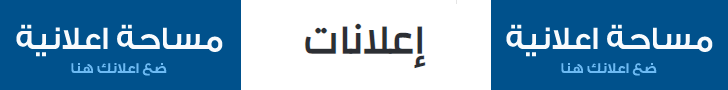أهمية العِلْم في حياة الإنسان

حقيقة العلم
وأثره على الفرد والمجتمع
الشيخ علي فقيه
حقيقة العلم
تعتبر حقيقة العلم من أعظم الحقائق لذوي العقول على الإطلاق، فلا يمكن للجاهل فضلاً عن العالم أن ينكر ثبوت تلك الحقيقة أو يخدشها.
فهي الحقيقة التي قامت عليها جميع الأمور ومختلف المسائل المتعلقة بأمور الدنيا والآخرة فأصبحت الشغل الشاغل للجميع لأنه موضع حاجاتهم ومصدر أرزاقهم والمميز لهم عن غيرهم من المخلوقات.
فلا يمكن لهم أن يحققوا أمراً من دون علم، ولا يمكن أن يدركوا حقيقة أو يصلوا إلى اكتشاف شيء بغير علم، فهو السلطان الأكبر الذي يتميز به الواحد عن الآخر.
العلم نور يقذفه الله في قلوب الناس عن طريق الكسب والتحصيل لأنه ليس إلهاماً إلا عند من خصه الله تعالى بهذه النعمة المميزة.
وقد يتحول هذا النور إلى نار في جوف صاحبه إذا استخدمه للشر والأذى كما فعل كثير من الناس في المجتمعات الغربية والشرقية، غير أن المجتمعات الغربية تميزت عن باقي الناس في استعمال العلم بتدمير البشرية.
العلم أمر عظيم، ولكن عندما يستخدم في مصالح البشر، أما العلم الذي تخرب به الكون فهو أحقر موجود شهدته البشرية عبر الزمن.
العلم رحماني وشيطاني
ينتج عما ذكرناه في البحث السابق هذا القسمان اللذان يتوازيان في سيرهما فلا يمكن لهما الإلتقاء في مورد ولا الإجتماع في موضع، وذلك لإستحالة اجتماع الخير والشر في شيء واحد في نفس الوقت.
إن للعلم حدوداً يجب الوقوف عندها، فإذا لم يراع المرء تلك الحدود فإنه سوف يقع في المحذور ويوقع غيره معه.
إن الحدود التي يجب أن يقف عندها طالب العلم هي العلوم التي يأمر بها الشيطان من أجل تدمير الأفراد والمجتمعات على مستوى العقول والأجسام والعقائد.
إن كل علم أنشأ من أجل مصالح الناس كان علماً رحمانياً لأن الله تعالى يحب كل ما فيه منفعة للبشر في حياتهم وبعد مماتهم.
ويمكن تلخيص المسألة بأنه ما اتصل به مصلحة للبشر كان علماً رحمانياً وما اتصل به ضرر كان علماً شيطانياً.
والسبب في تحصيل مثل هذا العلم هو أن الشيطان الرجيم يوسوس للإنسان بتلقي هذا النوع من العلم واستغلاله في المصالح الخاصة والأهداف الذاتية.
ونحن عندما نعظم العلم وندعو إلى تحصيله إنما نقصد بذلك النوع الأول(العلم الرحماني)
مصدر العلم عند الإنسان
يحمل الإنسان في صدره علماً يختلف مصدره عن مصادر العلوم في غيره من المخلوقات الحية رغم كثرة العلوم التي تلقاها، ورغم وتعدد أنواعها وماهياتها، فإن لكل علم ماهية تختلف عن ماهية العلم الآخر بسبب تكاثره واختلاف أنواعه وموضوعاته.
ورغم كثرة العلوم وتعدد المهن والحرف والصناعات التي اكتسبها الإنسان عبر تاريخه فإن منشأها فيه واحد وهو العقل الذي خلقه الله تعالى من أجل تحقيق غايات كثيرة.
وهذا بالإضافة إلى تعدد الطرق لكسبه والأساليب التي تساعد على تحصيله.
لقد وجد الإنسان على الأرض وهو خالي الذهن من أية فكرة أو علم فعلي، ثم بدأ بعد ذلك باختراع العلوم واكتشاف الأشياء بقوة العقل حتى لم يدع أمراً إلا وغاص في أسراره وأعماقه بسبب ما تقتضيه حاجته.
إن أكثر العلوم الحياتية اكتسبها الإنسان عن طريق الصدفة أو التجارب أو بسبب من الأسباب الطبيعية، ولقد خصصنا العلم هنا بالعلم الحياتي للفصل بينه وبين العلوم الإلهية التي نقلها الأنبياء إلى البشر بوحي من الله تعالى.
فلا يمكن أن تتحقق مسألة علمية إلا بعد المرور في القوة العقلية.
أساليب اكتساب العلم
لقد عرفنا أن مصدر العلم في الإنسان واحد إلا أن طرق كسبه مختلفة ومتنوعة وكثيرة، وذلك من حيث نوعية العلم وكيفية كسبه.
البعض يكتسب العلم عن طريق القراءة، والبعض الآخر عن طريق النظر أو السمع أو الحس أو بأي طريق من طرق كسبه الكثيرة.
ولهذا نرى طلاب الجامعات مختلفي الأمزجة في نوعية العلم لأن بعضهم يختار الطب، وبعضهم الهندسة أو الحقوق أو غير ذلك من أنواع العلم التي لا تكاد تحصى بسبب كثرتها.
وكذا الحال عند أصحاب المهن والحرف التي كان لها دور كبير في بناء البلاد والمدن والمجتمعات وفي الحفاظ على الحالة الإعمارية والإقتصادية في جميع البلاد، فلا البناء يستغني عن الهندسة والطبيب والمحاماة، ولا هؤلاء يستغنون عن البناء، ولا الجميع يستغنون عن عالم الدين ولا هو يستغني عنهم.
من هنا نصل إلى نتيجة هامة تختص بالعلم، وهي أن أنواع العلم رغم كثرتها مترابطة فيما بينها من حيث مؤداها.
والدليل على هذه العلاقة أو هذا الإرتباط حسي يعلمه العالم والجاهل على حد سواء.
إن لهذا الإختلاف بين أنواع العلم وطرق كسبه أثراً كبيراً على استمرار التطور ودوام الحياة العملية والإقتصادية.
وهناك علوم ذات آثار مادية وأخرى ذات آثار معنوية وكلا النوعين يعتبران موضع حاجة الإنسان.
ولو نظرنا إلى حقيقة هذين النوعين لوجدناها معنوية لأنه لا يوجد علم مادي بما هو علم لأن مركزه في الدماغ الذي هو موضع المعنويات، ولكننا عبرنا عنه تارة بالمادي وأخرى بالمعنوي من حيث نتائجه في التي تكون مادية أو معنوية.
ونمثل لكلا هذين النوعين بعلم العقائد وعلم الطب فإن آثار الأول معنوية وآثار الثاني مادية.
ونقصد بكلتا النتيجتين النتيجة الدنيوية وليس النتيجة في الآخرة لأن النتائج في الآخرة كلها مادية.
فالجنة أمر مادي يدخلها أهل الدين، والنار أمر مادي يدخلها أهل الدنيا.
الدافع إلى طلب العلم
عرفنا أن مصدر العلم في الإنسان واحد(وهو العقل) إلا أن الدافع إلى طلبه متعدد لأن سبب طلب العلم عند زيد مغاير لسبب طلبه عند غيره، والإنسان يطلب العلم بتحريك من الدافع.
هناك اشخاص طلبوا العلم وما زالوا يطلبونه لمجرد رغبتهم بالثقافة وحب الإستطلاع، ويمثل هذا النوع من طلب العلم عدداً كبيراً من البشر في العديد من المجتمعات العربية وغير العربية.
وبعضهم جعلوا من طلب العلم مصدراً لأرزاقهم، ولا مانع من ذلك لأن أغلب مصادر الأرزاق باتت متوقفة على العلم.
ومنهم من يطلبه ليباهي به الناس ويستمد لنفسه كرامة من كرامة العلم، فهو لم يطلبه من أجل المنفعة له ولغيره، وقد أبغض العقلاء هذا النوع من الدوافع واستقبحوا نفسية طالبه.
وقد امتازت المجتمعات الشرقية عن غيرها بكثرة هذا النوع فيها لأن الروح العربية ممزوجة بحب المعرفة وطلب العلم وإن لم يكن مصدر أرزاقهم، ولذلك قال قائلهم: وخير جليس في الأنام كتاب:
تنتفع المجتمعات العربية من الكتاب كثيراً لأنه الصناعة الوحيدة التي استخدمت حيزاً كبيراً من أوقاتهم وجهودهم بينما شغل الغرب نفسه بالفساد وإشباع الشهوات وشرب الخمر وافتعال المجازر وخوض الحروب من أجل تحقيق أهداف سافلة.
لم نعهد أن مجتمعاً عربياً صنع أداة لهو ليشغل الناس بها عن اكتساب بعض المعارف التي يرى المجتمع العربي منفعتها الأكيدة للإنسان.
لقد احتل الكتاب في المجتمع العربي على وجه الخصوص مكانة عالية وأخذ منهم اهتماماً بالغاً بحيث أصبح كل شيء في حياتهم.
نحن لا ننكر أن الغرب فضلاً مادياً على البشرية وذلك من خلال اختراعاته التي خدمت البشرية من ناحية ودمرتها من الناحية الأخرى.
ويا ليتهم لم يخترعوا شيئاً وحافظوا على الأخلاق والقيم والمبادئ فلو كان ذلك لكان أشرف لهم وأفضل من أن يستهتروا بالأخلاق التي حرمت منها مجتمعاتهم.
لقد أسسوا المصانع واخترعوا الآلات التي أصبحت اليوم ضرورة من ضروريات الحياة ولكنهم في المقابل دمروا الموارد الطبيعية ولوثوا الماء والهواء والنبات بفعل مخلفات تلك الأسلحة المدمرة التي تنبئ صناعتها عن خبث مدفون في صدورهم لا يعلم مدى حجمه إلا الله سبحانه وتعالى.
إذن.. هناك تنوع في العلم ودوافع عديدة لكسبه، وقد أحببنا أن نشير إلى ذلك من أجل زيادة المنفعة.
مصدر المعارف عند الحيوان
إن مسألة كسب المعارف لا تختص بالإنسان وحده بل هي تشمل كل ذي روح يريد أن يحافظ على حياته ووجوده.
فالإنسان يتعلم ويكسب المعارف، وكذلك الحيوان، إلا أن مصدر كسبهما مختلف، فإن مصدر معرفة الإنسان تنشأ من العقل، أما مصادر معرفة الحيوان فإنها تنشأ عن الغريزة وحب البقاء.
ولا شك بأن هناك تشابهاً بين بعض دوافع الإنسان والحيوان وربما يوجد تشابه بين أساليب كسبهما.
وهذا لا يعني أن الحيوان يتمتع بقوة عقلية خاصة بل إن حركة الحياة الطبيعة تقتضي وجود المشابهة بينهما رغم عدم وجود مشابهة في التفكير والإدراك.
إننا من خلال النظر إلى كيفية عمل الحيوان وتعلمه نشعر وكأنه يتمتع بقوة عقلية غير أن الواقع ليس كذلك لأن العقل من شؤون الإنسان وحده، أما تلك المشابهة بينه وبين الحيوان فإنها ناشئة من اتفاقهما في بعض أنواع العلم الذي لا يحتاج كسبه إلى قوة العقل.
ولهذا عمد علماء المنطق إلى تقسيم العلم أربعة أقسام وبيان ما اشترك فيها الحيوان مع الإنسان وما افترق فيها عنه.
وقبل ذلك أود أن أشير إلى وجود فارق أساسي بين علم الإنسان وعلم الحيوان رغم وجود الإتفاق بينهما في بعض أنواعه ورغم اختلاف مصدر علومهما وهو أن الإنسان يتعلم كل شيء، أي ما كان موضع حاجته وما لا حاجة له به، أما الحيوان فلا يتعلم سوى ما يكفل له استمرارية الحياة.
وقد نرى تمايزاً بين حيوان وآخر من جهة أن بعضهم يتعلم أشياء لا يتعلمها غيره حتى وإن كان من جنسه كما لو تعلم بعضهم بعض الحركات البهلوانية، واعلموا بأنه لولا علم الحيوان باستمرارية حياته بذلك لما تعلم شيئاً من ذلك.
فالإنسان والحيوان متفقان فيما لا يحتاج تحصيله إلى قوة عقلية، أما ما يحتاج إلى ذلك فلا حظ للحيوان فيه.
لقد ذكرت ذلك لأن بعض الناس قد ادعى وجود قوة في الحيوان تشبه القوة العقلية في الإنسان، فلو كان للحيوان تلك القوة لما كان حيواناً بالمعنى العرفي بل لكان مكلفاً كالإنسان.
نحن نؤيد هذا الرأي من جهة ونخالفه من جهة أخرى:
نحن نؤيده عندما قال : قوة تشبه القوة العقلية: فإنه لا يقصد بذلك العقل البشري إذ لو كان المقصود به العقل لإدعى وجود العقل فيه.
ونخافه في ذلك فيما لو كان قاصداً بذلك القوة العقلية المودعة في الإنسان.
لقد ذكر المناطقة وجوه الإتفاق والإفتراق بينهما وذلك بعد أن قسموا العلم إلى أربعة أقسام:
– الأول: العلم الحسي: وهو العلم الذي يكتسب عن طريق الحواس الخمس الموجودة في الإنسان والحيوان، فكما يتعلم الإنسان عن طريق النظر والسمع واللمس وباقي الحواس كذلك الحيوان الذي خلق الله له تلك الحواس ليستخدمها في حاجاته.
ولذا نجد الحيوان يميز بين منظور ومنظور وبين مسموع وآخر، وهذا النوع من العلم يشترك فيه الإنسان مع الحيوان.
– الثاني: العلم الخيالي: وهو العلم المكتسب بقوة الخيال عند الإنسان والحيوان لأن الله سبحانه وتعالى قد أودع فيهما هذه القوة ليدركا بها كثيراً من المعارف.
– الثالث: العلم الوهمي: وهو خاص بالشعور القلبي كالحب والبغض، فإن الإنسان منذ صغره يميز بين الحبيب وغيره نتيجة بعض المؤثرات الخاصة فيعلم من يحبه ومن يبغضه، وكذلك الحيوان وهذا من الأمور الواضحة لدى الجميع.
– الرابع: العلم الأكمل:
وهو العلم الذي ينشأ عن العقل، وهو الذي تميز به الإنسان عن الحيوان وتوصل به إلى معرفة الكثير من أسرار هذا الكون وما فيه من العجائب والغرائب.
وبهذا العلم أدرك الإنسان وجود الله تعالى وآمن بذلك وأقر بالعبودية له وأيقن بجميع صفاته وأسمائه.
وبهذا النوع من العلم وصل الإنسان إلى هذا التطور المذهل الذي لم يكن الناس له مقرنين قبل ذلك.
إنه العلم الذي وصفه الله سبحانه بالنور والبصر والهدى وبغيرها من عبارات التعظيم.
وهو العلم الذي يقابل الجهل فيمن له قابلية العلم،فإن الذي منح قابلية التعلم والمعرفة ولم يستغلها في ذلك كان جديراً بأن يوصف بالجاهل، ولا يوصف الحيوان بذلك لعدم وجود قوة العقل فيه.
تقسيم العلم باعتبارات متعددة
لقد جعل العلماء لهذا العلم تقسيمات عديدة بحسب اللحاظ والإعتبار، فإنهم تارة يقسمونه إلى حصولي وحضوري، وأخرى إلى بديهي ونظري، وثالثة إلى أقسام عديدة لا حاجة إلى ذكرها هنا.
تقسيم العلم بلحاظ أصل كسبه
ينقسم العلم بهذا اللحاظ إلى حصولي وحضوري:
1- العلم الحصولي: وهو العلم الذي لا يستحضره الذهن إلا عن طريق الكسب والتعلم، وذلك كأكثر العلوم التي يتلقاها الإنسان في المدارس والمعاهد والمساجد.
2- العلم الحضوري: وهو العلم الذي لا يأتي بطريق الكسب والجهد، كعلم الإنسان بالجوع والعطش والحب والبغض.
تقسيم العلم بلحاظ الوضوح والغموض
وينقسم العلم من هذه الناحية إلى بديهي ونظري:
1- العلم البديهي: وهو العلم السهل الذي لا يحتاج الإنسان في عملية كسبه إلى الجهد الفكري والعقلي ولا حتى إلى شيء من التأمل، كما لو قيل: واحد وواحد يساوي اثنين.
2- العلم النظري: وهو الذي يحتاج المرء في كسبه إلى إعمال العقل كأي علم لا يدرك بالبداهة كعلم الطب والفقه.
تقسيم العلم بلحاظ المنفعة وعدمها
لقد قسم العلماء هذا العلم إلى الأقسام التي مر ذكرها وقد لاحظوا في تقسيماتهم حقيقة العلم ولم يتعرضوا إلى ذكر النافع منه لأن هذا الأمر من مسؤولات عالم الدين.
ومن الحسن جداً أن نفصل بين علم وآخر ونبين النافع والضار ونحث على تعلم النافع منه وتجنب الضار، وهذه من النصائح الإسلامية الكبرى التي يبينها كل شاعر بالمسؤولية تجاه الفرد والمجتمع.
ولكي نفهم حقيقة العلم المطلوب الذي يجب اكتسابه دون غيره لزم أن نقسم العلم بطريقتنا الخاصة لنستغل ذلك في بيان نصائحنا فنقول:
ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام:
– الأول: العلم النافع:
وهو كل علم يخدم الناس على صعيد أجسامهم، كعلم الطب والجراحة، أو على صعيد المعيشة، كأي علم يضمن للمرء حياة سعيدة ولقمة من الحلال، أو على صعيد الدين، كعلم الفقه والعقائد والأخلاق.
– الثاني: العلم الضار:
وهو العلم الذي لا يعود على صاحبه إلا بالخسارة والأعباء وحدوث الضرر على نفسه وعلى غيره، كهذا العلم الذي قضى على ثروات الطبيعة ولوث كل مأكول ومشروب.
– الثالث: العلم الذي لا ينفع ولا يضر:
وهو العلم الذي يصرف فيه الإنسان وقته من دون أن يكون له فائدة منه أو مضرة، وذلك كما لو تعلم لغة من اللغات التي لا يتعامل بها أحد، فهذا علم ولكن لا فائدة منه.
ومن الأفضل له أن يستغني عن تلقي مثل هذه العلوم ويصرف وقته فيما ينفعه في الدنيا والآخرة.
ونقصد بعديم الفائدة ما لا فائدة منه لصاحبه وللناس، أما لو كان في فائدة لواحد منهما اندرج عندذلك تحت عنوان النافع.
وبعد هذا التقسيم نوجه نصيحة لكل طالب علم يسعى وراء المعرفة فنقول له: لا تصرف عمرك ونظرك ومالك وحقوق غيرك عليك في طلب علم لا فائدة فيه لك ولغيرك، فلا يقوم بذلك سوى الذين لا ثمن لأوقاتهم ولا هدف لهم في هذه الحياة، فإن العلوم التي لا حاجة لها في الدنيا ولا نفع لها في الآخرة فلا ينبغي أن نصرف ساعة من أوقاتنا في تحصيلها.
ونلاحظ بأن الشريعة الإسلامية السمحاء قد أوجبت على العباد تعلم بعض أنواع العلم، فلو بحثنا عن حقيقة تلك العلوم وآثارها لوجدناها ذات منفعة من جميع الجوانب.
العلم في القرآن الكريم
لم تعهد البشرية عبر تاريخها الطويل كتاباً سماوياً أعطى العلم قدراً من الأهمية كالقرآن الكريم الذي جعل العلم في أعلى المستويات لما يحمله من المنافع الدنيوية والأخروية لحامليه.
وقد دعا القرآن في مواضع عديدة إلى اكتساب العلم وتعليمه بعدما بين لنا مكانته العالية عند الله سبحانه وتعالى الذي جعل الغاية من إيجاد الخلق طلب المعرفة بدليل قوله(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وقد فسرت العبادة هنا بالمعرفة وأن العبادة من لوازم المعرفة، ولذلك عبر القرآن عن المعرفة بالعبادة.
ولعل هناك سبباً خفياً في استعمال هذا التعبير العظيم(التعبير عن العلم بالعبادة) وهو بيان منزلة العلم عند الله تبارك وتعالى.
والسر في ذلك هو لفت أنظار البشر إلى هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يحمل في نفوسهم نفس الأهمية التي تلقاها منهم العبادة.
إننا كأصحاب عقول نفهم من هذا التعبير ما هو أبعد من كونه تعبيراً عابراً لأنه لا يوجد في القرآن المجيد أمور عابرة وإنما يوجد بعد لكل كلمة ومعنى عميق لكل آية من آياته فلا ينبغي أن نمر على الآيات كما نمر على عبارات بعض الكتب التي نقرؤها.
وقد أشار أمير المؤمنين علي(ع) في كثير من خطبه إلى هذه الناحية الدقيقة ليلفت أنظارنا إلى العمق القرآني حتى يعظم معناه في قلوبنا وعقولنا لأنه قائدنا في الدنيا والآخرة، وحري بنا أن نعرف الكثير عن هذا القائد العظيم.
فمن جملة ما قاله(ع) : ظاهره أنيق وباطنه عميق :
إن لهذه العبارة وما يشبهها معان كثيرة:
منها : بيان عظمة القرآن.
ومنها: لفت أنظار الناس إلى وجود خفايا وغرائب وعجائب في داخله.
ومنها: دعوة إلى الإهتمام بباطنه أكثر من الإهتمام بظاهره.
وهناك معان أخرى لا مجال لذكرها في هذا المختصر.
ولعل التعبير عن المعرفة بالعبادة هو من أجل لفت أنظارنا إلى أمور:
أولاً : أن نعطي العلم اهتماماً كما نهتم بأمور عبادتنا.
ثانياً : أن هناك ارتباطاً بين العلم والعبادة.
ثالثاً : أن شأنه لا يقل عن شأن العبادة فيما إذا كان له علاقة بها، ونحن نعلم أن عبادة العالم أفضل من عبادة الجاهل بمراتب وذلك لأن العالم يفهم معنى ما يقوم به ويعي عظمة المعبود سبحانه.
ويمكن لنا القول بأن العلم هو الركن الأبرز من أركان العبادة فلا تكون العبادة عبادة إلا بعلم فإذا عبد الإنسان أمراً مجهولاً عنده لم تكن عبادته عبادة.
ولا يشترط أن يكون العلم بالمعبود علماً تفصيلياً بل يكفي أن يكون علماً إجمالياً وتتحقق العبادة به.
إننا ننفي وجود عبادة حقيقية فيما إذا لم يكن هناك علم من الأساس أما مع وجود العلم الإجمالي يمكن لنا إثبات العبادة إلا أن العلم التفصيلي في هذا المجال أفضل لصاحبه في يوم القيامة.
بيان فضل العلم والعلماء
في القرآن
قال تعالى:
(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)
المجادلة آية 11
(إنما يخشى الله من عباده العلماء)
فاطر آية 28
(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)
الزمر آية 9
(وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)
العنكبوت آية 43
هذه أربع آيات من عشرات الآيات الحاكية عن فضل طلب العلم والفرق بين العالم والجاهل، ولكن لكي يتضح لنا الأمر أكثر كان لا بد من بيان بعض ما تشير إليه هذه الآيات الكريمة مما يكشف لنا عن المكانة التي احتلها العلم في القرآن الكريم.
الآية الأولى
(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)
في هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى بعض النتائج التي جعلها من نصيب أهل العلم، وهي الرفعة، وقد وردت بلفظ مطلق، فهي_إذن_ ليست خاصة في الدنيا أو الآخرة وإنما تشمل الدارين معاً لأن الله عز وجل قد رفع أهل العلم(العاملون بعلمهم) في الدنيا والآخرة.
لقد ذكر الله تعالى هذه النتيجة بعد ذكر بعض المسائل الأخلاقية والإجتماعية التي يجب أن تتوفر في كل مؤمن، فإذا تحلى المؤمن بتلك الصفات شملته تلك النتيجة الكريمة وإلا فلا يكون من أهل العلم ذوي الرفعة عند الله سبحانه.
إن التحلي بتلك الصفات وتطبيق التعاليم الإسلامية على النفس يأتي بعد الإيمان بالله تعالى والتصديق بكل ما جاء به النبي(ص) من عند ربه، وإلا فإن العمل بها من دون إيمان لا طائل منه لأن الوسيلة التي يقبل الله بها العمل هي الإيمان به وبالنبي وبكل ما وجب الإيمان به.
وبنظرة بسيطة إلى القرآن الكريم تتضح عندنا هذه النقطة لأن القرآن قد قرن بين الإيمان والعمل الصالح في جميع السور التي دعا الله فيها عباده إلى الإيمان كقوله(وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وقوله (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)
من هنا نفهم أن الإيمان من دون عمل لا طائل منه وكذلك العمل من دون إيمان.
فلكي يكون الإنسان من أهل الرفعة عند الله سبحانه كان عليه أن يؤمن ويعمل.
ونلاحظ بأن السنة الشريفة قد ذمت المؤمن الذي لا يعمل، ودعت العامل الذي لم يؤمن إلى الإيمان حتى يستفيد من عمله، أي أنها دعته إلى الكمال الذي يبحث عنه أكثر الناس.
وإذا رجعنا إلى سورة المجادلة التي اشتملت على آية الرفعة المذكورة في أول البحث وجدنا أنها مسبوقة ببعض التعاليم والتوجيهات.
قال تعالى(يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون) إلى قوله(يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم… الخ)
إذا التزم المسلم بهذه التعاليم استحق تلك النتيجة العظيمة.
ثم إن هذه الآية الكريمة تتضمن أمراً يغفل عنه كثير من الناس، وإليكم هذا الأمر:
إن كل من يقرأ هذه الآية يفهم من خلالها أن الله تعالى سوف يرفع المؤمنين وأهل العلم من المؤمنين، ولكن السؤال هنا: لماذا فصلت الآية بين المؤمنين وأهل العلم؟
لو نظرنا إلى آراء المفسرين في هذه الآية الكريمة لوجدنا أنهم يفصلون في هذه النتيجة بين المؤمنين وأهل العلم من المؤمنين.
وإن من الطبيعي جداً أن يكون هناك تفاوت بين المؤمن العالم والمؤمن الجاهل، ولكن السؤال هنا: كيف يمكن أن نفهم هذه الحقيقة؟
يمكن لنا أن نفهم هذه الحقيقة من خلال مدح الله تعالى للمؤمنين فإن مدحه هذا يشمل العالم منهم والجاهل، ولكن في خصوص هذه الآية هناك فرق بينهما، وقد فسر المفسرون هذه الآية بأن الله عز وجل يرفع المؤمنين العاديين درجة، ويرفع المؤمنين العلماء درجات.
فلو كانت النتيجة واحدة لما فصل في القول بين الذين آمنوا والذين أوتوا العلم.
إن هذه السيرة يتبعها الناس فيما بينهم فإنهم يكرمون العالم بشكل مميز، ولا يحتاج هذا الأمر إلى شيئ من التوضيح، ولكن السؤال هنا: ما هو الشيء الذي جعل الناس يكرمون أهل العلم منهم؟
إن الإجابة على هذا السؤال تتم ببيان بعض الإحتمالات:
أولاً: أن الطبيعة التي خلق الناس عليها تقتضي صدور الإحترام من الداني إلى العالي، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر، وكأنه أمر تكويني قد فطر الناس عليه.
ثانياً: هم يحترمون أهل العلم ويكرمونهم لأن الله سبحانه وتعالى كرمهم وأمر الناس باحترامهم لما تحمله صدورهم من التعاليم النافعة للبشر في الدنيا والآخرة.
ثالثاً: أن حاجة الناس إلى العلم تجعلهم يقدمون الإحترام والطاعة لحامليه.
ففي مثل هذه الحالة لا يكون الإحترام للعلم بما هو علم بل احترام للنتائج التي تنبثق عن العلم.
فطالب العلم في المدرسة يحترم استاذه من أجل الحصول على شهادة تخوله الدخول في وظيفة معينة، والمريض يحترم علم الطبيب لحاجته إلى الدواء، وهناك قلة من الناس يحترمون العلم انفسه.
والنتيجة من ذلك كله أن العلم أمر عظيم يجب الحصول عليه بكل وسيلة ممكنة.
إن جميع هذه الشواهد تكشف لنا عن رفعة أهل العلم بغض النظر عن كونها في الدنيا أو في الآخرة أو في كلا الدارين معاً.
فمنهم من يرفعه علمه في الدنيا فقط، ومنهم من يرفعه في الآخرة،
ومنهم من يرفعه في الدنيا والآخرة.
الآية الثانية
(إنما يخشى الله من عباده العلماء)
من خلال حصر خشية الله في العلماء يظهر لنا جلياً أن العلم أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد تبين لنا ذلك من خلال ما ذكرناه في البحث السابق، غير أن هذه الآية الكريمة تشتمل على أكثر من وجه في دلالتها، وهذا ما سوف نعمد إلى بيانه في هذا البحث.
شرح مفردات الآية:
قوله تعالى (إنما) يفيد الحصر، وهذه مسألة لغوية يقول بها كل النحويين واللغويين.
وقوله(يخشى) أي يخاف، فإن العالم يخاف الله تعالى ويأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه.
وقوله(عباده) أي الناس جميعاً، لأن الجميع عبيد لله شاؤوا أم أبوا.
وقوله (العلماء) أي الذين عرفوه حق معرفته.
والمعنى الإجمالي للآية هو أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن حالة موجودة، وفي نفس الوقت يدعوا الناس إلى التعلم حتى تشملهم الآية المباركة.
معنى الآية:
تشير الآية الكريمة إلى أن الذين يخشون ربهم حقاً هم العلماء فقط، وأما غير العالم فلا تكون عبادته صحيحة، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح كيلا يفهم البعض هذا الأمر على غير وجهه الصحيح.
قد يتوهم البعض من خلال الآية أو من خلال كلامنا حولها أن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا ممن تفرغ للعلم وأصبح عالماً، ولكن الأمر ليس كما يتبادر إلى الأذهان لأن العلم لوحده لا يكفي لقبول العمل إذا لم يتوج العامل عمله بتقوى الله تعالى والتقرب منه.
فقد يتقرب الجاهل إلى ربه، وقد يبتعد العالم عنه.
إن فهم هذه المسألة يتوقف على فهم معنى العالم أو فهم ما قصد به في الآية الكريمة.
إن الذي يتبادر إلى الأذهان من خلال لفظ العالم هو عالم الدين، ولا يعقل أن يتقبل الله من رجال الدين فقط دون بقية الناس لأنه يستحيل على الجميع أن يكونوا علماء دين، فإذا كان الجميع كذلك فمن يبلغ من، ومن يعمل في المهن والصناعات والزراعة والحياكة.
إن هذا الأمر يعطل الكون كله ويخل بالأنظمة الموضوعة للحياة على هذه الأرض.
إن المقصود بالعالم هو الذي عرف ربه وعبده حيث لا تصح عبادة شيء مجهول، ولا يشترط أن يكون الإنسان عالماً بجميع التفاصيل، بل يكفي العلم الإجمالي في تحقق العبادة، وبهذه الطريقة يكون العابد مشمولاً بالآية الكريمة.
فإذا أقر المرء بوجود الله تعالى واستحقاقه للعبادة دون سواه فهو عالم.
يبقى عليه أن يطبق مضمون هذا العلم على نفسه ليكون أحد مصاديق الآية المباركة.
شبهة حول معنى الآية:
إن جميع آيات القرآن عظيمة، ولكن الناس لا يتداولون فيما بينهم سوى آيات قليلة يرون بأنها موضع كلامهم اليومي فهم يركزون عليها دون باقي الآيات.
ومن جملة تلك الآيات المتداولة على ألسنة الناس هي الآية التي نحن بصدد شرحها في هذا البحث وهي(إنما يخشى الله من عباده العلماء)
إن لهذه الآية معنى واحد يتفق عليه جميع المفسرين والعلماء وهو أن الذين يخافون ربهم هم العلماء، ولكن كثيراً من الناس فهموا لها معنى آخر، وهو أن الله عز وجل يخاف من العلماء.
والسبب في هذا الفهم أن لفظ الجلالة مقدم على لفظ العلماء وهذا الأخير فاعل ينبغي أن يتقدم على المفعول.
نقول: يجوز تقديم المفعول به على الفاعل عند أمن اللبس، وفي هذه الآية المباركة لا يوجد لبس، ولهذا قدم فيها المفعول على الفاعل لغاية بلاغية، والمعنى هو أن العلماء يخشون الله تبارك وتعالى.
من هم العباد
لقد ورد لفظ العباد في الآية بصيغة مستثنى منه حيث استثنى الله عز وجل من العباد(العلماء) وأخبر بأنهم الذين يخشونه، ولكن الأمر الذي يجب البحث عنه هنا هو حقيقة العباد، فمن هم العباد؟
هل هم الناس كلهم من دون استثناء؟
أم هم الذين أقروا بالعبودية لله وحده؟
تارة يطلق لفظ العباد ويراد به الإنسان العابد، وأخرى يطلق ويراد به كل إنسان من باب أن الجميع مأمورون بالعبادة، فيصح أن يطلق على الكافر أنه عابد فضلاً عن المؤمن.
إذن.. يصح استعمال لفظ العابد في كلا المعنيين، فأيهما المراد بالآية الكريمة؟
لعل المراد بها جميع الناس لأن الجميع مأمورون بأن يعبدوا الله تعالى، ولكن لم يعبده سوى العالم به، وقد ذكرنا سابقاً أن المقر بالعبودية لله يعتبر عالماً بما أقر به، وبناءاً على ذلك يكون المقصود بالعباد في الآية جميع الناس.
ولا يجدر بنا الإكتفاء هنا ببيان مفردات الآية أو معناها الإجمالي بل لا بد من ذكر بعض الفوائد التي يمكن اكتسابها منها لتكون الفائدة لنا آكد والأجر أعظم.
إن ظاهر الآية المباركة إخبار ولكن يمكن لنا أن نستفيد منها ما هو أكثر من الإخبار.
ولذا يمكن القول بوجود دعوة ضمنية يدعو الله بها عباده إلى اكتساب ما يجعلهم علماء به حتي يكونوا مصاديق للآية الكريمة.
وكأن الله عز وجل يقول لنا كونوا علماء لتكونوا عباداً حقيقيين.
ويمكن لنا أن نستفيد أمراً آخر: وهو أن الله تعالى يبين بالآية عظمة العلم وبعض ثماره، وقد عرفنا من خلال هذا البحث أهم ثمار العلم وهو اكتساب صفة العبودية لله عز وجل.
الآية الثالثة
(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)
في هذه الآية يعبر الله تعالى عن المؤمنين بالذين يعلمون، وعن الكفار بالذين لا يعلمون مبيناً بأنهما لا يستويان عنده.
ومن الطبيعي جداً أن لا يستوي المؤمن والكافر عند الله لأن عاقبة الأول تختلف تماماً عن عاقبة الآخر.
كيف يمكن أن يستوي شخص أضاع عمره باللهو والعصيان وعدم المبالات والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقه من قبل الله عز وجل مع شخص قضى حياته فيما يرضي الله تبارك وتعالى.
ليس من العدل_عقلاً_ أن تكون نتيجتهما واحدة، والله تعالى العادل الذي لا يجور، وبناءاً على ذلك وجب أن لا يكونا متساويين لا في الدنيا ولا في الآخرة.
وقد ضرب الله عز وجل مثلاً لبيان الفارق بينهما والسبب من عدم تساويهما، وذلك قبل الآية المذكورة حيث يقول(أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه)
هذه بعض الأمور التي يقوم بها أهل العلم الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان، قد ذكرها الله تعالى بعد ذكر الأعمال التي يقوم بها الكفار حيث قال هناك(وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله)
ولهذا كان من الطبيعي جداً أن تكون النتيجة كما قال الله تعالى
(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)
الآية الرابعة
(وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)
وهي الآية الثالثة والأربعون من سورة العنكبوت التي يذكر الله فيها أمثلة كثيرة من أجل أن يعتبر بها أولوا الألباب.
وبعد ذكر تلك الأمثلة العظيمة أخبر الله عباده بحالة واقعية لا نكران لها، وهي أن الذين يعقلون تلك الأمثال ويعتبرون بها هم أهل العلم دون غيرهم لأنها لا تعني الكافر الذي جهل_أو تجاهل_ ما عند الله سبحانه من الثواب والعقاب والنعيم والجحيم.
إن أهل العلم يأخذون كل كلمة تصدر عن الله سبحانه ويعملون بها لأنها تعنيهم في الدنيا والآخرة، أما الجاهل فإن وجود تلك العبر وعدم وجودها لديه سيان، ولهذا فإنه يلقي بها خلف ظهره.
الله سبحانه وتعالى لا يميز في التبليغ والتعليم بين عبد وعبد فإنه يبعث الأنبياء إلى الجميع ويضرب الأمثال ويعطي العبر لكافة الناس، ولكن لعلمه تعالى بعاقبة الأمور أخبرنا بأن هذه العبر لا يستفيد منها إلا أهل العلم، وهذا معنى قوله(وما يعقلها إلا العالمون)