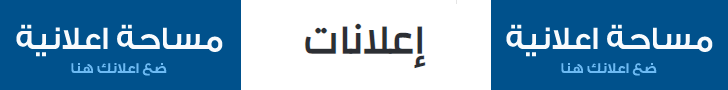النَّفْسُ فِيْ القُرْآنِ الكَرِيْم
عندما نتحدث عن النفس يعني أننا نتحدث عن الإنسان، ولكننا نركز على موضوع النفس لأنها المعيار في العمل وفي النتيجة.
فلو أننا تصفّحنا سور القرآن وآياته، وتدبّرناه كما أمر خالقه لوجدنا التركيز على النفس ظاهراً في معظم السور.
وقد عوّدنا االقرآن في طريقته على الإعتناء بما يكثر ذكره فيه، والنفس من الألفاظ التي احتلت مساحة كبيرة في آياته مما يعني أن هذه النفس أمرٌ مهم في عالم العقيدة بشكل خاص، وفي عالم المعرفة بشكل عام، ويعني أيضاً ضرورة الإهتمام بها من قِبل الجميع لأنها تعني الجميع بشكل مباشر.
فمعرفة النفس ساحة للمعرفة النافعة، فمنهم من يستفيد منها للدنيا، ومنهم من يستفيد منها للدنيا والآخرة، والثاني هو المطلوب الأول.
وقد اهتم القرآن الكريم بذكر النفس وأنواعها ومراتبها، فحدثنا عن الزكية والمطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء، كما وحدثنا عن النفس المشتملة على الحواس الخمس، وهذا ما سوف يظهر جلياً فيما يأتي من البحوث إن شاء الله.
وعلى كل إنسان منا أن يعلم بأنه مأمور في معرفة النفس أولاً، وفي تهذيبها ثانياً، ولا شك بأن القرآن رسم طريق السعادة لها، وبيّن طريق الهلاك داعياً إلى جعلها زكية مطمئنة، محذراً من جعلها مرتعاً للشيطان الرجيم.
وإذا أعطى القرآن المجيد اهتمامه لشيء فعلى كل مؤمن بالقرآن أن يعظّم ما عظّمه القرآن ويضع ما يضعه القرآن وهذا ضربٌ من ضرورب الإلتزام بالنهج القرآني.
اللهُ تَعَالَى يُقْسِمُ بِالنَّفْس
من معاني التعظيم العميقة في القرآن المجيد أنه اعتمد مبدأ القسم في الأمور ذات الأهمية البالغة ليشير إلى عظمة ما يُقسم به وعليه.
ومع تأمل بسيط وتدقيق قليل نجد بأن الله سبحانه أقسم في كتابه الكريم بأمور كلها ذات شأن رفيع عنده، فلم يُقسم بما لا قيمة له وما لا شأن عنده.
لقد أقسم الله تعالى بنفسه وملائكته وكتبه وأنبيائه، وأقسم بسمائه وأرضه والشمس والقمر والليل والنهار والقرآن والنجم ويوم القيامة، وكذلك أقسم بالنفس البشرية في أكثر من موضع.
ففي سورة الشمس أقسم الله بأمور عظيمة ومنها النفس البشرية حيث قال(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)
والملاحَظُ في الآية الأولى أنه تبارك وتعالى أقسم بنفسه وبالنفس البشرية معاً، فقد أقسم بشيء على شيء، أقسم بنفسه وبالنفس أن الفوز والفلاح لأصحاب النفس الزكية والأعمال الصالحة، والخسارة والعذاب لأصحاب الأنفس الأمارة بالسوء التي آثرت طاعة الشيطان على طاعة الرحمن.
ولا يمكن للنفس أن تزكو إلا بالعمل الصالح.
فقد أفلح وفاز وربح من جعل نفسه مؤتمرة بأوامر ربها معرضة عن الهوى واللغو والمعصية، وقد خاب من أطلق العنان لنفسه حتى نزلت إلى مستوى لم يُرِد الله لها النزول إلى هذا الموضع، وإنما أراد أن يرفعها وينزهها، ولكن صاحبها لم يكن من أصحاب القلوب الواعية فكانت النتيجة أنه استسلم للوسوسة فكان من الخاسرين.
وقد يحاول البعض تقديم أعذار هي في الحقيقة أقبح من الذنوب متهماً رب العالمين سبحانه بأنه هو الذي يلهم للطاعة ويلهم للمعصية، وهذا عين الكفر لأن به طعناً في العدالة الإلهية التي لا تُجبر إنساناً على شيء.
فالإلهام هنا يعني البيان والتعليم، وبمعنى آخر: لقد خلق الله الإنسان وعنده القابلية لأن يكون تقياً أو فاجراً وقد خيّره بين طريقي الخير والشر والحق والباطل بدليل قوله تعالى في سورة الكهف(وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا)
وقال تعالى في سورة العنكبوت(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِم)
وفي سورة الزلزلة(فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)
وفي سورة الكهف(وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)
وفي سورة القيامة أقسم الله سبحانه بالنفس اللوامة ليشير إلى عظمة تلك القوة في الإنسان وأنها أحد سبل النجاة في يوم القيامة فقال تعالى(وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) أي إنني أقسم بالنفس اللوامة، واللام هنا زائدة وإنما استُعملت للمبالغة في القسم.
حَقِيْقَةُ النَّفْس
تنقسم النفس إلى حواس ومشاعر، ولكل جزء من أجزائها المادية والمعنوية وظيفته الخاصة، وقد جعل الله ذلك من أجل الإنسان الذي كان أكمل المخلوقات الحية سواء في عقله ومشاعره أو في التركيبة الجسدية الخاصة.
أما القسم الأول من النفس فهو المشتمل على الحواس الخمس، وهذه الحواس ليست خاصة بالإنسان بل هي مشتركة بينه وبين كثير من أنواع الحيوانات التي تتمتع بتلك الحواس.
فالإنسان يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويحس وكذلك الحيوان، وليس الكلام هنا عن هذا القسم بل الكلام في القسم الآخر الخاص بالقوى النفسية والمشاعر.
وهو الذي ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز، وهو ينقسم إلى قسمين:قسم رحماني وقسم شيطاني أهوائي.
وهذا معنى قوله تعالى(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)
فهناك_إذن_ نفس زكية ونفس أمارة بالسوء، ولعل القسم الأخير هو الأساس في النفس إلا إذا عمل الإنسان على نقل نفسه من الشر إلى الخير ومن السوء إلى التزكية لأن من شأن النفس أن تجر صاحبها إلى المهالك إلا إذا التجأ إلى العقل ولاذ بقواه.
إن أول أمر يجب على الإنسان أن يعرفه هو النفس وحقوقها وواجباتها، وذلك من أوضح المعارف لدى الإنسان.
والسبب في وجوب معرفة النفس أولاً هو أنها مصدر المعارف حتى معرفة الله سبحانه وتعالى.
إن النفس البشرية أساس كل قوة أو ضعف في الإنسان، وهي مبعث كل صلاح أو فساد ولهذا كانت معرفتها ضرورية.
بالنفس يرتفع شأن الإنسان أو ينزل إلى أدنى المستويات وأحط المراتب.
ولا يمكن لأية قوة في العالم أن تدرك حقيقة النفس لأنها سر من أسرار الخالق سبحانه ولكننا نرى النفس في أفعالها عبر الجسد الذي تستخدمه في هذه الحياة.
فإذا وضع الشخص يده على النار وانتفض متألماً فعند ذلك نعلم بأن النفس تتألم من النار، وكذلك الحال في الأمور التي تأنس بها النفس فنعرف ذلك من خلال حركات الجسد لأنه المترجم لقوة النفس.
ومن هنا عقد الفلاسفة وعلماء النفس بحوثاً حول علاقة النفس بالبدن لأنهم استطاعوا أن يعرفوا الكثير عن النفس بواسطة الجسد.
ولذا قال أحدهم: كما أن العين لا تبصر والأذن لا تسمع والأنف لا يشم بدون النفس، كذلك النفس لا تعرف الألوان والأصوات والروائح بدون العين والأذن والأنف.
ولهذا قال بعضهم: من فقد حساً فقد علماً:
قُوَى النَّفْسِ البَشَرِيَّة
إن للنفس البشرية قوى عديدة ومختلفة، فتارة نقصد بها الحواس الخمس، وأخرى نقسمها تقسيماً عقائدياً كالزكية واللوامة، وتارة نرجع إلى التقسيم الذي وضعه علماء النفس لها، وهو ما سوف أسلط الضوء عليه في هذا البحث.
وهذا التقسيم قائم على دراسة أحوال المشاعر والأحاسيس لدى كل البشر الذين يشتركون في هذه الأقسام الأربعة لقوى النفس.
التقسيم العقائدي لقوى النفس:
تنقسم النفس بالمنظار العقائدي إلى أربعة أقسام:
زكية، ومطمئنة، ولوامة، وأمّارة بالسوء.
التقسيم العلمي لقوى النفس:
وتنقسم بالمنظار العلمي إلى أربعة أقسام أيضاً:
عقلية، ووهمية، وسبعية، وشهوية.
نبدأ بالتقسيم العلمي لها وبيان أحوالها ووظائفها.
القسم الأول: القوة العقلية الملكية:
ترتبط هذه القوة بنور العقل ارتباطاً وثيقاً بحيث يمكن التعبير عنها بالعقل لأنها تخضع لقوانينه وموازينه، وهذه القوة موجودة في كل إنسان تكويناً، ولكن الإنسان هو الذي يتخلى عن بعض قواه فيدعم إحداها ويقلل من فاعلية الأخرى.
هناك صراع مستمر داخل الإنسان بين قواه النفسية، وهناك صراع دائر بين القوى الرحمانية في النفس والقوى الشيطانية، فأيها ينتصر يصبح هو الحاكم على الإنسان، فإذا انتصرت القوة العقلية الملكية كان الإنسان صاحب ثلاث قوى من قوى النفس بحسب التقسيم العقائدي وهي الزكية والمطمئنة واللوامة.
وهناك فرقٌ ملحوظ بين التقسيم العقائدي والتقسيم العلمي للنفس.
ففي التقسيم العقائدي يوجد ثلاث قوى رحمانية، وقوة واحدة شيطانية، أما في التقسيم العلمي فالمعادلة معكوسة حيث يوجد ثلاث قوى شيطانية وواحدة رحمانية.
فقوة النفس العقلية الملكية تأتمر بأوامر العقل الذي لا يُرشد إلا لفعل الصواب، ويندرج تحت هذا التقسيم ثلاث قوة من قوى النفس بحسب التقسيم العقائدي، وهي القوى التي تدفع بصاحبها نحو الخير.
ولا يشك أحد بالتأثير الفعّال لهذه القوة، ولكن لا يعني أنها أقوى من القوى الرحمانية، ونحن نؤمن بأحد أمرين يتصلان بإيماننا بالرحمة والعدالة الإلهية.
نؤمن يقيناً بأن قوى الخير في الإنسان أقوى من قوى الشر، وإذا لم تكن النسبة دقيقة فإن مستوى هذه القوة بمستوى القوى الرحمانية على أقل تقدير، وهذا القول ينسجم مع معنى الإمتحان وموازينه.
أما التعبير عن كون القوى الرحمانية أقوى فهو من باب الثقة المطلقة بالرحمة الإلهية، ولكننا لو دققنا قليلاً في الأمر لأدركنا وجود خلل في هذا التعبير حيث يضرب موازين الإمتحان المفروض من قِبل الله عز وجل، لأن الإعتقاد بكون القوى الرحمانية أقوى فهذا يعني أن الإنسان مجبور على الخير، والواقع أنه مخير، والتخيير يستلزم أن تكون القوتان بمستوى واحد، ونفس الكلام يجري فيما إذا اعتبرنا بأن قوى الشر أقوى.
والأمر متروك لصاحب النفس فهو الذي يقدر على جعل هذه أقوى أو تلك.
فالقوة العقلية الملكية هي القوة التي لازمت الأنبياء والأوصياء والصلحاء عبر الزمن لأنها القوة التي تنصاع إلى أوامر الخالق ونواهيه.
القسم الثاني: القوة الوهمية الشيطانية:
وهي ذات علاقة متينة بالنفس الأمارة بالسوء، وهي من القوى التي تخضع للوسوسة الشيطانية.
واسمها ينبئ عن مضمونها، فهي تعمل بالوهم الشيطاني، ونعني بالوهم الشيطاني ما يقابل الوهم الطبيعي الناشئ عن الجهل.
وهي تقابل الوهم المنطقي الذي معناه الإحتمال كمن يتوهم بصحة شيء فاسد أو فساد شيء صحيح نظراً لعدم المعرفة.
وهي القوة التي يعمل بها قومٌ وقفوا طاقاتهم لخدمة إبليس، فهم يمارسون دوره في المجتمع ويوهمون الناس بأن الباطل حق، والحق باطل، ويستعملون أسلوب المراوغة في بيان الأمور من باب التمويه، ولعلها أكثر القوى انتشاراً في المجتمع البشري الذي بدأ بالحسد والقتل، وما زالت تلك الممارسات مستمرة حتى اللحظة.
إن أصحاب هذه القوة يحاولون بألف وسيلة ووسيلة أن يخدعوا القلوب قبل الآذان، فهم يستعملون العبارات المبهمة التي تحتمل أكثر من معنى، ويستعملون الأساليب التي يضمنون معها عدم المساءلة، فهم يوسوسون للناس بطرق خاصة، ويوصلون إليهم الأمر وكأنهم لم يشيروا إليه حتى يقع الإنسان في المخالفة ويصبح رهين شهواته وأخطائه فيعلنون البراءة من فعله ويتنصلون من تحمّل المسؤولية مدعين بأنهم لم يقصدوا إيصاله إلى الخطأ.
ولعل هذه القوة ترتبط بشيطان يُطلق عليه(الشيطان الأبيض) وهو المكفل بالوسوسة للأنبياء والصلحاء، وقصّة الراهب برصيصا أكبر شاهد على الأسلوب الذي يستخدمه هذا الشيطان الرجيم حيث استدرجه بطريقة ذكية للوقوع في الحرام فجعله يخسر الدنيا والآخرة في آن واحد.
وهذا يخضع لحدود سلطة الشيطان على النفس، فلقد سلّطه الله على النفس ليختبر عباده، ولا يمكن للشيطان أن يُجبر أحداً على الخطأ لأن المسموح به للشيطان هو الوسوسة فقط، وعلى الإنسان أن يكون حذراً في التعاطي مع هذا العدو الخطير الذي يجري في عروقه.
وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون الشيطان مسلطاً على النفس البشرية في حدود معينة حتى تكتمل بذلك عناصر الإختبار، وإلى هذا يشير الله سبحانه بقوله في سورة الأعراف(قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ * قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ * قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ)
القسم الثالث: القوة الغضبية السبعية:
حين خلق الله تعالى هذا الإنسان ميّزه عن باقي مخلوقاته بالكثير من المميزات، فوهبه العقل وخلق فيه مشاعر خاصة تختلف بمكان ما عن مشاعر غيره من ذوي الأرواح.
فالحيوان يمتلك العديد من المشاعر والأحاسيس، ويتعامل بها عن طريق الغريزة، ويشترك معه الإنسان في امتلاك تلك المشاعر، ولكن القوة العقلية في الإنسان توجّه تلك المشاعر توجيهاً منطقياً على خلاف استعمالها لدى الحيوانات.
فالحب في الإنسان شعولا عاطفي، ولكنه يمر عن طريق العقل، فيعمل الإنسان ما يرغب به محبوبه، ونفس هذا الحب موجود في الحيوان، ولكنه لا يمر فيه عن طريق العقل بل عن طريق الغريزة التي تختلف كثيراً مع أحكام العقل.
فبدل أن يستغل بعض الناس قوة عقولهم لتوجيه قوى النفس في داخلهم راحوا يمارسون بعض القوى كما يمارسها الحيوان الذي نزّهنا الله عنه.
فالسبعية من صفات السباع وليس من صفات الإنسانية، فإذا استعمل المرء هذه القوة فقد نزل بمستواه إلى مستوى السباع، فيخيف الناس ويرهبهم حتى يسيطر عليهم أو ينال منهم مراده كما يصنع الحيوان القوي تماماً مع الحيوان الضعيف حتى يسرق له فريسته عن طريق الترهيب.
فهذه القوة تدعو إلى الغضب في حالات لا يليق بها الغضب، ولكن بما أنها سيطرت على صاحبها فهي تكمه وتوجهه، وهذا يعني دمار إنسانية هذا الإنسان.
القسم الرابع: القوة الشهوية البهيمية:
خلق الله الإنسان مفطوراً على العديد من الأمور كالتوحيد وحب المعرفة، وخلق فيه الكثير من الحاجات التكوينية التي لا يمكن أن تستمر حياته إلا بها.
ومن تلك الحاجات مسألة إشباع الشهوات، وهي كثيرة في الإنسان قليلة في باقي المخلوقات الحية، ومعدومة في بعض المخلوقات كالملائكة.
ولكي نقرّب المعنى الحقيقي إلى الأذهان كان لا بد من إجراء مقارنة بين ما يطلبه الإنسان من الإشباع وما يطلبه الحيوان من ذات الشيء، فيمكن حصر شهوات الحيوان في ثلاث، أكل ونوم وتزاوج.
أما في الإنسان فيصعب حصر الشهوات لديه، ويعود السبب في كثرتها عند الإنسان إلى كونه عاقلاً وذا بنيان يسمح له بالقيام في أكثر من شأن.
فيشترك الإنسان مع الحيوان في الشهوات الثلاث المذكورة ويفترق عنه بشهوات السلطة والتطور والمعرفة والتسلط وجمع الثروات وما يشبههما من الشهوات الكثيرة.
ويفترق الإنسان عن الحيوان بعقله وقواه النفسية المتعددة، ولكل واحدة من هذه القوى شهواتها الخاصة.
والنتيجة الواضحة أن ذوي الأرواح يطلبون إشباع الشهوات، أما شهوات الحيوان فلا قيود لها ولا ضوابط تقيدها، وأما الإنسان فينقسم في عملية الإشباع إلى قسمين:
القسم الأول: وهم الذين يطلبون الإشباع من دون التقيد بالضوابط ومن دون مراعاة الأحكام الإلهية، فيزنون ويشربون الخمر ويلعبون القمار ويفعلون الكثير من المحرمات، وهؤلاء شأنهم شأن الحيوان، غير أنهم مسؤولون عن فعلهم دون الحيوان، وقد أعدّ الله لهم من العذاب ما يستحقونه في يوم القيامة إن لم يعملوا على التغيير والإنضباط، فهم أصحاب القوة الشهوية البهيمية التي تنزل بالإنسان من مستواه الطبيعي إلى ما لا يليق بشأنه كمخلوق كرّمه ربه.
القسم الثاني: وهم الذين يطلبون الإشباع ولكن عن طريق القانون الإلهي فلا يرتكبون المحرمات ولا يخرجون عن الجادة المرسومة لهم.
وقد ورد في الحديث أن الإنسان بعمله يستطيع أن يكون أرفع شأناً من الملائكة أو أوضع شأناً من الحيوان، فهو في دائرة التخيير، وهو مسؤول عما يختار.
وإن أفضل درس أُعطي للبشرية حول ترويض النفس ما ذكره الإمام علي(ع) في خطبة له في نهج البلاغة حيث قال:
“فَإنَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ-كَانَ يَقُولُ: «إنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، وَإنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ». وَاعْلَمُوا أنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللهِ شَيْءٌ إلاَّ يَأْتي فِي كُرْهٍ، وَمَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ شَيءٌ إلاَّ يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ. فَرَحِمَ اللهُ رَجُلاً نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ، وَقَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ، فَإنَّ هذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْءٍ مَنْزِعاً، وَإنَّهَا لاَ تَزَالُ تَنْزِعُ إِلَى مَعْصِيَةٍ فِي هَوىً. وَاعْلَمُوا ـ عِبَادَ اللهِ ـ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي إلاَّ وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ، فَلاَ يَزَالُ زَارِياً عَلَيْهَا وَمُسْتَزِيْداً لَهَا. فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ، وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ”
النَّفْسُ فِيْ السُّنَّةِ المُطَهَّرَة
لا شك بأن نظرة السنة إلى النفس كنظرة القرآن الكريم لها، غير أن السنة قد أظهرت الكثير عن خصائصها وفسرت بعض الجوانب الغامضة التي لم يتعرض القرآن لها بسبب الإيجاز المنزل به.
ولا تفترق قيمة كلام السنة عن قيمة كلام القرآن غير أن لفظ القرآن ومعناه من الله تعالى، وأما السنة فمعانيها من الله وألفاظها من المعصومين(ع).
ولذلك سوف نعمد إلى ذكر بعض الأحاديث الواردة لبيان النفس وقواها ووظائفها.
قال أمير المؤمنين(ع) ” إن النفس لجوهرة ثمينة من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها”
وقال(ع) ” ليس على وجه الأرض أكرم على الله سبحانه من النفس المطيعة لأمره”
وفي بيان النفس الأمارة بالسوء قال(ع) ” النفس الأمارة المسوّلة تتملق تملق المنافق وتتصنع بشيمة الصديق الموافق، حتى إذا خدعت وتمكنت تسلطت تسلط العدو وتحكمت تحكم العتو فأوردت موارد السوء”
وقال(ع) ” إن النفس لأمارة بالسوء والفحشاء فمن ائتمنها خانته ومن استنام إليها أهلكته ومن رضي عنها أوردته شر المورد”
عندما مر(ع) بقتلى الخوارج يوم النهروان قال ” بؤساً لكم لقد ضركم من غركم، فقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: الشيطان المضل والأنفس الأمارة بالسوء غرتهم بالأماني وفسحت لهم بالمعاصي ووعدتهم الإظهار فاقتحمت بهم النار”
وفي مناجاة الإمام زين العابدين(ع) ” إلهي إليك أشكو نفساً بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة…كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع، ميّالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو”
وفي دعاء للإمام الصادق(ع) ” أسألك أن تعصمني من معاصيك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ما أحييتني لا أقل من ذلك ولا أكثر إن النفس لأمارة بالسوء إلى ما رحمت يا أرحم الراحمين”
قال أمير المؤمنين(ع) ” أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه”
وقال” غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه”
وقال” نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس”
وكنا قد أشرنا إلى أن الإنسان لا يمكن له معرفة الغير قبل معرفة النفس ولهذا قال الإمام علي(ع)” من جهل نفسه كان بغيره أجهل”
وفي حديث آخر” من عرف نفسه كان لغيره أعرف”
وفي موضع آخر قال(ع)” عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه”
وقد بين النبي(ص) بعض فوائد معرفة النفس وذلك عندما سأله رجل فقال: يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال(ص) معرفة النفس، فقال الرجل: كيف الطريق إلى موافقة الحق؟ فقال(ص) مخالفة النفس، فقال: كيف الطريق إلى رضا الحق؟ فقال(ص) سخط النفس، فقال: كيف الطريق إلى وصل الحق؟ قال(ص) هجر النفس، قال الرجل: فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال(ص) عصيان النفس، فقال: كيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قال(ص) نسيان النفس، فقال: كيف الطريق إلى قرب الحق؟ قال(ص) التباعد من النفس، فقال: كيف الطريق إلى أنس الحق؟ قال(ص) الوحشة من النفس، فقال الرجل: يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذلك؟ قال: الاستعانة بالحق على النفس.
النَّفْسُ بِحَسَبِ التَّقْسِيْمِ العَقَائِدي
عرفنا فيما سبق تقسيم النفس في المصطلح العلمي لدى علماء النفس، بقي أن نبيّن أقسامها كما ورد في القرآن الكريم وعلى لسان النبي الأمين وآله الطاهرين(ص) فإنه وإن كان التقسيم العلمي مفيداً في مجال البحث عنها، ولكنه يبقى ناقصاً ما لم نركز على تقسيمها العقائدي لأنه الأهم في نظرنا.
وهذا التقسيم للنفس بكلا نوعيه(العلمي والعقائدي) يستفاد منه وجود نسب مختلفة بين قسم وقسم آخر، ووجود نسب أيضاً في القسم نفسه.
وعلى سبيل المثال فإن النفس الأمارة بالسوء ليست بقوة واحدة في الجميع، وليس طريقها إلى القلب واحداً، فهناك طرق كثيرة لها ووسائل عديدة ونسبٌ متفاوتة.
فهذا تسوّل له نفسه القتل، وذلك الزنا، وآخر شرب الخمر، ومع التدقيق في جوهر هذه القوة نجد بأن الداعي لشرب الخمر غير الداعي إلى القتل أو إلى السرقة.
بعض الناس يطلقون العنان أمام هذه القوة فترتكب أنواعاً كثيرة من الكبائر والصغائر من دون أن يلتفتوا يوماً إلى عواقب هذا الفلتان الخطير.
وبعضهم يطلقون هذا العنان لفترة وجيزة أو في مجالات محدودة فتراه يرتكب نوعاً من أنواع المحرمات.
وبناءاً عليه لا يمكن القول بأن النسبة واحدة في الجميع لأن هناك ميزاناً في القلب يرجح أحد طرفيه بتدني الآخر.
ونفس ما يقال في هذه القوة يمكن أن يقال في غيرها من قوى الخير وقوى الشر، فالنفس الزكية ليست واحدة في جميع المؤمنين بدليل أن الله تعالى جعلهم في الجنة طبقات ووضع لهم درجات بحسب الأعمال التي قاموا بها في دار الدنيا، فلو كانت النسبة واحدة في الجميع لكان جميع أهل الجنة في درجة واحدة، وجميع أهل النار في درجة واحدة أيضاً، وهذا ما يتعارض مع ظاهر القرآن الكريم حيث أخبرنا ربنا تعالى عن اختلاف النسبة بين عبد وآخر، وبالتالي عن اختلاف درجة كل واحد عن الآخر مع إمكان أن يتفق أكثر من واحد على نسبة واحدة في الخير أو الشر، قال سبحانه في سورة آل عمران(هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ)
وفي سورة الأنعام(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)
ومردّ هذا الجعل إلى السلوك والعمل، فإن الإنسان ترتفع درجاته عند ربه أو حتى في الدنيا بسبب سلوكه.
وإما أن تكون الرفعة للبعض في الدنيا بهدف الإمتحان لهم، فإن الله تعالى يعطي البعض ليمتحنهم فيما آتاهم، وهذا ما أشار إليه القرآن لدى حديثه عن عطاء الله سبحانه لقارون(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)
وهذا التفاوت موجود بين الأنبياء(ع) وفي قال سبحانه في سورة البقرة(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)
الفَوَارِقُ الأَسَاسِيَّةُ بَيْنَ قُوَى النَّفْسِ
عرفنا فيما سبق أن أقسام النفس بحسب الشريعة أربعة، ولكن بعض العلماء نسف واحدة منها معتبراً أن النفس اللوامة والنفس المطمئنة يكوّنان بمجموعهما ما يسمى بالنفس الزكية، ولا مانع عقلي أو علمي أو شرعي من هذا التفسير.
فالنفس الأمارة بالسوء تدعو إلى فعل المحرمات، والنفس اللوامة تلوم صاحبها وتؤنبه عند اقتراف السيئة، فإذا تأنب ضميره ورجع إلى صوابه وتاب إلى ربه أصبح صاحب نفس مطمئنة.
أما تقسيمنا نحن قوى النفس إلى أربعة فهو من باب أنّ ما تقوم به النفس الزكية غير ما تقوم به النفس اللوامة، فهناك لومٌ ثم تزكية للعمل، ثم نصل إلى درجة الإطمئنان.
ولذا يمكن القول بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المطمئنة واللوامة والزكية بحيث يتحول الجميع إلى واحدة(مطمئنة) ولكن لا يتم هذا التحول إلا بالمرور على اللوم وتزكية الأعمال.
فالإسم مستنبط من الوظيفة، ولأن وظيفة هذه القوة كانت لوم النفس فقد أُطلق عليها اللوامة، ولأن وظيفة الثانية التزكية كانت نفساً زكية، ومن هنا نشأ التقسيم إلى أربعة أقسام دون الثلاثة.
أما المطمئنة فلا وظيفة لها لأن وظائف اللوامة والزكية ينتج عنها اطمئنان النفس، فهي نتيجة لتلك الوظائف.
والنتيجة: إن النفس المطمئنة هي القوة الناجمة عن حسم الصراع بين اللوامة والأمارة لصالح الأولى، فإن حصل ذلك كان صاحبها مشمولاً بقوله تعالى(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً)
النَّفْسُ الأَمَّارَةُ بِالسُّوء
نبدأ البحث بقوله سبحانه(وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ){يوسف/53}
إنها من الآيات التي يتداولها الناس فيما بينهم بمناسبة وغير مناسبة، وبمعرفة وعن غير معرفة في مضمونها والمراد منها.
وقد وردت هذه الآية لدى حديث الله تعالى عن امرأة العزيز التي راودت فتاها عن نفسه وحاولت أن تجبره على الخطأ، ولكنه عصم نفسه فكان من الفائزين.
وتُشعرنا الآية بأن هذا الكلام قد صدر عن تلك المرأة بعد أن افتُضح أمرها فشعرت بالندم واعترفت بالحقيقة التي بسببها وُضع الصدّيق يوسف(ع) في السجن لأعوام.
وقال بعض المفسرين إن هذا كلام يوسف(ع) يبيّن من خلاله حقيقة للعزيز وهي وإن كانت النفس أمارة بالسوء إلا أن ربي سبحانه عصمني عن الخطأ.
وأياً يكن القائل فإن معنى الآية واضح والدرس منها صريح، والتركيز هنا على مضمون الآية أهم من التركيز على القائل.
امرأة العزيز وكثير من الناس حتى زماننا يستعملون هذه الآية لتبرير أخطائهم وكأنهم غير مسؤولين عما يصدر منهم وعنهم، ولكن الحقيقة التي يحاول الكثيرون إخفاءها هي أن الآية الكريمة لم تَرِدْ لبيان التبرير فقط وإنما وردت لبيان مفهوم إنساني ديني واسع مؤدّاه أن النفس تشتمل على قوة تأمر صاحبها بالسوء وتحذرنا من الوقوع في أفخاخ هذه القوة التي لا ينجو من سوئها إلا القليل.
بعضهم كان عنده قصور في فهم الآية فظن بأن مضمونها يشكّل له عذراً في يوم القيامة، وهو وهمٌ واضح.
وبعضهم يدرك المعنى الحقيقي لها، ولكنه يحاول تصوير أمرها على وجه غير صحيح لغاية في نفسه.
وبعضهم يفهم المعنى بشكل صحيح ويطبق الأثر كما يجب، وهكذا يجب أن يكون كل مؤمن بالله وكتابه العزيز.
فالنفس البشرية أمّارة بالسوء، وهذا لا يعني أن نضعف أمامها ونستسلم لما تفرضه علينا، وإنما تجب مواجهتها بالقوى التي تقابلها لأن الله سبحانه أوجدها وأوجد في النفس ما يدرأ به الإنسان شر الوسوسة.
فالنفس الأمارة بالسوء واحدة، ولكن قوى الخير في النفس ثلاث:زكية ومطمئنة ولوامة: وهذا يعني رفض أي عذر يقدمه الإنسان المتذرع بالقوة السلبية.
فلو أن بعضهم حاول أن يتذرع بالتقسيم العلمي للنفس مدعياً بأن القوى للنفس أربع، واحدة تستمد القوة من العقل، وثلاث من الهوى؟
نقول: وإن كان هذا التقسيم صحيحاً ومنطقياً إلا أنّ علماء النفس يقولون بأن القوة العقلية رغم أحاديتها إلا أنها أقوى من سائرها، ولا شك بأن هذا الكلام صادر عن معرفة واسعة نتائج مؤكدة لدى علماء النفس.
وعلى الإنسان أن يعلم بأن الله سبحانه خلق النفس الأمارة بالسوء حتى يستقيم بها الإمتحان في الدنيا، وإلا فلا امتحان من الأساس، وعدم وجود الإمتحان في الحياة يعني اللغوية في الوجود والإيجاد، والله تعالى منزّه عن اللغو في الخلق والفعل.
إن باستطاعة الإنسان أن يدمّر هذه القوة في داخله تدميراً كاملاً عبر التزامه بأوامر ربه ونواهيه، فإن فعل ذلك كان وجود النفس الأمارة بالسوء فيه كعدم وجودها، وهو قادر على فعل ذلك حيث مكّنه ربه من المقاومة، ومع هذا التمكين لا يبقى للإنسان عذر في المخالفة.
صحيح.. إن الإنسان ليس معصوماً بالتكوين، ولكنه قادر على أن يدرك هذه المرحلة من خلال سلوكه والتزامه بفضل قوى الخير المودعة فيه حين الخلق.
فإذا أردتَ أن تحاجج ربك يوم القيامة بوجود هذه القوة فيك فسوف يحاججك ربك بوجود القوى المقابلة لها فيك، وببعثه للرسل، وإنزاله للكتب، وبآلاف التحذيرات التي وجهها إليك عبر أنبيائه وكتبه.
معنى ذلك أنك الخاسر الأكبر ما لم تطع رب العالمين وتعمل على وأد قوة الشر بداخلك، وهو أمر مقدور عليه، وبكل بساطة.
والآن نأتي إلى الشطر الآخر من الآية الكريمة، فلقد تحدثنا عن قوله سبحانه(إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) بقي الحديث عن قوله تعالى(إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
لا تعني الآية أن الله تعالى يعصم من يشاء ويوقع في المعصية من يشاء، وإنما تعني أن النفس وإن كانت أمارة بالسوء إلا أن الله يرحم الذين لم يديروا مسامع قلوبهم إلى هذه القوة.
وبمعنى آخر.. إن الله سبحانه يرحم من يطيعه ويحارب هذه القوة، فإن حاربها كان الله رحيماً به لأنه دله على طريق الخلاص، وإلا فلن يلوم الإنسان إلا نفسه.
ولا بد في نهاية هذا البحث أن نبيّن الدرس والموعظة المستفادة منه:
علينا أن نأخذ العبرة من الذين ظلموا أنفسهم بركوب الحرام واستسلموا لشهواتهم ونزواتهم حتى أصبحوا عبيداً للشيطان، فقد استخفوا بتلك التجاذبات فيهم والصراعات التي تدور في داخلهم حتى جاءهم ما كانوا يوعدون، وندموا حيث لا ينفع الندم، وطلبوا العودة حيث لا عودة، فقد أدركهم الموت الذي تناسوه حتى جاءهم بغتة فحال بينهم وبين التوبة وأغلق عليهم باب الأوبة فأصبحوا حطباً لنار جهنم.
وخير ما يقال في المقام موعظة لسيد المتقين الإمام علي(ع):
“لاَ يَنْزَجِرُ مِنَ اللهِ بِزَاجِرٍ، وَلاَيَتَّعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ، وَهُوَ يَرَى الْمَأْخُوذِينَ عَلَى الْغِرَّةِ، حَيْثُ لاَ إِقَالَةَ وَلاَ رَجْعَةَ، كَيْفَ نَزَلَ بِهمْ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ، وَجَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا يَأْمَنُونَ، وَقَدِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَى مَا كَانُوا يُوعَدُونَ”
ومهما حاولنا أن نوضّح حقيقة هذه القوة فلن نتمكن كما تمكن المعصومون سلام الله عليهم من بيان حقيقتها وآثارها وسلوكها مع صاحبها.
فعن أمير المؤمنين علي(ع) قال: إنّ النفس لأمارة بالسوء والفحشاء، فمن ائتمنها خانته، ومن استنام إليها أهلكته، ومن رضي عنها أوردته شر الموارد:كتاب غرر الحكم.
وعنه(ع): إن هذه النفس لأمارة بالسوء فمن أهملها جمحت به إلى المآثم: كتاب غرر الحكم.
وقد مرّ(ع) بقتلى الخوارج يوم النهروان فقال لهم: بؤساً لكم، لقد ضركم من غرّكم: فقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين؟ قال: الشيطان المُضل والأنفس الأمارة بالسوء، غرتهم بالأماني، وفسحت لهم بالمعاصي، ووعدتهم الإظهار، فاقتحمت بهم النار:نهج البلاغة
النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ
زكاة النفس هو الدواء الموصوف لعلاج فسادها، وهناك صراعٌ مستمر بين هذه القوة الرحمانية والنفس الأمارة بالسوء التي تدعو للمعصية وإشباع الشهوات بغير ضوابط، وتلك تأمرها بالإنضباط ومراعاة الأحكام الإلهية.
وتلك الأمراض الناجمة عن وسوسة النفس الأمارة بالسوء فتاكة من دون رحمة، وغدارة في أية لحظة، لا تدري متى توقعك، ولا تعلم أين تحفر لك.
لهذا كان الحذر مطلوباً ملحاً لأن حُفَر السوء عميقة لا يمكن الخروج منها بسهولة ما لم تكن النفس الزكية فعّالة وقوية وذات منعة.
ودواء هذا الداء موصوف في الكتاب العزيز الذي يدعو أولاً إلى عدم الإبتلاء بتلك الأمراض، وعلى فرض أن الإنسان لم يسمع فوقع في المعصية، فهناك في كتاب الله ما يخلصه وينقذه.
لقد أنزل الله كتابه الكريم من أجلنا، من أجل حفظ دنيانا وآخرتنا في ذات الوقت، وأنزل فيه التعاليم المطلوبة والإرشادات الكثيرة والمواعظ البليغة التي وضعها في خدمة الإنسان من أجل الإنسان حيث دلنا القرآن على مواطن السعادة ورسم لنا طرقها بشكل واضح.
لم يذكر الله تعالى إسم هذه القوة(النفس الزكية) بشكل صريح، وإنما ذكر لنا ما لو فعلناه لكنا أصحاب نفس زكية، فلم يتحدث عن النفس الزكية وإنما أشار إلى تزكية النفس، بخلاف باقي الأنفس فإنه ذكر أسماءها بشكل صريح كالمطمئنة واللوامة.
والكناية في بعض الأحيان أبلغ من التصريح، وقد يرِد هذا الأسلوب لبيان العظمة، ولكي يتضح البحث أكثر كان لا بد من الرجوع إلى الفوارق بين القوى الرحمانية الثلاث(المطمئنة والزكية واللوامة) فإذا أدركنا حقيقة تلك الفوارق بشكل جيد نكون قد أدركنا المعنى المراد من خلال هذا البحث.
ومن الإشارات القرآنية إلى وجود النفس الزكية قوله سبحانه في سورة الشمس(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)
وقد مرّ الحديث عن تزكية النفس في بحث القّسَم بالنفس، ولا حاجة إلى تكرار ما ذُكر.
ولكن ما أريد قوله هو أن النفس الزكية من أقسام النفس وليس جزءاً منتفياً كما اعتقد البعض.
ومن الدلائل القرآنية على وجود النفس الزكية قوله عز وجل في سورة النور(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
والفضل لله تعالى في كل شيء، وفي أنه خلقنا فينا قوى نستطيع من خلالها أن نجعل أنفسنا زكية، وبالتالي مطمئنة.
النَّفْسُ اللوَّامَة
شاءت حكمة الله سبحانه واقتضى عدله أن يجعل ميزاناً دقيقاً بين قوى النفس المتناحرة ليخلق بذلك تكافئاً في الصراع الداخلي الدائر بين قوى الخير وقوى الشر.
وبسبب ثقتنا المطلقة بالرحمة الإلهية الواسعة إعتقدنا بأن هذا التكافؤ قائماً على رجحان قوى الخير ليكون ذلك مساعداً أساسياً في مقارعة الشر، وحجة واضحة يحتج بها رب العالمين على عباده.
فبعد أن خلق الله تعالى قابلية في الإنسان للخير والشر دعم قابلية فعل الخير بخلق قوة جوهرية خفية يُطلق عليها(الفطرة) التي فطر جميع خلقه عليها، وأهم وظائف هذه القوة هي الدلالة على الوجود والوحدانية، وسوف يرد الحديث عنها مفصّلاً في محله بإذنه تعالى.
وهذا الميزان الدقيق الذي أشرنا إليه آنفاً وُضع في الإنسان لتستقيم به مقدمات الإمتحان المفروض على كل عاقل مكلَّف، وقد طرح الله في كتابه ما ينسجم مع واقع هذا الإمتحان من أوامر ونواه بيّنها بالتفصيل.
ولا يمكن لأي موجود أن يُنكر حقيقة الموجد والموجود، لأن الأدلة عليه متضافرة لا يمكن إنكارها بوجه من الوجوه، وقد جعل الله سبحانه آياته في كل ما يرى الإنسان ويسمع مما هو محيطٌ به أو بعيدٌ عنه.
وأودّ الإشارة إلى حقيقة ثابتة تتصل بعدل الله سبحانه، وهي الفرق بين كون الله جل وعلا لا يقبل الأعذار، وبين كون عدم وجود مجال للعذر.
إن الله سبحانه يقبل الأعذر، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن كثير، ولكن قد يصل حال الإنسان إلى حائط مسدود لا يُقبل معه عذر كما كان حال فرعون الذي كفر وظلم وعاند وهو في قرارة نفسه يعرف الحقيقة، ولهذا حُرم من قبول عذره، وهذا لا يختص بشخص فرعون، بل يشمل كل شخص شابه عملُه عملَه.
والحقيقة الثابتة هو أن الإنسان لا عذر له بعد أن أعطاه الله ما أعطاه وبيّن له ما بيّن له من تعاليم ومفاهيم وأسراراً، ولكنه سبحانه بحلمه وعفوه قد يقبل الأعذار في بعض الحالات كما قبِل عذر الوحشي قاتل حمزة عم النبي(ص).
لقد مرّ الكلام عن النفس الأمارة بالسوء والنفس الزكية، بقي لنا أن نعرّج على ما يتصل بالنفس اللوامة التي ذكرها الله سبحانه في سورة القيامة ضمن قسَم أقسم به حيث قال(لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ)
والنفس اللوامة هي من القوى الرحمانية المجعولة في الإنسان والتي اختُصت بإلقاء اللوم عليه حين الخطأ، فهي تستمر في لومه حتى يتراجع عن خطئه ويتوب من ذنبه لتجعل من نفسه نفساً زكية، وهذا الصراع يشعر به كل إنسان منا وإن لم يكن مؤمناً أو مسلماً لأنه موجود فينا بالتكوين.
ففي وصية رسول الله محمد(ص) لابن مسعود: يابن مسعود أكثر من الصالحات والبر، فإن المحسن والمسيء يندمان، يقول المحسن يا ليتني ازددت من الحسنات، ويقول المسيء قصّرتُ، وتصديق ذلك قوله تعالى(ولا أقسم بالنفس اللوامة):
وتعددت أقوال العلماء في حقيقة هذه النفس:
فقال بعضهم: هي نفس المؤمن التي تلومه في الدنيا على المعصية، وتنفعه يوم القيامة.
وقال آخرون: هي النفس الإنسانية بشكل علم من دون اختصاصها بالمؤمن أو الكافر، فهي تلوم الكافر يوم القيامة على كفره في الدنيا، وتلوم المؤمن على قلة الطاعة.
وقال البعض: إنها تختص بنفس الكافر.
ولو أردنا أن نكون منصفين لتبنّينا القول الثاني لأانها موجودة في كل إنسان، فإن اختصاصها بالمؤمن يُشعر بوجود ظلم لغيره، ويدل على ذلك وصية النبي(ص) لابن مسعود.
النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ
ننطلق في البحث من قول الله العظيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي)
لم تُذكر النفس المطمئنة في كتاب الله سوى مرة واحدة في سورة الفجر.
وقد جعلها البعض أجنبية عن قوى النفس لأنها نتيجة عمل النفس اللوامة، ولهذا لم يُدرجها لا في التقسيم العلمي، ولا في التقسيم العقائدي.
ولكنها موجودة بالفعل وإن لم يذكر البعض أو لم يعترفوا بأنها من قوى النفس المجعولة في الإنسان بهذه الدنيا.
ويمكن القول بأن هناك اتفاقاً بين الكثيرين على قوتين في النفس فقط، هما: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة معتبرين بأن زكاة النفس أو اطمئنانها ينجم من أثر اللوم.
وعلى أي حال لا بد لنا من تسليط الضوء على هذا البحث لأنه غاية في الدقة والأهمية، ولأنه قد يعارض بعض المسلَّمات لدى الناس.
إن كثيراً من الناس يطلقون لفظ المطمئنة على الموتى احتراماً لهم وللموت، ويضعون الآيات الكريمة المذكورة في أوراق النعي.
ولكن كثيراً من الذين يتداولون هذه الآيات أو كلمة المطمئنة يجهلون المعنى الحقيقي لها، وقد كثر استعمال لفظها في الأموات دون الأحياء، فهل هذا الإستعمال دليل على كونها مختصة بالنفس بعد الموت؟ أم أن التعبير هنا من باب المجاز فيصح إطلاقها في الحياة والموت على حدِ سواء؟
وقبل إبداء الرأي الخاص حول هذه الحقيقة أحب أن أشير إلى أن سياق الآيات المذكورة يوحي باختصاص المطمئنة بما بعد الموت لأن الآيات تحدثنا عما سوف يجري في يوم القيامة.
الله عز وجل يخاطب النفس المطمئنة بعد الحساب ويقول لها أدخلي جنتي مع عبادي الصالحين.
وهنا يفرض السؤال نفسه: هل أن استعمال القرآن لهذا اللفظ لدى حديثه عن أحداث يوم القيامة يخصصها؟ أم يجوز استعمالها في غير يوم القيامة؟
نحن نقول: لا ريب أن اطمئنان النفس ناجم عن العمل الصالح، والعمل الصالح لا يخرج إلا بعد صراع طويل بين النفس الأمارة والنفس اللوامة، فإذا انتصرت اللوامة على الأمارة خرج العمل الصالح، وكان صاحب هذا العمل صاحبَ نفس مطمئنة.
والعمل الصالح خاص بالدنيا وليس في الآخرة على اعتبار أن الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، فإذا كان صاحب العمل الصالح صاحب نفس مطمئنة جاز وصف نفسه بالإطمئنان قبل موته، وتكون النفس المطمئنة قِسماً من أقسام النفس بغض النظر عن كونها ذات وظيفة وعمل أو كونها نتيجة.
ونفس الذي نذكره حول النفس المطمئنة يجوز استعماله في النفس الزكية لوجود مشابهة قوية بينهما باعتبار كونهما ناجمين عن نتيجة العمل.
وإذا كان الإطمئنان من نتاج اللوم، فإن اللوم يحصل في الدنيا، وبالتالي فإن النتيجة تحصل في الدنيا أيضاً، فإن حصلت النتيجة في الدنيا جاز الوصف فيها.
وحال هذا اللفظ كحال غيره من الألفاظ المستعملة في الدنيا والآخرة كلفظ الإيمان والصلاح، فيقال للمؤمن مؤمن في الدنيا وكذلك في الآخرة.
ولا يهمنا ما إذا كانت المطمئنة لفظاً خاصاً بالدنيا أم الآخرة، أم كان مشتركاً بينهما، ولا يهمنا إن كانت مدرَجة تحت أقسام النفس أو لا، ما يهمنا أولاً وبالذات هو كيفية جعل النفس زكية ومطمئنة.
نترك هذا البيان للنبي وآله(ص) فهم أعظم من رسموا طرق السعادة لبني البشر.
عن الإمام علي(ع): سبب صلاح النفس العزوف عن الدنيا:
وعنه(ع): صلاح النفس مجاهدة الهوى:
وعنه(ع): أعون شيء على صلاح النفس القناعة:
وعنه(ع): سبب صلاح النفس الورع:
وعنه(ع): إذا رغبْتَ في صلاح نفسك فعليك بالإقتصاد والقُنوع والتقلل:
وعنه(ع) في نهج البلاغة”أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ، وَإِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُمْ، وَبِهِ نَجَاحُ طَلِبَتِكُمْ، وَإِلَيْهِ مُنْتَهْى رَغْبَتِكُمْ، وَنَحْوَهُ قَصْدُ سَبِيلِكُمْ، وَإِلَيْهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ، فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ، وَبَصَرُ عَمَى أَفِئِدَتِكُمْ، وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ، وَصَلاَحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ، وَطُهُورُ دَنَسِ أَنْفُسِكُمْ، وَجِلاَءُ عَشَا أَبْصَارِكُمْ، وَأَمْنُ فَزَعِ جَأْشِكُمْ، وَضِيَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمْ. فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللهِ شِعَاراً دُونَ دِثَارِكُمْ، وَدَخِيلاً دُونَ شِعَارِكُمْ”
بتطبيق هذا الوصايا والتعاليم تصبح النفس نفساً مطمئنة وإلا فإن صاحبها من أهل الشقاء.
آثَارُ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ فِيْ الدُّنْيِا وَالآخِرَة
بعد أن ذكرنا حقيقة النفس وبيّنا الفرق بين أقسامها وأشرنا إلى انقسامها باعتبارين مختلفين(علمي وعقائدي) رأينا من المناسب ذِكْرُ طرق محاسبتها ومراقبتها وتوجيهها توجيعاً صحيحاً وفعّالاً لأن ذلك يعنينا أكثر من معرفة حقيقتها وبيان أقسامها، فمن غير ذلك هذه الأساليب لا يبقى لباقي ما يتعلق بها أي شأن.
والغرض الأساسي من هذه البحوث هو الوعظ والتوجيه بطريقة دقيقة، أو قل بطريقة علمية إن صحّ التعبير إذ لا قيمة للبيان من دون توجيه، وما ذكرناه من مقدمات حول النفس وقواها يساعد على إدراك الأساليب التي تنقل النفس من السلب إلى الإيجاب، ومن ظلمة الجهل ‘لى نور المعرفة.
ولا بد من التركيز على حقيقة محاسبة النفس التي تحمل تلك الآثار الطيبة والنتائج الإيجابية.
فهناك نوعان لمحاسبة النفس في الدنيا بغض النظر عن يوم حسابها في الآخرة.
النوع الأول: هو الإختلاء بالنفس في أي وقت من الأوقات ومراجعة الحسابات والتدقيق فيما صدر عن النفس أثناء اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو فيما هو أكثر من ذلك، ولكن أفضل طريقة لمحاسبة النفس هو كل وقت تسمح فيه الفرصة وإن كان أكثر من مرة في اليوم الواحد.
فيختلي أصحاب هذا النوع بأنفسهم ويكتشفون عدد الأخطاء التي ارتكبوها، ويقف الأمر عندهم عند مسألة العد فقط من دون تحريك أي ساكن يدفع بالنفس نحو الإرتقاء.
النوع الثاني: هو مراقبة الأفعال والأقوال واكتشاف الفاسد منها وتصحيح ما فسد منها على أن يكون الوقوع في الخطأ هذا اليوم درساً له حتى لا يكرر مثل هذا الخطأ فيما بقي له من عمره، فهو يكتشف الخطأ ويستغفر منه ويتوب إليه ويعاهده بعدم العودة إلى ارتكاب مثل هذا الذنب، وهذا هو المطلوب في محاسبة النفس، بل هو الطريقة التي تعود على صاحبها بالمنفعة إن سلكها بالشكل الصحيح لأنه أدرك بأن حساب النفس في الدنيا أمرٌ يسير في مقابل حسابها يوم القيامة، فيستغفر كيلا يصل إلى يوم الحساب، وهناك لا منقذ له من تبعات ما قام به في دار الدنيا، ولهذا نجد القرآن الكريم يصف المؤمنين بأنهم يسألون ربهم أن يعجّل حسابهم في الدنيا قبل حلول يوم الحساب فقال سبحانه في سورة ص(وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ)
فمن آثار محاسبة النفس الدنيا الوقاية بمفهومها العام أي أنها تحفظه من شر النفس وتُبعد عنه شبح مخاطر السلوك السيء وتجعل منه إنساناً شبه متكامل.
أما آثارها في الآخرة فهو إرضاء الله سبحانه والفوز بالنعيم المقيم، وهذا ما يطمح إليه كل مؤمن، ومن هنا وردت الأحاديث الشريفة لتحث على محاسبة النفس من قِبل صاحبها قبل أن يحاسبها خالقها.
ومن آثار محاسبة النفس في الدنيا للآخرة هو أن الإنسان بمحاسبته لنفسه يخفف عنها أعباء الحساب يوم لقاء ربه.
إن أول من دعانا إلى محاسبة النفس هو الله تبارك وتعالى الذي جعل في ذلك رحمة لنا فقال سبحانه(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)
أيها الإنسان.. هل فكرتَ في قول الله عز وجل(يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ){الإنفطار/19}
هل فكرت في قول ربك(وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ)
هل نظرت في قول خالقك متأملاً(يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ)
هل فكرت في كل ما علّمك إياه ربك؟
الجواب عندك.
ولكي نفهم هذه الطرق بشكل أفضل نعود إلى ما ورد عن المعصومين(ع) في هذا الشأن، فقد جاء في خطبة للإمام علي(ع) في نهج البلاغة:
” عِبَادَ اللهِ، زِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا، وَحَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَتَنَفَّسُوا قَبْلَ ضِيقِ الْخِنَاقِ، وَانْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّيَاقِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَزَاجِرٌ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا زَاجِرٌ وَلاَ وَاعِظٌ”
إنه(ع) بهذه الكلمات النورانية يناشد عباد الله سلوك طرق الخير لهم في الدنيا والآخرة فيطلب منهم التنفس قبل أن يأتي يوم لا يستطيعون فيه ذلك، وهو تعبير مجازي بلا شك، فإن الإمام(ع) يريد أن يوضح لنا نقطة هامة، وهي أننا ما زلنا نملك الفرصة للتصحيح والخلاص والحركة بحرية عبر رقابة النفس ومحاسبتها، فإذا لم نكن نحن عوناً لأنفسنا فلن نجد من يعيننا عليها، ومن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ.
وفي خطبة أخرى له(ع) يُفصح في الموعظة أكثر فيقول:
“أَلاَ وَإنَّ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ اصْطَبَّهَا صَابُّهَا، أَلاَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلَّ وَلَدٍ سَيُلْحَقُ بِأَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ، وَغَداً حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ”
صحيح أن الدنيا دار عمل لا حساب فيها، ولكن من ألطاف ربنا علينا أنه جعل لنا مجالاً للحساب في دار العمل ليكون هذا الحساب في الدنيا ذاباًّ عنا بعض أهوال يوم الحساب.
أَنْوَاعُ مُحَاسَبَةِ النَّفْس
لم أشعر بأن القلوب شبعت مما ذكرناه حول محاسبة النفس فرأيت من الأنسب أن أزيد البحث إيضاحاً من باب الإستفادة، ومن باب إتمام الحجة حول هذا الأمر الشيق.
إن محاسبة النفس نوعان:
النوع الأول: ما يأتي قبل العمل:
ولعله من أكثر الأنواع انتشاراً بين المؤمنين، ورغم كونه منتشراً إلى هذا الحد تبقى الحاجة ملحة من تسليط الضوء على جوهره.
ينظر العبد إلى العمل، فإن كان ضمن حدود قدرته قام به كالصلاة والصوم، وإلا اندرج تحت عنوان لا يكلف الله نفساً إلا وسعها كالجهاد بالنسبة لمن أخرجهم الله عز وجل عن دائرة التكليف.
ثم ينظر إلى العمل مرة ثانية، فإن كان فيه خيرٌ له في الدنيا والآخرة أو في الآخرة خصوصاً قام به وإلا استغنى عنه.
ثم ينظر إلى تفاصيل أخرى فيحدد المصلحة ويقوم بها كما حاله في مراقبة العمل كونه لله أم لغير الله، فإن كان لله تقرّب به إليه وإلا تجاوز عن فعله، وهكذا.
النوع الثاني: ما يأتي بعد العمل:
ويمكن تلخيص محاسبة النفس بعد العمل في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: محاسبة النفس على التقصير في الطاعة، مما يسبب له حرماناً لبعض الأجر، كما لو طلب أحد من الناس منه مساعدة ولم يقم بها وكان بإمكانه القيام بها ولكنه استسلم للهوى فلم يغتنم الفرصة ففاته أجرٌ وثواب، هذا فيما إذا لم تكن المساعدة مندرجة تحت الضروريات الشرعية وإلا كان القيام بها واجباً.
فهنا يجلس بينه وبين نفسه فيؤنبها على هذا التقصير وينظر أقرب فرصة للتعويض.
الأمر الثاني: وهو يقابل الأول من حيث الماهية، ولكنه هذه المرة ينحصر في ترك شيء وليس في فعل شيء، كما لو قام بعمل مكروه لا عقاب عليه، فيندم ويعاهد ربه أن لا يقوم بمثله ثانية.
الأمر الثالث: وهو محاسبة النفس على بعض المباحات، فهذا الأمر ليس مطلوباً شرعياً ولكن القيام به يساعده على محاسبة نفسه كيلا تقع في الأعظم.
وبعد ذلك كله نستطيع أن نكتشف الكثير من الفوائد التي تعود على محاسب نفسه، والتي كان منها معرفة حق الله تعالى، ومقت النفس الأمارة بالسوء، والشعور بالندم أمام أي تقصير بفعل أو ترك، والزهد في الدنيا، والإجتهاد في طاعة، وغيرها الكثير من الفوائد المعلومة وغير المعلومة.
فهناك ميزان في الأمر، فإن التشديد على النفس في الدنيا يريحك كثيراً في يوم الحساب، وهذا أهم سبب للإنكباب على محاسبة النفس والإستمرار بهذا السلوك الإيماني العظيم.
وإليكم في ختام البحث موعظة من مواعظ الإمام علي(ع) الذي قال:
“وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ، فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ، فَإِنّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا. أَفَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ، وَالْعَثْرَةِ تُدْمِيهِ، وَالرَّمْضَاءِ تُحْرِقُهُ؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابَقَيْنِ مِنْ نَارٍ، ضَجِيعَ حَجَرٍ، وَقَرِينَ شَيْطَانٍ”
واعلموا أيها الأعزاء أن أعجز الناس هو من عجز عن إصلاح نفسه وتأديبها.