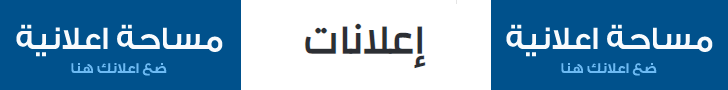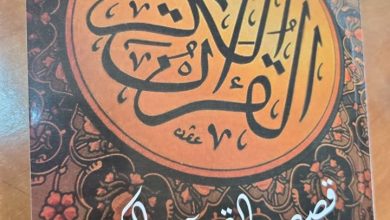الأجل
مهما طال عمر الإنسان في هذه الحياة فلا بد وأن يأتيه أجله في زمان ومكان لا يعلمهما غير الخالق سبحانه وتعالى فإن به تُختَم الحياة وينتقل الإنسان إلى المراحل الأخرى من أجل أن يحاسَب على ما قدمته يداه في دار الدنيا بالخير خيراً منه وبالشر شراً منه.
فلا يمكن لأي مخلوق أن يفارق هذه الحياة قبل حلول أجله لأن الأمر كتاب مؤجل وهو بيد الله الذي كان الموت والحياة بيده، فلقد ذكر القرآن الكريم هذه الناحية فقال(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً) ولهذا فقد ورد عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم أن الأجل حصن حصين لذي الروح وأنه الحارس له، وإلى هذا المعنى يشير علي(ع) بقوله:كفى بالأجل حرزاً إنه ليس أحد من الناس إلا ومعه حَفَظة من الله يحفظونه أن لا يتردّى في بئر ولا يقعَ عليه حائط ولا يصيبَه سَبُعٌ فإذا جاء أجله خلَّوا بينه وبين أجله:
فالخروج عن نظام الأجل أمر لا يقدر عليه الإنسان بالغاً ما بلغ لأنه يفوق قدرته وإرادته فلا أحد من الناس يوجد بإرادته ولا يمكن له أن يختم حياته بإرادته إلا إذا جاء أجله الذي لا يمكن تقريبه أو إبعاده حيث جعل الله تعالى لكل شيء أجلاً ولكل أمة اجلها الخاص بها فقال تعالى(ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) وقال سبحانه(وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون)
إن أجلنا بيد الله وعلمه ولكنه تعالى قادر على أن يطيل الأجل أو يقصره نتيجة لبعض الأعمال والظروف الخاصة حيث ورد أن هناك أعمالا إذا قام بها المرء طال عمره كصلة الأرحام مثلاً وبعض أعمال البر والإحسان وهذا ما يستفاد من قول علي(ع) بالصدقة تُفسح الآجال: يعني تصبح قابلة للتوسعة والتمديد، وقد أشار الصادق إلى هذا المعنى عندما قال: يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم: ونحن بدورنا عندما نقرأ هذا الكلام نفهم منه أمرين:
الأمر الأول: أن المرء بإحسانه قد يطول عمره فيعيش ثمانين بدل سبعين أو أقل، وأنه بارتكابه السوء يعيش خمسين بدل ستين أو أكثر. وقد عرفنا بأن هناك سلوكيات تطيل في عمر الإنسان فتفسح له في أجله فيتأخر انتقاله إلى عالم الآخرة.
الأمر الثاني: وهو أن المحسن يبقى ذكره عامراً وحياً في قلوب الناس مدة طويلة من الزمن حتى وإن مات وغيّب التراب جسده، وأن المذنب يموت في نظر الناس قبل أن يميته أجله، ولكن الأمر الأول هو الأرجح.
الشيخ علي فقيه