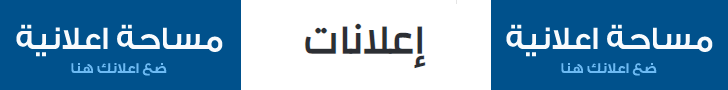أَخْبَارٌ وَأَنْبَاءٌ مِنْ حَيَاةِ الأَنْبِيَاء
نَبِي اللهِ نُوْحٌ(ع)

نَبِي اللهِ نُوْحٌ(ع)
قبل أن نبدأ البحث حول تاريخ ومواقف هذا النبي العظيم أحببت أن أتبرّك بذكر بعض النصوص القرآنية الكريمة التي تعرضت لذكر أحوال أبي البشر الثاني(ع) لتكون تلك النصوص هي المدخل الأساسي لهذا البحث النبوي الرسالي الذي فيه الكثير من الدروس والعبر والفوائد الجمّة.
قال سبحانه وتعالى(إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ){آل عمران/33}
وقال جلّ وعلا(وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ){الأنعام/84}
وقال عز جل(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ * قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ * أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ){الأعراف59/62}
وقال عزّ مِن قائل(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ * فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ){يونس71/73}
وقال تعالى(وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ){الأنبياء76/77}
وقال تبارك وتعالى(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ){المؤمنون/23}
وقال سبحانه(كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ){الشعراء105/109}
وقال تعالى(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ * فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ){العنكبوت/15}
إِرْسَالُ نُوْحٍ(ع) إِلَى البَشَرِية
قال تعالى(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ){هود/25}
وقال سبحانه(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ)
وقال تعالى(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا)
تنص هذه الآيات الكريمة على أن نوحاً(ع) مرسلٌ من عند ربه، فشأنه شأن جميع الأنبياء الذين أرسلهم ربهم للدلالة عليه وتعليم الناس ما يصلح به حالهم على مستوى الدنيا والآخرة.
وفي هذه الآيات الثلاث بيانٌ لإرسال نوح، ولكن ذيل كل آية يشير إلى موضوع خاص.
ففي الآية الأولى أشير إلى أن الله تعالى أرسله إلى الناس نذيراً ومبيناً، وفي الآية الثانية أشير إلى أنه دعاهم إلى التوحيد، وفي الثالثة بيّن القرآن الكريم المدة التي قضاها نوح بين أفراد قومه.
مَنْ هُمْ قَوْمُ نُوْح
نلاحظ في هذه الآيات الثلاث وفي غيرها مما لم نذكر هنا أن الله تعالى أكّد على كونه مبعوثاً لقومه، وهذا لا يعني استثناء مجموعة من الناس حيث لم يرد أنه في زمن نوح(ع) كان يوجد غيره من الأنبياء في مناطق أخرى، ولعل المراد بقومه هنا هو كل سكان الأرض لأن رسالته كانت عالمية، ويشهد على ذلك الطوفان الذي قضى على جميع سكان الأرض بعد دعوة نوح للجميع، فلو لم تكن رسالته عالمية وشاملة لجميع سكان الأرض لما شمل العذاب جميع العالم خصوصاً وأن الله تعالى يقول بصريح العبارة(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً){الإسراء/15}
لقد أرسله الله عز وجل بشيراً إلى الناس بالسعادة والجنة الواسعة وكل خير، ونذيراً لينذرهم ويحذرهم من البقاء على الكفر الذي ليس له سبب سوى المعاندة، ويلقي الحجة عليهم كيلا يكون لهم حجة على الله في يوم الحساب.
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ) هذه الدعوة هي الوظيفة الأساس في مهمات الأنبياء والرسل من عهد آدم وإلى عهد خاتم النبيين(ص)، وكلام نوح(ع) يدلنا على أن البشرية منذ قديم الزمان كانت غارقة في ظلمات الوثنية المتنوعة التي أُشرِبَت في نفوسهم رغم اختلال أركانها من الأساس بحيث كانت تستوعب الكرة الأرضية في ذلك الزمان، ولم يكن على وجه الأرض مؤمن غير نوح وقلة قليلة من أرحامه كما ينص التاريخ، ولعله كان النبي الأوحد الموجود في الأرض لأن السفينة التي صنعها لم يكن عليها نبي آخر.
لقد كانت مهمته صعبة للغاية حيث بعثه الله في زمنٍ سيطرت فيه الوثنية على جميع الناس فأبعدت الحق عنهم وأنستهم الفطرة السليمة التي أنشأهم الله عليها، فراحوا يعبدون من الأوثان ما يجهلون أعدادها ووظائفها، وكثرت بذلك الفئات والمعتقدات مما أدى إلى تدمير النفوس التي أصبحت مُلكاً للشيطان الرجيم.
فنوح(ع) أدى الواجب بكل نشاط وصبر، وتحمَّل الأذى المادي والمعنوي من الوثنيين الذين حملوا دعوته على محمل الإستهزاء، وعيّروه بوظيفته ومهنته قبل النبوة حيث كان نجاراً، فراحوا يتهمونه بأنه بدَّل مهنة النجارة بمهنة النبوة، وهكذا كانوا يتعاملون معه، ومن هنا تظهر لنا عظمة أنبيائنا.
فعلى فرض أنك أيها المؤمن أردت أن تعظ شخصاً كافراً أو عاصياً ولم يقبل منك الكلام فأخذه بعين السخرية، فهل توطِّن نفسك مرة ثانية على وعظه؟ بالطبع لا، لأنك تعتبر أن في وعظه مرة أخرى إهانة لك وانتقاصاً من شأنك وكرامتك.
نبي الله نوح(ع) وعظ قومه آلاف المرات، وقد وُوْجِه بأشد أنواع الإهانات، ومع ذلك صبر عليهم ما يقرب من ألف سنة، فلو لم يكن عظيماً لما صبر طيلة تلك المدة.
لقد حدثنا القرآن عن ألف إلا خمسين عاماً، وهي المدة التي عاشها مع قومه بعد تكليفه بمهام تبليغ الرسالة، ولكن صبره على الأذى تجاوز هذه المدة لأنه كان صابراً منذ زمن بعيد قبل مبعثه، كان يرى الظلم والإنحراف والفساد، ولكنه كان عاجزاً عن صنع أي شيء لأن العلاج كان موقوفاً على الأمر الإلهي.
ثم إنه بعد حدوث الطوفان وانتشار الخلق على الأرض من جديد لم يشعر نوح بالراحة لأنه تابع تأدية الرسالة كما كان يؤديها قبل حدوث الطوفان.
إِتهَامُ نُوْحٍ بِالْكَذِبِ وَوَصْفُ المُؤْمِنِيْنَ بِالأَرَاْذِلِ
من خلال الإطلاع على سلوك المعاندين الذين واجهوا الرسالات السماوية بالتكذيب وتوجيه الصفات القبيحة لها ولحامليها، ومن خلال اتهامهم لمن آمن معهم بالسحر والجنون وما شاكل ذلك من الأسلحة التي استعملها الكفار والمعاندون ضد رسالات السماء، ومن خلال دراسة أحوالهم والمقارنة بين جميع الحوارات التي دارت بين جميع الأنبياء من جهة، وأقوامهم من جهة ثانية ظهر لنا وبكل وضوح أن هناك قاسماً مشتركاً بين جميع الأقوام رغم البُعد الزمني الفاصل بينهم، وهو توجيه الإتهامات للأنبياء من دون أن تكون للتهمة أساس أو منبع أو سبب منطقي، وإنما وُجّهت تلك الإتهامات لمجرد المواجهة والتكذيب المتعَمَّد.
فبعد أن أرسل الله نوحاً إلى قومه ليبلِّغهم رسالات السماء وينصح لهم ويهديهم إلى الرشد والصواب والهدى رفضوا كلامه وأصروا على ما هم عليه من الظلم والضلال والإنحراف الأخلاقي، وقد ذكر لنا القرآن جواب قوم نوح المشابه لأجوبة غيرهم من أقوام الأنبياء قبل نوح وبعده حيث قال تعالى(فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ){هود/27}
هذا هو الجواب الذي استعمله الكفار والمشركون، بل هو السلاح الذي شهروه في وجوه الأنبياء، وقد توارثه الأبناء عن الآباء والأجداد، ولكن هناك في الآية المذكورة أمور يجب الوقوف عليها، وذلك من باب الإحاطة بالفائدة الكاملة، فإن هناك خمسة أمور أشير إليها في الآية المباركة:
الأمر الأول: (فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ) فالذين واجهوا نوحاً وأنكروا رسالته هم مجموعة من قومه في مقابل المجموعة التي آمنت به وبرسالته، وهم -أي الذين آمنوا معه- يشكِّلون عدداً ضئيلاً للغاية يكاد يوصف ببضع، أي أنه لم يتجاوز العشرة في بادئ الأمر لأن الأغلبية الساحقة من قومه أصروا على الكفر وذلك بدليل أن الذين ركبوا السفينة معه كان عددهم قليلاً جداً، وقد ورد عن الإمام الباقر(ع) عندما سُئل عن قوله تعالى(وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ) أنهم كانوا ثمانية:
فَخَرَجَ بقوله(الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ) تلك المجموعة التي آمنت به، وهذا ما يُظهر لنا الدقة في التعابير القرآنية التي شكّلت جزءاً من المعجزة الخالدة.
الأمر الثاني🙁مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا) وهذا ليس رداً منطقياً، فهو حُجة احتج بها الكفار بهدف تكذيب نوح، وهي أن الله تعالى يتخذ من البشر رسلاً وأنبياءاً، ولعل الحكمة في ذلك هي الحفاظ على موازين الإمتحان، وقد طلب بعض الأقوام من أنبيائهم أن يأتوهم بالملائكة، وعلى فرض أنه تعالى استجاب لذلك فلن يؤمنوا به لأن العناد حائط كبير وسدٌ منيع لا تتجاوزه حتى المعجزات، فلو أنزل الله إليهم ملكاً لتعاملوا معه بنفس الطريقة التي تعاملوا بها مع أنبيائهم، بل إن اتخاذ الأنبياء منهم أبلغ لهم وأفضل، حيث يمكن لهم رؤية الإعجاز منه الدال على صدق نبوته، أما إرسال الملَك إليهم فسوف لا يشعرون بالإعجاز الذي يأتي به لأن نفس إنزال الملك إليهم هو معجزة، فإذا كان أصل الرسول معجزة فلا تظهر معه المعجزة إذا جرت على يديه لأنها سوف تكون حينئذ من طبيعته، والمفروض أن تكون المعجزة خارقة لقوانين الطبيعة، فلكي تُسمى المعجزة معجزةً فلا بد من أن تصدر عن إنسان عادي.
ولو أنزل الله إليهم ملكاً فسوف ينزله على هيئة البشر كالملائكة الذين أنزلهم على نبيّه لوط، فلو نزل الملك على هيئته التي خلقه الله عليها فلن يتسنى لأحد أن يراه لأنهم جنس غير جنسنا، ولو سمح الله لهم برؤية الملك على صورته الحقيقية لأنكروا كونه ملكاً وقالوا بأنه مخلوق غريب له قدرة تفوق قدرة الإنسان، وكذلك لو أرسل إليهم ملكاً لطلبوا منه الإعجاز كما طلبوا ذلك من الأنبياء والرسل.
مَوْقِفٌ مُشَابِهٌ لِمَوَاقِفِ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ(ص)
لقد حصل مثل هذا الأمر مع نبينا الأعظم محمد(ص) الذي حدثنا القرآن عن عناد قومه حيث يقول(وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيلاً أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا رَّسُولاً قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلآئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا){الإسراء 90/96}
نفس الجواب الذي أجاب به نوح قومه فقد أجاب به محمد(ص) قومه أيضاً، لأن ما يطلبونه لن يحل المشكلة وإنما سوف يزيدها تعقيداً.
هم يستغربون بعث البشر إليهم، ولو بعث إليهم الملائكة فسوف يستغربون ذلك ويطلبون بعث البشر، والسبب في ذلك كله هو أنهم لا يريدون الإيمان.
الأمر الثالث: وهو معنى قوله تعالى(وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ){هود 27}
لقد تكرر في القرآن الكريم ذكر هذا النوع من الكلام في عهود مختلفة، ولاحظنا بأن أكثر الأقوام اتهموا الأنبياء بالكذب من خلال اتباع الفقراء لهم دون الأغنياء، لقد كانت هذه الظاهرة منتشرة في العهود السابقة، ولكن ذلك لا يوحي بوهن أهل الإيمان، وإنما يؤكد لنا كلامنا حول موضوع العناد، وهذا لا ينفي وجود أغنياء قد آمنوا، لأن اللسان يحكي من باب الأغلبية وليس الشمول والعموم.
ما هو السبب في كون السباقين إلى الإيمان هم الفقراء والضعفاء دون الأغنياء والأقوياء؟
السبب واضح وهو أن أكثر الأقوياء والأغنياء قامت قوتهم وثرواتهم على الباطل، وعلى رأس الباطل ما يسمى بالوثنية، إن نفس الدليل الذي قدمه النبي للضعفاء هو نفسه الذي قدمه للأقوياء، فلماذا اقتنع الفقراء والضعفاء دون غيرهم؟ نقول: لأن الفقير ليس له مصلحة في العناد والإصرار على الوثنية، فعندما سمع الحق من الأنبياء آمن مباشرة خصوصاً أنّ ما جاء به الأنبياء فهو من شأنه أن يُقنع الجميع، فمن اقتنع فقد مارس الدور الطبيعي، ومن جحد وأنكر فقد خرج عن الطبيعة السليمة ولجأ إلى العناد.
ثم أشار القوم إلى أن الذين اتبعوا نوحاً لا رأي لهم، وهذا في نظرهم لا يؤثر عليهم سلباً بل هو دليل ضد نوح ومن تبعه ممن لا رأي له.
ويكشف لنا اتباع الضعفاء للأنبياء أنهم وجدوا الخلاص على أيدي الرسل، وأن الذين أصروا على الكفر هم المستفيدون من بقاء الوثنية، وإنّ نفس تمسكهم بما فيه مصالحهم الخاصة لدليل على عنادهم.
الأمر الرابع: يكمن خلف قوله تعالى(وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ) وهنا أظهروا جانباً من عنادهم، وهو الحسد، إذ كيف يطيعون نوحاً الفقير الذي كان يعمل نجاراً، فهم في نظرهم ومحدودية تفكيرهم أولى بذلك من نوح لأنهم الأقوى والأغنى، وهم أصحاب النفوذ والقرار، فلا شك بأن لهذه النفسية أيضاً دوراً في عملية الإنكار والعناد، وليس ذلك بغريب، فلقد عصى الشيطان ربه بعد عبادة آلاف السنين بداعي التكبر والعجب حيث اعتبر نفسه أفضل من آدم لأنه مخلوق من النار.
تَصْرِيْحُ القَوْمِ بِعَدَمِ الإِيْمَانِ
هؤلاء المعاندون يصرِّحون بأنهم لن يسمعوا كلام نوح حيث لا فضل لنوح عليهم، فهم أركان المجتمع وعماده كما يظنون، والحال هذه تشبه حالنا في هذه الأيام، فإن كثيراً من أصحاب النفوذ والمال يستكبرون عن اتباع الحق لأن ممثلي الحق فقراء أو ضعفاء، مع أنهم هم الأقوياء بالفعل، ولا يصبح القوي قوياً إلا عبر الضعفاء.
وقد وصل الأمر لدى بعض أصحاب النفوذ إلى التدخُّل بالأمور العقائدية والشرعية فقد حاولوا السيطرة على الناس حتى في معتقداتهم التي هي أغلى شيء عندهم، وذلك كما كان حال المسلمين في العصور الماضية، فقد كان الحكام هم المفتون، ولكنهم لا يفتون إلا بما ينسجم مع أهوائهم، بل كانوا يقتلون العالِم الذي يصر على الحق ويخالف أهواءهم.
إِتهَاْمُ نُوْحٍ وَالمُؤْمِنِيْنَ بِالكَذِبِ
الأمر الخامس: وهو المعنى من قوله عز وجل(بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ)
فبعد أن وجَّهوا اتهاماتهم إلى نوح ومن آمن معه- ولعلهم عجزوا عن إثبات الضلال لهم- لجؤوا إلى اتهامهم بالكذب، وهذا أسهل طريقة لإنكار الحق.
(بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ) ما هو الكذب فيما ادعاه نوح، وكيف حكمتم على المؤمنين بالكذب حيث لا يصح الحكم عليهم بذلك.
إن الكذب آفة اللسان، وهو أقبح صفة في الإنسان، وإن أخطر المخاطر على المرء أن يظن نفسه من أهل الحق والصدق وهو في الواقع من أهل الباطل والكذب، فعندما يتهم الكاذب الصادقين بالكذب فهذا وباء قاتل قد لا نجد له دواءاً.
وقد كان هذا النوع من الإتهامات السلاح الأولي لأقوام الأنبياء، وقد كان كل نبي يكلفه الله بمهامه كان يوطِّن نفسه على تحمل اتهاماتهم قومه وتكذيبهم له.
هذا ما صرّح به القرآن لدى حديثه عن موسى(ع) عندما أمره ربه بأن يذهب إلى فرعون وقومه ويدعوهم إلى الإيمان، فخاف موسى من تكذيب القوم له، وقد قال الله تعالى في وصف هذه الحالة(وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ)
المَنْطِقُ السلِيْمُ سِلاحٌ لا يُقْهَرُ
لقد سدد الله عز وجل رسله وأنبياءه بالحكمة والمنطق السليم والكلمة الطيبة، وهي نعمة جليلة لا تُقدَّر بثمن، ولا تقاس بشيء، لأنها تمثِّل الخير كله.
ومن شيم المعصوم وأخلاقه أن يصدر عنه الجميل لأن الجميل لا يرشح منه سوى الجميل، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكلٌ ينفق مما عنده، فما عند الأنبياء هو العلم والفهم والحكمة والقلب السليم والعقل النيّر والفكر الواسع والنفس الزكية وجميع صفات الكمال البشري، وهذه الصفات لدى أهل الوعي أكبر من المعجزة وأبلغ منها في عملية الإقناع.
ولأجل ذلك نجد بأن الأنبياء (سلام الله عليهم) قد استعملوا في مهمة الدعوة والتبليغ نوعين من أسلحة المواجهة والإثبات، فإذا كان القوم من أهل الوعي فسوف يستعملون معهم سلاح المنطق، أما إذا كان القوم من المعاندين استعملوا معهم -إلى جانب المنطق- قوة الإعجاز وذلك من باب إتمام الحجة.
أما الذين كانوا يتمتعون بشيء من الفهم والوعي فقد أعلنوا الإيمان قبل صدور المعجزة حيث أدركوا بأن هذا الكلام أو هذا المنطق لا يصدر عن شخص عادي بل هو مسدد بقوة غيبية، وأما الذين حرموا أنفسهم من نعمة الفهم فلم يأخذوا المنطق السليم بعين الإعتبار ولكنهم فهموا منطق الإعجاز، ولكي نفهم هذه الحالة بشكل دقيق ينبغي علينا أن نُقسِّم القوم بشكل عام(أي من دون تحديد لأن ما سوف نذكره إنما هو القاسم المشترك بين جميع الأقوام) إلى عدة أقسام:
القسم الأول: وهم أصحاب القابلية السليمة الذين كانوا معتقدين ببطلان الوثنية، ولكنهم لم يكونوا يعرفون جهة الحق، فلقد كانوا بأمس الحاجة إلى بصيص أمل حتى يتبعوا الحق الذي كانوا يعتبرونه مصدر خلاصهم مما هم فيه، وهؤلاء هم الذين وصفعم المعاندون بالضعفاء أو الأراذل، فهؤلاء بمجرد أن سمعوا كلام النبي اطمأنت نفوسهم وأعلنوا الإيمان بالله والتمرد على الوثنية ووطّنوا أنفسهم على مواجهة شرور القوم، وكانوا كانوا يشكّلون عدداً ضئيلاً جداً.
القسم الثاني: وهم المشابهون للقسم الأول، ولكن قابلية القناعة عندهم كانت أقل من قابلية القسم الأول، فهم يريدون أن يؤمنوا، ولكنهم يطلبون الإثبات القاطع، ولذا نجد بأن هؤلاء بمجرد أن رأوا المعجزة أيقنوا بالحق وأعلنوا الإيمان كالسحرة الذين خروا ساجدين بمجرد أن رأوا الآية في عهد كليم الله موسى ابن عمران(ع).
القسم الثالث: وهم الذين آمنوا، ولكن بعد أن رأوا أكثر من معجزة وسمعوا الكثير من الأدلة العقلية، وهؤلاء يشكلون عدداً كبيراً كأولئك الذين رأوا رسول الله محمداً(ص) ورأوا معجزاته الكثيرة، ولكنهم لم يؤمنوا إلا بعد سنوات طويلة، أي عندما انسدت في وجوههم جميع طرق الباطل.
القسم الرابع: وهم الذين آمنوا ولكن ليس من أجل الله بل من أجل مصالحهم الخاصة حيث وجدوا المصلحة في إعلان الإيمان كما صنع أبو سفيان.
القسم الخامس: وهم الذين آمنوا خوفاً من قوة المؤمنين أو من قوة الرسول، ويدلنا على ذلك ارتدادهم عن الحق بعد وفاته.
القسم السادس: وهم المعاندون، وهم أخطر أنواع البشر على الإطلاق لأنهم عرفوا الحق كما عرفوا أنفسهم، ولكنهم أنكروه بغضاً للحق، أو أنكروه لأنهم لمسوا المصلحة في بقائهم على الكفر كما كان حال آزر الذي وصل إلى قناعة تامة بما جاء به إبراهيم ولكنه لو آمن لتوقفت تجارته بالأصنام، وكحال جنود فرعون الذين رأوا بدل المعجزة معجزات، ومع ذلك لم يؤمنوا خوفاً على مصالحهم الخاصة.
القسم السابع: وهو نادر جداً، وهم المحايدون الذين لم يكن همهم الإيمان أو الكفر، إذ كانت غاية همهم الحفاظ على حياتهم ومعيشتهم، فلم يُظهروا الإيمان ولم يُظهروا الوثنية، وهؤلاء حكمهم الكفر لأنه كان من واجبهم أن يؤمنوا بالله عز وجل.
وقد أردت من بيان هذه الأقسام أن أكشف عن مدى حجم المهمة التي حملها أنبياء الله ووطّنوا أنفسهم على تحمل المخاطر والمصاعب في سبيل إحياء الحق وإعلاء كلمته.
وهذه الأقسام كان الأنبياء يواجهونها جميعاً في وقت واحد، وكانوا يعاملون كل قسم منهم بالطريقة المناسبة حيث كانوا في البداية يشخِّصون الحالة ثم يصفون لها الدواء المناسب.
جَوَابُ نُوْحٍ(ع) لِقَوْمِهِ
بعد أن بلّغ نوح(ع) رسالة ربه ووصل صداها إلى أرجاء الأرض فشملت جميع بقاعها ومجتمعاتها، ولم يكن بعدُ قد استعمل معهم الإعجاز بل أراهم الحق عن طريق الأدلة العقلية والمنطقية، فبعد أن دعاهم إلى الإيمان مقدماً لهم الأدلة القاطعة أجابوه بالمعلوم الذي ذكرناه في السابق، فلم يبق نوح ساكتاً بل رد عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة ليكون أسلوبه في الرد أيضاً دليلاً آخر على صدق دعواه، وقد ذكر القرآن الكريم جواب نوح لقومه حيث يقول(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ){هود 28/31}
وهنا ينبغي الوقوف على كل فقرة من فقرات هذه الآيات لنتعرف على المراد وندرك أهم المعاني المقصودة منها.
تَسْدِيْدُ نُوْحٍ بِالأَدِلة
(أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ)
الله تعالى أرسل نوحاً إلى قومه وسدَّده بالبينات والأدلة والبراهين التي لا ينكرها إلا معاند، ولسان الآيات الكريمة يكشف لنا عن كونه قدّم لهم أفضل الأدلة، ورغم ذلك فقد أنكروها، وكأنه يعتب عليهم بقوله: لقد رأيتم البينات التي بعثني الله بها فلماذا هذا العناد الذي لا يخدم مصلحتكم.
الهِبَةُ الإِلهِية
(وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فعُمّيت عليكم)
يريد نوح(ع) أن ينبه القوم إلى أن الله تعالى فرض عليهم الإيمان ليرحمهم وأنّ الإيمان رحمة للإنسان في الدنيا والآخرة.
ولا شك بأن الرحمة التي أصابت نوحاً كانت كبيرة جداً، فهي رحمة الإيمان بالدرجة الأولى ثم النبوة ثم العلم والحكمة ثم باقي الرحمات الإلهية التي من شأنها أن تصيب الجميع ما عدا الخصوصيات كالنبوة وما يتفرع عنها وما يتصل بها كالوحي ولإعجاز.
إن هذا الذي رأوه في نوح ولمسوه به من تلك القدرات التي أظهرها لهم ولم يكن من قبل قد أظهر شيئاً من ذلك، يريد أن يقول لهم: إن ذلك رحمة من ربي، ولن ينال تلك الرحمة إلا من آمن واتقى، فلماذا أصابكم العمى وأنتم ترون وتسمعون وتفكرون لماذا لا تفكرون فيما رأيتم؟
نَفْيُ الإِكْرَاهِ فِيْ الديْن
(أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُون)
هذه الرحمة التي آتاها الله لنبيه نوح لا يمكن أن يلزمها قومه أو يجبرهم عليها لأنهم كارهون لها وللحق الذي جاء به.
الغَاْيَةُ مِنْ دَعْوَتِهِمْ إِلَى الحَق
(وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ)
لقد ظن قوم نوح بنبيِّهم كما ظن باقي الأقوام بأنبيائهم، لقد ظنوا بأن نوحاً يدعوهم إلى ذلك طمعاً بالمال حيث كان فقيراً، ولكن الحقيقة لم تكن طلب مال لأن رحمة الله خير من كل شيء، ولأجل ذلك وقبل أن ينشروا فكرة أن نوحاً يطمع بالمال استدرك الأمر وأزاح هذه الشبهة عن العقول كيلا يستعملها القوم سلاحاً ضده، ولعل هذا الأسلوب كان متَّبعاً عندهم من قِبَل بعض الطامعين بالمال، ولذلك قال لهم: أنا لا أريد منكم مالاً ولا أريد شيئاً على الإطلاق، ما أريده منكم هو لكم، أريدكم أن تؤمنوا بالله الواحد الأحد، أما أَجري فهو على رب العالمين، ولا شك بأن هذه الكلمات قد زرعت شيئاً من التأمل في نفوس البعض مما جعلهم يراجعون حساباتهم ويفكروا بالأمر قليلاً كما كان حال قوم إبراهيم عندما أثبت لهم وَهْنَ الأصنام التي لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر فقال عنهم القرآن(فرَجعوا إلى أنفسهم) أي فكروا في الأمر الذي سمعوه.
ونزاهة المرء تظهر من عدم طمعه بما في أيدي الناس فإن المرء إذا لم يطلب شيئاً من حطام الدنيا، معنى ذلك أنه يطلب الأثمن، وفي هذه الدنيا لا يوجد أثمن من المال والجاه والسلطة كما هو الحال في نظر أهلها، معنى ذلك أن هذا الرجل صادق فلا بد من مراجعة الحسابات، وقد استطاع نوح أن ينفذ إلى قلوب البعض من خلال هذه البيانات.
المَوْقِفُ الحَازِمُ
قد حكى القرآن عن سلوك نوح مع قومه وعن كلامه العذب الذي كشف جانباً كبيراً من الحقيقة فقال تعالى(وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ)
لقد طلب الوثنيون من نوح أن يرد الذين آمنوا ويرجعهم إلى ما كانوا عليه قبل الإيمان، وهذا الطلب لا يمكن أن يستجيب له نوح وقد صرّح لهم بأنه لا يطرد مؤمناً من إيمانه لأن كل إنسان منا مسؤول عن سلوكه في هذه الحياة، فقد يُكرَه الإنسان على كثير من الأعمال والممارسات، ولكن لا يمكن أن تكرهه وتجبره على اعتناق عقيدة معينة، ولأجل ذلك أطلقها القرآن صريحة في مواضع عديدة، ففي سورة البقرة قال سبحانه (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ){البقرة/256} وفي سورة الكهف(وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا){الكهف/29}
فبعد أن رفض نوح الإستجابة لطلب القوم حول طرد المؤمنين بيّن لهم الحكمة من وراء ذلك كما قال القرآن(إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ) يعني أن أمرهم بيد الله تعالى فهو يفعل بعباده ما يريد، ولا يريد الله لعباده سوى الخير والنفع.
وبعد أن تأزَّم الوضع بين الفريقين لم يكن لنوح أن يبقى ساكتاً أمام تلك الإتهامات الباطلة فبيّن لهم أنهم هم الجهلاء وليس الذين آمنوا، فالذين آمنوا وصلوا إلى ما لم يصل إليه الكفار والمشركون، فقال لهم نوح(وَلَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ)
أنتم تجهلون الحقيقة التي باتت واضحة، وتعملون على إخفائها عبر تضليل الناس وتهديدهم بأولادهم وأنفسهم ولقمة عيشهم وأمنهم لأنكم الأقوى مالاً ورجالاً.
وهنا نصل إلى نتيجة واضحة وهي أن الكافر جاهل وإن تَخَرَّج من أحسن وأرقى جامعات العالَم، فالذي يجهل الحق يعني أنه جهل شيئاً خاصاً به وموجوداً في نفسه، والعقيدة الحقة موجودة في كل إنسان لأن الله تعالى خلقنا على فطرة الإيمان، ولكننا نحن الذين أضللنا أنفسنا وأَمَتْنا تلك القوة في داخلنا.
ثم بيّن لهم نوح خطورة الشيء الذي يطلبونه وهو أنه ليس أمراً خاصاً، فإن عليه عقاباً من الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك قال لهم(وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ)
على فرض أن نوحاً استجاب لهم ذلك وطرد المؤمنين من الإيمان فمن يُخلِّص نوحاً من الله الذي واعد كل كافر وكل مُعِين على الإثم والعدوان عذاباً أليماً.
ثم حسم لهم موقفاً ربما كانوا قد أشاروا إليه، وهو أنهم يريدون من نوح أن يفتح لهم خزائن السماء ليس من أجل أن يُثبت لهم الحق، فلقد أثبت لهم ذلك، ولكن لعلهم استغلوا هذا الحال من أجل أن تنزل عليهم البركات وتزداد بذلك ثرواتهم ولهذا قال لهم(وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ)
وقبل أن يسألوه شيئاً من الغيب قال لهم(وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ) فإن ذلك بيد الله عز وجل، فإذا أراد الله أن يُطْلعه على شيء من الغيب فلا راد له، ولكن قوم نوح أرادوا أن يُوْقِعوه في حرج أمام الذين آمنوا ويضمنوا بذلك عدم دخول أحد من الوثنيين في الإيمان، فهم بذلك يحاولون أن يُحَصِّنوا موقفهم ليس أكثر.
ثم نفى عن نفسه أن يكون ملَكاً، بل أثبت لهم إنسانيته، ولكن الله تعالى اختاره لحمل هذه الرسالة، وما هو إلا بشر كلَّفه الله تعالى بتأدية هذه الوظيفة الكبرى.
لقد نفى الملائكية عن نفسه، وكذلك عِلْمَ ما سوف يكون، وأن الله تعالى إذا أراد أمراً فإنه يفعله(وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ) أنا لا أريد أن أكون من الظالمين الذين يخالفون ربهم ولا يلتزمون بما أمر ونهى.
فإذا أراد الله سبحانه أن ينزل الخير عليهم فسوف يكون ذلك، وإلا فالأمر يعود إليه وحده، فهو الذي بيده مفاتيح خزائن السموات والأرض.
نَتِيْجَةُ حِوَاْرِ نُوْحٍ مَعْ قَوْمِهِ
بعد أن بيّن لهم نبي الله نوح(ع) حقيقة الأمر وذكّرهم بالله ودعاهم إلى الإيمان به ونبذِ الأوثان التي لا تستحق منهم هذا العناء فقد أيقن الجميع بصدق نوح، ولكنهم أصروا على الكفر واستكبروا على الحق وآثروا الوثنية العمياء التي كانت مصدر رِفعتهم في هذه الدنيا التي أغرتهم وزينت لهم الكفر والفسوق والعصيان، وقد وصلوا إلى تلك النتيجة التي كانت مأمولة منهم وهي(قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ) ولعله(ع) كان قد أخبرهم بالمصير الذي سوف يكون حتمياً وهو الغرق انتقاماً من الله تعالى وتطهيراً للأرض من ظلمهم وفسادهم، لقد أرادوا أن يحل بهم الطوفان يوم الحوار، ولكن نوحاً(ع) أخبرهم بأن ذلك بيد الله الذي ترجع إليه الأمور.
الحَسْرَةُ عَلَيْهِم
وها هو القرآن الكريم يصف لنا هذا الحوار الذي آلم نوحاً لقرون طويلة من الزمن الحافل بالعمل المضني والسعي لإثبات الحق، فقال تعالى محدِّثاً عن نبيِّه نوح.
(قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا)
فلم يهمل نوح تلك المهمة لحظة واحدة، بل كان من أعظم الصابرين حيث تحمَّل أذى قومه ما يقرب من عشرة قرون دون أن يمل من وعظهم وإرشادهم وتعليمهم وتحذيرهم مما هم عليه، فلم يتباطأ في مهمته لا في الليل ولا في النهار، وهذا يدلنا على عظمة الأنبياء الذين كانوا نماذج خاصة في هذه الحياة.
(إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا)
رغم العمل المستمر والجهد الدائم المدعوم بالأدلة والبراهين والمعجزات لم تخشع قلوبهم ولم تستنر عقولهم المتحجرة التي لو كانت جماداً للانت في تلك المدة، فهم الذين ملوا من نصح نوح وهموا بقتله ليرتاحوا من كلامه، فكان كلما دعاهم إلى الله وَلَّوا مدبرين وازدادوا بُعداً عن الحقيقة وجفاءاً للرشد والصواب والصلاح، وهو معنى قوله تعالى(فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا)
(وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا)
يخبرنا القرآن بأن نوحاً(ع) يبيّن لنا الشيء الذي دعانا إليه عبر بيان النتيجة وليس الحقيقة، فهو(ع) لم يَقُل دعوتهم إلى الإيمان، وإنما قال: دعوتهم لتغفر لهم: وهذه المغفرة لا ينالها المرء إلا بعد الإيمان والعمل، ولعل التعبير بالنتيجة ورد من باب الترغيب بالإيمان.
ورغم أنه بيّن لهم هذا الخير الكبير والفوز العظيم إن هم آمنوا بالله وتخلوا عن عبادة الأوثان فلقد راحوا يَسُدُّون أسماعهم بأصابعهم كيلا يسمعوا الحق خوفاً من أن يصلوا إلى القناعة ويخسروا بذلك دنياهم، وإن دلنا هذا السلوك على شيء فإنما يدل على كون الحق واضحاً لا يخفى على أحد.
ثم راح القوم يخبِّؤون وجوههم بثيابهم تحصيناً لهم من سماع الحق وذل لنفس الهدف أو الغاية التي ذكرناها، وكانت النتيجة أنهم أصروا على الكفر واستكبروا على عبادة ربهم سبحانه وتعالى.
ثم يوضح القرآن لنا مدى الجهد الذي قام به نوح في دعوة القوم فيقول(ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا)
كان نوح(ع) يستغل كل أوقاته في الليل النهار لدعوة القوم عَلَّه ينجح في إقناع البعض منهم، ولكن جميع محاولاته الخيّرة قد باءت بالفشل لأن العناد لا دواء له على الإطلاق، لقد دعاهم إلى الله في السر والعلن، وجرَّب معهم كل الأساليب، فألقى الحجة على الجميع، فلم يبق لأحد منهم ذرة من الحجة أو مَأْخَذٌ على نوح.
ماذا قال لهم نوح في السر والعلن؟ قال لهم كما حدثنا القرآن الكريم(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا)
إذا آمن الإنسان بربه فإن ثمار الإيمان سوف تعود على صاحبه في الدنيا والآخرة لأن ثماره وآثاره لا تقتصر على يوم الحساب، يوم الحساب هو الأساس في ظهور النتائج، ولكن ذلك لا يعني نفي آثار الإيمان عن المؤمن في هذه الحياة، وقد ورد عشرات الأحاديث عن النبي وآله(ص) تكشف عن بعض آثار الإيمان في الدنيا قبل الآخرة، من قبيل الصدقات التي تَظهر آثارها على الإنسان في هذه الحياة، ومن قبيل صلة الأرحام وغير ذلك من الأفعال التي تحمل الفوائد على مستوى الدارين.
الوَحْيُ يُخْبِرُ نُوْحاً بِالنتِيْجَةِ الحَتْمِية
بعد أن تأفَّف القوم من نصح نوح ودعوته لهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لقي منهم رداً سلبياً كان أساسه العناد الذي هو مرضٌ فُقِد دواؤه وانقرض مُداووه، فقد حاولوا إسكاته عن طريق إغلاق جميع النوافذ وقطع كل الطرق أمام قلوبهم السوداء وعقولهم المتحجرة، بمعنى أنهم قالوا له: سكوتك أفضل من كلامك لأن كلامك لن يقدم ولن يؤخّر فلن نؤمن حتى ولو ثبت لنا الحق: ولعل هذا هو المراد من قوله تعالى في خلال حديثه عن نوح وقومه(قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)
إنَّ قولهم (فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا) لأكبر دليل على علو الهمة التي كان يتمتع بها هذا النبي العظيم الذي افتتح الله به إرسال الرسل، فقد حاولوا أن يحرجوه ويكذبوه فقالوا له (فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فلقد علّقوا إيمانهم على إثبات ما دعاهم إليه عن طريق المعجزة، والله تعالى يعلم بأنهم لن يؤمنوا حتى ولو رأوا مئات المعجزات، وهذا ما حصل بالفعل عندما رأوا كيف بدأت السماء تتلبد بالغيوم في وقت لم يَعْتَدْ الناس فيه على الشتاء، ورغم ذلك لم يؤمنوا، هذا مع العلم بأن دعوة نوح لهم استمرت إلى ما قبل إغلاق باب السفينة، ها هو نوح قد أتاكم بما وعدكم فلماذا لم تؤمنوا كما ادعيتم من قبل؟ وإنّ أكبر دليل على ما نقول هو ما دار بين نوح وولده حيث خاطبه نوح من داخل السفينة فرفض الصعود إليها عناداً، وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
نعود إلى صلب الموضوع، فإنه عندما أغلقوا نافذة الحوار بينهم وبين نوح لم يمتنع عن دعوتهم رغم امتناعهم عن سماع الكلام عبر إغلاق الآذان والتستر خلف الثياب.
وعندما طلبوا منه أن يأتيهم بما وعدهم به أجابهم بقوله(قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
هذا الأمر الذي تطلبونه سوف يحصل من دون شك، ولكن الأمر ليس بيدي بل هو بيد الله الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء ومتى شاء، وأنتم غير معجزين، أنتم لا تقدرون على منع الله أو الوقوف في وجه إرادته.
ثم إن جميع مواعظي وإرشاداتي ونصحي لكم لن تنتفعوا بها إذا أراد الله تعالى أن يغويكم لأن الأمور بيده، فهو ربكم وإليه مرجعكم.
فلو فكر هؤلاء في موضوع الرجوع إلى الله والحساب على كل صغيرة وكبيرة لما أصروا على الكفر والعناد ولما قاموا بأية مخالفة في حياتهم لأن العقاب سوف يكون أشد مما يتوقعون.
إنّ الله تعالى لم يخلق الخلق سدى، ولن يترك المرء وشأنه، فهناك قوانين إلهية يجب أن يتبعها العبد في هذه الحياة، وهناك حقوق عليه يجب أن يؤديها، وأهم حق منها هو حق الله على الإنسان، وتأدية هذا الحق تتم عبر الإيمان الصحيح الذي يُترجَم عملياً، وليس مجرد الشعور القلبي الذي لا يُسمن ولا يغني من جوع.
ثم إن هذه الإرشادات التي ذكرها القرآن عن جميع الأنبياء لم تكن مجرد سرد تاريخي لأحداث مضت منذ آلاف السنين، وإنما ذكرها من أجل أن نستفيد منها، فلو لم تكن تلك الأحداث والوقائع ذات أثر ومنفعة لما ذكرها القرآن الكريم.
إن نفس ما قاله الأنبياء لأقوامهم هو يقال لنا الآن، الله تعالى يحدثنا عن نوح بأنه قال لقومه(وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
نفس هذا الكلام موجَّه إلينا لأنه لم يختص بقوم نوح فقط، فلقد وجّه هذا الكلام إلى جميع السابقين لأنه لا يجوز أن نحصر القرآن بأُطُر محدودة، ولا يجوز أن نلغي منه شيئاً يريد الله بقاءه واستمراره.
الوَحْيُ يَأْمُرُ نُوْحاً بِصُنْعِ السفِيْنَة
بعد عناء طويل وتاريخ حافل بالعمل المضني والجهد المميز عبر مدة لم يحدثنا القرآن عن مثلها حيث بلغت تسع مئة وخمسين سنة أوحى الله تعالى إلى نوح(ع) بأنه لن يؤمن بعد ذلك من قومك أحد لأن الله أعلم بما كان وبما سوف يكون، وأظن بأن هذا الوحي لم يرفع التكليف عن نوح بل بقي مستمراً في الدعوة كيلا يكون لأحدهم حجة على الله ونوح في يوم الحساب، ويؤيد هذا الرأي دعوة نوح لقومه أثناء صنع السفينة وبعد الإنتهاء منها وفي بداية نزول المطر العظيم، فلقد أخبره الوحي بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقد كان بين هذا الأمر وحصول الطوفان سنين كما يحدثنا التاريخ، فقد تابع نوح مهمته الرسالية والتبليغية وهو منهمك في صنع السفينة الكبيرة التي لم يشهد لها الناس مثيلاً عبر تاريخهم، وفي خصوص هذا الوحي قال تعالى(وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ)
فلا تبتأس ولا تحزن عليهم، فهم الذين اختاروا هذا المصير الأسود لأنفسهم بسبب كفرهم وإصرارهم على الوثنية، ولم يقصِّر نوح يوماً في نصحهم، فلا ينبغي أن يحزن عليهم لأنه أراد لهم الخير وأرادوا له ولأنفسهم الشر.
بعد هذا الإيحاء الذي أخبره بهذه النهاية التي كان يسعى نوح لأن تكون مُرضية فقد وجّه الله إليه أمراً بأن يصنع سفينة كبيرة في تلك الصحراء، وهنا بدأت حكاية جديدة وعهد جديد فتح لهم المجال للسخرية والإستهزاء، قال تعالى(وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ)
لقد أمر الله نوحاً بصنع السفينة لأنه أراد أن يطهِّر الأرض من رجس الكفار والمعاندين، وبدأ نوح بجمع الخشب اللازم من الغابات القريبة والبعيدة لأن صنع مثل هذه السفينة يحتاج إلى خشب كثير.
وهنا كُلِّف نوح بمهمة صعبة وشاقة للغاية حيث لا يوجد مَن يعينه على صناعتها سوى عدد قليل للغاية، ورغم ذلك بدأ العمل بنفسه لينفِّذ أمر الله وإرادته.
ولكننا نلاحظ ورود فقرة في هذه الآية تكشف لنا مدى رقة قلب نوح، هذا القلب الذي لم يحمل الحقد على الناس رغم الأذى الذي رآه منهم طيلة تلك المدة، فنوح(ع) أحب أن يؤمن الجميع بالله لأن ذلك غاية سروره، ولكن هذه الأمنية كانت بعيدة عن الواقع بسبب الموانع التي زرعها القوم بأيديهم، إن قوله تعالى(وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ) يكشف لنا عما أَسَرَّه نوح، وهو الطلب من الله تعالى أن يفتح له المجال أكثر علَّه ينجح في إقناع البعض قبل فوات الأوان، ولكن النتيجة كانت ظاهرة من الأساس، وهي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن.
نحن نريد أن نُشبِّه أنفسنا بالأنبياء، وأنّى يكون لنا ذلك ونحن بعيدون عنهم روحياً ونفسياً، كيف نتشبه بهم وقلوبنا مليئة بالحقد والكره وتمني الشر للآخرين؟ نحن إذا حاولنا أن نعظ شخصاً أول مرة ولم يتعظ(ولا أقول استهزأ بنا) فإننا لا نعيد الكرة مرة أخرى بل نحقد عليه وربما نسبُّه ونلعنه، وهذا خُلُق بعيد عن خُلق الأنبياء الذين كانوا يمشون بأنوار الإيمان الصحيح، وأُقَيِّد لفظ (الإيمان) هنا (بالصحيح) لأننا نشك بكثير من إيمان المؤمنين الذين جهلوا حقيقته أو تجاهلوها.
(وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ)
لقد بدأ بصنع السفينة وأصبح بذلك موضعاً للسخرية والإستهزاء من قِبَل قومه الضالين الذين استبعدوا فكرة العذاب وأن الله سوف يغطي الأرض بالماء ولن ينجو من الطوفان إلا ركاب هذه السفينة، لقد راحوا يضحكون على نوح ويتهمونه بالجنون، من يصنع سفينة في الصحراء؟ هل تريد أن تبحر في الرمال؟ وهكذا كانوا يُصدرون الكلام السيء، وقد جعلوا من نبي نوح موضعاً للتسلية وإضاعة الوقت، وقد أيقنوا في أنفسهم بكونه مرسَلاً من جهة قديرة ليست الأصنام الحقيرة، ورغم هذا الشعور فقد أصروا على الكفر والعصيان.
لقد كان نوح(ع) يرد سخريتهم واستهزاءهم بالكلام النبوي اللين والأخلاق الفاضلة والأساليب التي لا تخدش جوهر الرسالة والرسل ولا تعيبها بشيء، أكثر ما قاله لهم (إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) ولا يعني ذلك أنه يريد أن يرد عليهم بالمثل بل معناه أن هذه السخرية سوف ترتد سلباً عليكم لأن النبي أَجَلُّ من أن ينزل إلى هذا المستوى الخُلُقي الوضيع، فمعنى قوله(نَسْخَرُ مِنكُمْ)أي سوف ينتقم الله منكم وتصبحون أنتم موضعاً للسخرية عبر التاريخ.
ويدلنا على ذلك قوله تعالى(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ) وهنا كشفت الآية عن كون المراد بالسخرية عليهم هو العذاب وليس استعمال طريقتهم الشنعاء.
فَوَرَاْنُ التَنوْرِ
لقد أجرى الله عز وجل سلسلة من المعجزات على يد نبيه نوح(ع) لتكون هذه الآيات علامة على نبوته وكونه مرسَلاً من عند إله عظيم قادر على كل شيء.
فمن لم يسمع الكلام المنطقي ولم يأخذ به بسبب سيطرة الهوى على جميع قواه النفسية ومشاعره وأحاسيسه فسوف يرى المعجزة التي لا يمكن لأي عقل أن ينكرها والتي لا تستطيع جميع أصنامهم الحجرية والخشبية والبشرية أن تصنع ذرة منها، فمن لم يفهم عن طريق المنطق فيجب عليه أن يفهم عن طريق الإعجاز الذي يُخرِس حجتهم ويُبطل أدلتهم ويحط من شأن ادعاءاتهم.
يمكن للإنسان أن ينكر المنطق السليم ويرفض الدليل العقلي عن طريق اللعب على الألفاظ، ولكنه لا يستطيع أن يسلخ أثر الإعجاز من صدور الناس مهما كان ضليعاً في المكر والمخادعة والتضليل، ولكن العناد يلقي على القلب والعقل ثوباً من الظلام الدامس فيمنع الإنسان من التأمل والتفكير حتى في الأمور الواضحة والثابتة التي لا يمكن إنكارها بسبب وضوحها كالمعجزات الخارقة لقوانين الطبيعة والتي لا يمكن لأي عالِم أو ساحر أو حاكم أن يصنع شيئاً منها أو ما هو قريب منها.
وكان من الضروري في مسألة التبليغ أن يسدد الله أنبياءه ورسله بالمعجزات قبل أن يطلبها الناس لأن الناس من طبيعتهم أن يطلبوا الدليل القاطع، ولقد كان الدليل الساطع على صدق الأنبياء هو المعجزات التي شهدت بها البشرية عبر تاريخها إلى أن أصبح منكرها مُلاماً حتى من قبل بعض أتباعه وأعوانه ومحبيه.
لقد كانت حياة الأنبياء مليئة بالمعجزات التي استعملوها في الأوقات المناسبة، فمنهم من بادر بالمعجزة قبل أن يسأله الناس ذلك كما صنع موسى(ع) في مجلس فرعون، ومنهم من قام بها بعد أن طلبها الناس كنبي الله صالح الذي أخرج من الجبل بقدرة الله ناقة عظيمة، ومنهم من لم يحتج إليها وذلك بحسب الظروف التي كانت محيطة به، ومنهم من كررها بعينها أو أتى بغيرها كما هو حال كثير من الأنبياء الذين أجرى الله على أيديهم عشرات المعجزات.
ففي زمن نبي الله نوح(ع) حصلت عدة معجزات سوف نذكرها في البحوث القادمة، ولكننا الآن نشير إلى واحدة منها لضرورة ذِكرها هنا حيث أن البحث هنا خاص في قوله تعالى(حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ) أي أنه جاء الأمر الإلهي بحلول العذاب في قوم نوح الذين طغوا وتكبروا وأفسدوا في الأرض، فالأمر الإلهي معلوم، ولكن ما هي علاقته بفوران التنور؟ وما هي حقيقة هذا التنور؟
حَقِيْقَةُ التنوْرِ
التنور هو المكان الذي تُشعَل فيه النار لصناعة الخبز، وهو عبارة عن حفرة في الأرض أو في الصخر الثابت أو المتنقل، وكان يصنع بأحجام مختلفة، ويعود ذلك إلى ذوق الصانع.
لقد أخبر الله نبيه نوحاً بأنه سوف يهلك قومه، ولكن متى يصعد نوح والمؤمنون إلى تلك السفينة؟ لقد أعطاه الله تعالى علامة على ذلك، تلك العلامة هي فوران التنور بالماء، ولكن ليس كل تنور، بل هو تنور خاص كان في بيته تستعمله زوجته لصناعة الخبز المطلوب، وكان تعالى قد أخبر نوحاً بهذه العلامة فطلب نوح من زوجته أن تخبره بكل ما تراه من شأن التنور، وقد أخبرها بأنه سوف يخرج منه الماء بقدرة الله فجلست زوجة نوح تراقب التنور حتى رأته يوماً يفيض بالماء فأسرعت إلى زوجها وأخبرته بالأمر فاستعد هو ومن آمن معه للركوب في سفينة النجاة.
وقيل بأن هذا التنور كان مصنوعاً من الحجر الأسود وصانعه هو نبي الله آدم(ع) وكانت تستعمله حواء زوجته وقد توارثه الأبناء والأحفاد من باب التبرك حتى وصل إلى زوجة نوح.
وكان التنور موجوداً في بيت سام بن نوح، وقد أخبر نوح زوجته بما سيكون من أمر هذا التنور قائلاً لها: يا رحمة إن آية الطوفان من هذا التنور فإذا رأيت الماء فأسرعي إلى السفينة.
جَمْعُ أَصْنَافِ الحَيَوَاْنَاتِ
قال سبحانه وتعالى في موضوع الأمر الذي وجّهه إلى نبيّه نوح(ع) بجمع أصناف الحيوانات (حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ){هود /40}
كثير من الناس يتحدثون عن هذه الحادثة ويعلمون بأن نوحاً هو الذي أدخل أصناف الحيوانات معه في السفينة حذراً من انقراضها، ولكنهم لم يلتفتوا إلى أمر هو أساس في هذا الموضوع، وهو يكشف لنا العديد من الأمور التي يجب التعرف عليها من خلال هذا الحدث.
هناك أكثر من نقطة هامة تتعلق بهذا الموضوع ينبغي البحث فيها كي نخلص بالنتائج الواضحة والغايات المطلوبة من وراء عقد هذه البحوث بهذا الشكل التحليلي والعلمي الموسع حول تواريخ الرسل والأنبياء(ع)
مِن كُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
قال تعالى(قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ)
هذا أمرٌ وجّهه الله عز وجل إلى نوح(ع) وهو يقضي بحماية المخلوقات الحيوانية بل الثروة الحيوانية من الإنقراض لأن الإنسان لا يمكن أن يستغني عن تلك المخلوقات، فمنها يلبس، ومنها يأكل، ومنها يشرب، ومنها ما يركب المرء في أسفاره، ومنها ما يستخرج منه الدواء، ومنها ما خلقه الله من أجل الزينة والتفكر والتأمل، ومنها ما له من الظائف ما لا يسمح لنا المجال في تعدادها.
فقوله تعالى(مِن كُلٍّ) يعني من كل صنف ذكراً وأنثى ليستمر التناسل فيما بينها كيلا تنقرض من الوجود ويخسر الإنسان كثيراً من أسس معيشته.
وقبل متابعة القصة نذكر لكم بعض الآيات التي تتحدث عن الحيوانات حتى تتم لنا الفائدة أو جزء من الفائدة في هذا البحث.
حَدِيْثُ القُرْآنِ عَنْ أَصْلِ خِلْقَةِ الحَيَوَاْنِ وَمَنْفَعَتِهِ
لقد تحدث القرآن الكريم عن أصل خلقة الحيوان وبيّن لنا العديد من منافعه للإنسان الذي سُخِّر له استعمال الحيوان وأكله والإستفادة منه في أكثر وجوه الإستفادة، وقد بيّن لنا من خلال ذلك جانباً من قدرته المطلقة وأنه قد مَنَّ علينا بوجود تلك المخلوقات التي كانت جزءاً من حياتنا على كوكب الأرض.
قال تعالى في سورة النور(وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ){النور/45}
وفي سورة النحل(وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ){النحل 5/8}
هذه بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن خلق الحيوانات، وقد آمن الناس بكون نوح هو الذي حافظ على هذه الثروة من الإنقراض، ولكن ينبغي أن نتعمق في البحث قليلاً لنطال بكلامنا موضوعاً حساساً حول مسألة خلق الحيوانات، فهو(أي البحث حولها) ينفعنا كثيراً في فهم المراد من إدخال الحيوانات في سفينة النجاة، طبعاً هناك العديد من النقاط التي سوف نبينها في البحوث القادمة ولكنني أريد أن أركز على هذه النقطة بالذات لأن كثيراً من الناس يرغبون بمعرفة جوهرها.
مضمون هذه النقطة سؤال قلّ طرحه من قِبل الناس، ولا شك بأن كثيراً منهم غافلون عنه إما لعدم وجود ثمرة عملية فيه أو لعدم الإدراك الناتج عن عدم الفائدة العملية، وعلى كل حال يستحسن لنا طرحه من باب زيادة الفائدة، وهو: من أي شيء خلق الله الحيوانات؟ وقد عرفنا في البحوث السابقة أن الإنسان خُلق من تراب، وهو من لحم ودم، وبيَّنا كيف جعل الله عملية الخلق عبر الإتصال الجنسي، فمن أي شيء خُلق الحيوان الذي يشابه الإنسان في كثير من الخصوصيات ما خلا العقل وبالأخص فيما يتعلق بمسألة التناسل فإن خلق الحيوان يتم بنفس الطريقة التي يتم بها خلق الإنسان، فهل هذا يكشف عن كون الحيوان خُلق بنفس الطريقة التي خلق الله بها الإنسان؟
وقبل أن نخوض في صلب هذا البحث المتوج بالتعقيد والموصوف بالصعوبة في مقابل عدم الفائدة أشير إلى أنه لا يوجد أمر خال من الفائدة، وإنما هناك نسبة تفاوت بين أمر وآخر، وقبل البدء في البحث أتوقف عند عبارة قرآنية وردت في ذيل آية من آيات سورة النحل بعد حديثه عن خلق الأنعام والبغال والحمير حيث قال تعالى في ذيل الآية(وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)
نحن نمر دائماً على هذه الفقرة عند قراءتنا للقرآن من باب كسب الأجر عِلماً بأن التأمل في الآيات يزيد في الأجر والثواب، فنمر على هذه الآية الكريمة مرور الكرام مع أنها تحمل معانٍ سامية ومفيدة ونافعة في الكشف عن بعض المعارف الخاصة في هذا المجال المبحوث عنه هنا.
فماذا نفهم من هذه الآية وما هو المراد منها؟
نحن نفهم من هذه الآية أن الله تعالى قادر على أن يخلق أصنافاً وأنواعاً لا عداد لها من الحيوانات وغيرها من المخلوقات التي بلغت عدد أنواعها الملايين في البر والبحر، وما زال الخبراء حتى يومنا هذا يكتشفون الأسرار تلو الأسرار حول هذه المخلوقات الدالة على القدرة والدقة في الصنع.
لقد اكتشف العلماء حتى يومنا هذا ما يزيد على عشرين ألف نوع من الحيوانات البحرية، وهذا العدد قابل للزيادة مع الأيام، كما اكتشفوا من الحيوانات البرية آلاف الأنواع، ومن النباتات ملاين الأنواع والأصناف، ولكنهم لم يصلوا بعد إلى معرفة كل شيء فإن خَلْق الله لا يعلم جميع تفاصيله إلا الله عز وجل.
هذا ما نفهمه من ظاهر الفقرة القرآنية المذكورة، ولكننا لو دققنا قليلاً في معانيها لوجدنا لها أكثر مما عرفنا من المعاني.
ولكي نوضح الأمر أكثر لا بد من تصوير الفقرة بنحوين:
النحو الأول: وهو أن الله تعالى خلق من الحيوانات ما لا يمكن لنا معرفته بسبب كثرته وانتشاره في بقاع من الأرض فلا نستطيع نحن البشر أن نصل إليها.
النحو الثاني: وهو أن الله تعالى الذي خلق تلك الأصناف بتلك الأعداد الهائلة قادر على أن يخلق غيرها متى شاء، ويمكن حمل ذلك على أنه يخلق إما ذكراً وإما أنثى وهذا لا يعرفه الإنسان إلا بعد التكوين.
وكلا النحوين مقبول وممكن، ولا نريد أن نطيل البحث حول هذه الفقرة حذراً من أن يعترضنا ما يُبهم الصورة بعد وضوحها.
لقد حدثنا القرآن الكريم عن أصل خلقة الإنسان فذكر لنا أنه خلق من تراب، ولكنه لم يحدثنا عن أصل خلقة الحيوان، ولعل السبب في ذلك هو أن يعرف الإنسان نفسه ويتفرغ لذلك، أما مسألة أصل خلقة الحيوان فقد لا يرى القرآن أن في معرفتها ثمرة معتداً بها.
لقد ادعى البعض تكوين الحيوان من تراب آدم، وهذا أوهن رأي سمعناه حول هذا الأمر لأن التراب الذي كُوِّن منه آدم كان تراباً خاصاً بخلقه هو وزوجته حواء التي خلقت من فاضل تربته، فلم يبق بعد خلق حواء من التربة شيء.
هناك وجوه مشابهَة كثيرة بين الإنسان والحيوان من حيث التكوين الجسدي وطريقة التغذية والأنظمة الجسدية كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والأمعاء والفم والمخرج وكذلك المشابهة في موضوع التناسل فإن الطريقة بينهما واحدة وهو التناسل عبر الإتصال الخاص بين الذكور والإناث.
هذا التشابه بين النوعين دفع بالبعض إلى فكرة أن تكون أصل خلقة الحيوان كاصل خلقة الإنسان، وهذا لا دليل عليه لأن الأمر مسكوت عنه، فلقد ركّز القرآن على بيان أصل خلقة الإنسان مرات عديدة ولم يُشِر مرة واحدة إلى أصل خلقة الحيوان، أكثر ما ذكره القرآن عن خلقة الحيوان هو ما ورد في سورة النور حيث يقول (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء)
وهذه ليست من خصوصيات الحيوان فقط لاشتراك الإنسان معه فيها فإن الإنسان أيضاً خُلق من الماء الذي هو ماء الذكر وهو معنى تعالى في سورة السجدة(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ)
فلا مانع من أن يكون أصل الحيوان من الماء السائل المعروف كما كان أصل الإنسان من تراب وأصل الجن من نار، فلا مانع من ذلك، ولكن لا دليل عليه فهو مجرد احتمال.
ثم إنه لا مانع أيضاً من أن يكون الحيوان قد وُجد من العدم مباشرة، أي من دون أن يكوّنه قبل إيجاده من تراب أو ماء أو نار أو أي شيء آخر، وبما أن الأمر مسكوت عنه ترجَّح أن يكون الحيوان قد وُجد مباشرة كما أوجد الله كبش إسماعيل فأوجده بلمح البصر من دون أن يصوره من أي شيء آخر، أو كناقة صالح التي أوجدها الله من العدم مباشرة أيضاً، أو كثعبان موسى.
هذه النماذج تدعم فكرة أن يكون أصل الحيوان العدم دون التراب كما كان أصل الوجود كله.
وإذا اعترضنا أي إشكال حول أي بحث لم يرد فيه دليل فإننا نعمل على قاعدة :أسكتوا عما سكت الله عنه: وأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كل شيء، وقد قال تعالى(وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)
نُوْحٌ(ع) يَجْمَعُ أَصْنَافِ الحَيَوَانِ
فور توجيه الأمر الإلهي إلى نوح(ع) بجمع أصناف الحيوانات من كل زوجين اثنين باشر(ع) بجمعها كما أمره الله تبارك وتعالى، وقد فرّغ وقتاً طويلاً جداً في عملية البحث عنها وجلبها إلى مكان السفينة وإدخالها إليها، ولا شك بأن في الأمر رعاية من الله عز وجل حيث لم يكن لأي إنسان أن يقوم بتلك المهمة الصعبة إلا بتسديد إلهي وبتدخّل القدرة الإلهية في ذلك فإن مسألة جمعها ليس بالأمر السهل بل هو من الوظائف الشاقة والخطيرة.
وتظهر لنا القدرة الإعجازية في هذا الحدث من خلال النظر إلى مروِّضي الحيوانات كيف أنهم يقضون سنوات طويلة من أعمارهم في ترويض حيوان واحد، وقد ينجحون في ذلك وقد تفشل جميع محاولاتهم، ولكن نوحاً(ع) استطاع أن يروِّض جميع أصناف الحيوانات ويدخلهم إلى سفينته.
وهنا جملة من العناوين ينبغي أن نقف عليها لندرك حقيقة الأمر.
كَيْفَ اسْتَطَاعَ نُوْحٌ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ
لقد أشرنا قبل قليل إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم بقدرة الإنسان وحده مهما كان قوياً وحذقاً ومتعدداً، وإنما كان للقدرة الإلهية دخل في هذا الأمر من باب المحافظة على تلك الثروة، وقد جمع من كل صنف ذكراً وأنثى ليبدأ التناسل من جديد بعد انتهاء الطوفان الرهيب الذي قضى على جميع سكان الأرض إلا من دخل السفينة.
الصبْرُ أَسَاْسُ النجَاحِ
لقد تمتع نوح(ع) بقوة الصبر في حياته، ولا شك بأن مسألة جمع الحيوانات قد استغرق من الوقت ما لا يعلمه إلا الله تعالى لأن نوحاً قد جمعها من أماكن مختلفة من هذه الأرض وليس من مكان واحد، فلو لم يكن عظيم الصبر لما نجح في إتمام تلك المهمة الصعبة، ويمكن أن يكون هناك أنواع من الحيوانات التي لم تكن مخلوقة في عهده يمكن أن يكون الله تعالى قد خلقها مجدداً ولا مانع من طرح هذا الإحتمال.
إِتْمَاْمُ المُهِمةِ
إن المهمة التي كُلِّف بها نوح(ع) لم تقتصر فقط على جمع الحيوانات وإدخالها إلى السفينة، وإنما راح يجمع لها الطعام كي تبقى على قيد الحياة، وقد جمع من الطعام الكثير الكثير، وقد كان للقدرة الإلهية دور في الحفاظ على جودة الطعام لمدة فاقت الأربعين يوماً حيث لا يوجد وسائل تبريد ولا مواد حافظة، إن المادة التي حفظت ذلك الطعام هي الإرادة الإلهية، ولم يقف الأمر على الطعام فقط بل على الماء أيضاً فإن من بين تلك الحيوانات ما يحتاج يومياً إلى كمية هائلة من الماء.
تَبَدُلُ الأَنْظِمَةِ التَكْوِيْنِيةِ
إن الأنظمة التكوينية لتلك الحيوانات قد دخلها الإستثناء الإلهي من عدة جهات:
أولاً: لقد سلخ الله تعالى بقدرته روح السبعية من السباع، ولولا ذلك لما جلس الأسد مع النعجة في مكان واحد من دون أن يصيبها بأذى.
ثانياً: لقد أكلت الحيوانات اللاحمة أكل غيرها من الحيوانات النباتية وأكل الإنسان.
ثالثاً: عدم حصول فوضى في ذلك المكان الذي تحول إلى شبه غابة.
وهذه كلها مؤشرات على وجود الرعاية الإلهية لتلك السفينة المباركة ومَن كان على متنها.
لقد أدخل نوح(ع) جميع أصناف الحيوانات البرية إلى تلك السفينة، وقد يطرح سؤال حول موضوع الحشرات والحيوانات البحرية فهل أدخلها إلى السفينة أم لا؟
نقول: لم يرد نص ينص على أنه أدخل الحشرات، فقد تكون وُجدت بعد الطوفان من جديد، وليس ذلك على الله بعزيز، وأما الحيوانات البحرية فلم يكن هناك من داع لإدخالها لاحتمال أن تكون قد سبحت في مياه الطوفان، ويحتمل أن تكون قد هلكت ثم أعاد الله خلقها من جديد.
وقد يطرح سؤال آخر، وهو: لماذا لم يهلك الله جميع الحيوانات كما أهلك القسم الأكبر منها ثم أعاد خلقها من جديد من دون أن يكلف نوحاً بتلك الوظيفة الشاقة؟
قلنا ونقول بأن الله تعالى يُجري الأمور بأسبابها حتى لا يبقى الإنسان متحيراً في أسس الأشياء كما أخبره عن أصل وجوده كيلا يبقى جاهلاً بحقيقة نفسه، ثم إن هذا السؤال قد يتفرع عليه أسئلة مشابهة وهي أنه لماذا لم يخلق الله البشر دفعة واحدة؟
الجواب هو أن الخلق حصل بحكمة ومن أجل هدف، وعلى رأس الأهداف بناء المجتمعات والأسر المعبَّر عنها في القرآن بالشعوب والقبائل، هناك حكمة من الله الذي لا يُسئل عما يفعل، ولكنه لا يوجد سلوك رباني إلا ووراءه حكمة لنا.
ومن جملة المسائل التي ينبغي طرحها في المقام مسألة الحيوانات التي لم يُدخلها نوح إلى السفينة، فهو(ع) أدخل من كلٍ زوجين اثنين، والباقي هلك بالطوفان، فإذا كان الأمر الإلهي قد صدر بمعاقبة العاصين من البشر فلماذا شمل الحكم تلك الحيوانات؟
وهنا نقول ما يشبه قولنا السابق من أن الله تعالى هو المالك وهو يفعل في ملكه ما يشاء دون أن يسأله أحد، فلو اعتبرنا قبض أرواح الحيوانات ظلماً فلماذا تذبحونها وتأكلون لحمها، ولماذا تحبسون الطيور في الأقفاص وغيرها من الحيوانات.
فهل إذا قبض الله روح الإنسان كان ظالماً له؟ طبعاً لا لأنها سنة الحياة، وكذلك إذا قبض أرواح الحيوانات.
هناك دور أدته الحكمة الإلهية في وجود تلك الحيوانات وقد انتهى هذا الدور عند حدوث الطوفان.
طَاقَمُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ
كانت سفينة نوح معجزة بجميع تفاصيلها بدءاً من صناعتها ومروراً بضمها لتلك المخلوقات الكثيرة ووصولاً إلى ارتفاعها فوق سطح الماء ومكوثها على قمة الجبل بعد انتهاء الطوفان وابتلاع الأرض للماء وتوقُّف السماء عن إنزاله.
لقد كانت سفينة كبيرة جداً ومحكمة البناء والأشكال الهندسية التي تتلاءم مع عملية الإبحار، والظاهر أنها لم تكن السفينة الأولى التي صُنعت على أيدي البشر وإنما كانت أول سفينة تُصنع بهذا الحجم، فلو كانت أول سفينة وكان الناس خاليي الذهن من فكرة الإبحار لمَا أصبحت سفينته موضع استهزاء القوم الذين اتهموه بالجنون من خلال صناعة السفينة على اليابسة لأن المفروض هو أن تكون السفينة في الماء، ولذلك سخروا منه وتعجبوا من صناعته لها وقالوا بِلُغة المتعجب: أسفينة في الصحراء؟.. وهذا يعني أنها لم تكن صناعتها فكرة جديدة، بل الجديد هو حجمها وصناعتها في مكان بعيد جداً عن الماء إذ لا يمكن حملها إليه أو جرها ولو بواسطة آلاف الفيلة والحمير والبغال.
وربما يكون نبي الله نوح(ع) قد أخبرهم بدور هذه السفينة وعملها.
لقد استغرق وقتاً طويلاً في صناعتها حيث جمع كل الأخشاب اللازمة لصناعتها، والله وحده يعلم حجم تلك الكمية الهائلة.
وقيل بأن الله تعالى أمره بغرس الأشجار التي اتخذت منها الأخشاب وقد علّمه جبرائيل كيفية صناعتها بهذا الشكل.
وقيل استغرق صنعها من الوقت ثمانين سنة وليس ذلك ببعيد نظراً لحجمها الكبير وهندستها الرائعة، وقد قيل بأن طولها يُعد بمئات الأمتار، ولا بد أن تكون بهذا الحجم لكي تتسع لتلك الأعداد الهائلة من المخلوقات ومن الأكل والشرب والأمتعة، وقد كانت تلك السفينة عبارة عن عدة طبقات.
وأما طاقم السفينة فلقد كان نوح(ع) هو القائد لها والمدبر للأمر كله، وقد دخل معه السفينة كل من آمن به، وقد آمن به مجموعة من أولاده باستثناء واحد منهم وزوجته التي ذمها القرآن الكريم بقوله(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ)
والخيانة المذكورة هنا ليست خيانة زوجية بل هي عدم الإيمان، وقد عبّر القرآن عن العناد هنا بالخيانة.
(حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ)
لقد أمر الله نوحاً بأن يحمل معه من الحيوانات من كل زوجين اثنين وأن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول، وهم الذين استحقوا العذاب بسبب كفرهم وعنادهم، ومن جملتهم زوجته وأحد أولاده، ثم يخبرنا القرآن الكريم عن أنه لم يؤمن بنوح إلا قليل من الناس رغم عمله الذي ناهز الألف سنة.
وبعد ذلك أُقفلت أبواب السفينة بانتظار نزول المطر، وكان السكون مسيطراً على ركابها وهم يترقبون تلك الآية الكبرى.
(وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)
وهكذا بدأت البشرية رحلتها الجديدة من تلك السفينة التي لم ينج سوى ركابها بقدرة الله عز وجل.
تَحَقُقُ الوَعْدِ وَاسْتِحْقَاقُ الوَعِيْد
لم تخشع قلوب القوم ولم تَلِنْ عقولهم المتحجرة رغم ما رأوا من البراهين والأدلة على يد نبي الله نوح الذي أرسله الله رحمة لهم حيث دلهم على الحق وأرشدهم إلى الصواب وبيّن لهم شريعتهم، ولكن كان ذلك كله من دون جدوى إذ كان الشيطان مالكاً لهم من دون الله بسبب ضعفهم أمام الشهوات والنزوات وحب السلطة.
ورغم بداية نزول المطر من السماء وتلبدها بالغيوم السوداء المخيفة، ولعل ذلك حصل في أيام الصيف، ورغم أن الفرصة ما زالت مفتوحة أمامهم لم يقروا بالحق بل أصروا على ما هم عليه من الكفر حتى أصبح المطر غزيراً بشكل لم تعهده البشرية من قبل، هذا ونوح يناديهم ويعطيهم الفرصة الأخيرة للنجاة حتى علت المياه وبدأت تغطي كل شيء على هذا الكوكب الأرضي.
ثم أخذ الماء بالإنهمار بشكل مرعب ومخيف حتى علا فوق الجبال والله وحده يعلم كم كان علو الماء عن سطح الأرض، ربما كان بعشرات آلاف الأمتار وقد غطى الماء كل الكرة الأرضية بحيث أصبحت كتلة مائية، أذكر هذا الأمر لأن بعض الناس ما زالوا يعتقدون بأن الطوفان لم يشمل الأرض، مع أن الواقع هو أن الماء طغى على الأرض كلها من دون استثناء.
لقد ذكر القرآن هول الأمر وعِظَمه عندما شبّه الموج المتلاطم بالجبال حيث يقول(وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ) لقد كانت الموجة شبيهة بالجبل في بداية الطوفان، فكيف كانت بعد ساعات أو أيام؟
هذا ما يمكن أن يجيب به كل واحد منا نفسه عن طريق إجراء عملية حسابية أو عن طريق الوجدان من دون أي دلي آخر.
لقد حاول بعض الكفار أن يهرب من الموج فصعد أعالي الجبال الشاهقة في علوها، ورغم ذلك وصل الماء إليهم وأهلكهم.
ومن جملة الذين حاولوا الفرار أحد أولاد نوح الذي ناداه والده بأن اصعد إلى السفينة، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
ثم اختفى أثره وأثر كل اليابسة وما عليها فلا ترى هنالك سوى الماء النابع من الأرض والنازل من السماء وهو يتلاطم يميناً وشمالاً بشكل مرعب ومخيف وكلما مال الماء مالت معه تلك السفينة التي أشبه حجمها حجم المدينة، ولكنها لم تتأثر بشيء حيث كانت مشمولة بالرعاية الإلهية لأنها سارت على اسم الله وبركاته(بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا)
لقد استمر هطول المطر مدة أربعين يوماً، والله وحده يعلم حجم وقدر الكمية التي هبطت على الأرض حتى آن أوان انتهاء الرحلة بعد تلك المدة.
لقد حدث الطوفان وكان معجزة من الله سبحانه وتعالى أجراها على يد نبيه نوح الذي دعا على قومه بالعذاب وقد استجاب الله دعاءه، وفي ذلك قال عز وجل(وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا)
أنظروا كيف اختلفت الموازين وتبدلت المعادلات، ففي البداية كان نوح يرغب بأن يعطيهم ربهم فرصة علهم يهتدون ويرجعون إلى الصراط المستقيم، ولكنه عندما أيقن بإصرارهم على الكفر وأدرك حجم الخطر الذي سوف يتولد عنهم إن أبقاهم الله على قيد الحياة فعند ذلك سأل ربه بأن ينزل عليهم العذاب.
وهناك سؤال ينبغي طرحه حول موضوع الطوفان وهو يتعلق بمدة استمراره أربعين يوماً، فلماذا استمر تلك المدة الطويلة مع أن المفروض هو أن سكان الأرض قد هلكوا منذ اليوم الأول تقريباً؟
ونحن كعادتنا في هذه البحوث نريد أن نحيط بالأمر من كل جانب كيلا ندرك الأمور بشكل ناقص أو خاطئ.
لِمَاذَا اسْتَمَرَ الطُّوْفَانُ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً
إن للطوفان الذي حدث في عهد نوح(ع) مهمتين أساسيتين:
المهمة الأولى: وهي القضاء على الكفار والمعاندين الذين قست قلوبهم وتحجرت عقولهم فأصبحوا عبيداً مخلصين للشيطان الرجيم، فلا هم يستغنون عن وسوسته ولا هو يستغني عن معونتهم له في تنفيذ مهمته الإجرامية ضد بني آدم كلهم.
المهمة الثانية: وهي تظهر جلية من خلال البحث في الأمور الآتية:
الأمر الأول: ذكرنا في البحوث السابقة أن هناك أسلوباً يتعامل به الله مع عباده بهدف إفهامهم وتعليمهم، وهذا الأسلوب هو إجراء الأمور عبر أسبابها الطبيعية في الغالب، وأقول في الغالب ليخرج به المعجزات التي لا تلتقي مع قوانين طبيعتنا، ولكن في أكثر الموارد يُجري الله الأمور بأسبابها وأنظمتها الطبيعية والتكوينية.
الأمر الثاني: وهو أن الطوفان قد قضى على الجميع منذ البداية لأننا نستشعر من خطاب نوح مع إبنه أن الموج كان يعلو ويرتفع بشكل سريع جداً بحيث انقطع حوارهما نتيجة أن الماء قد غطى ولده الذي ربما يكون قد بادر بالصعود إلى القمة العالية التي أشار إليها القرآن.
الأمر الثالث: منذ فترة حصل طوفان بسيط للغاية وارتفع الموج أمتاراً معدودة ومع ذلك وبلحظات قليلة قضى الطوفان على عشرات الآلاف من سكان تلك المناطق التي شهدت هذه الكارثة.
الأمر الرابع: وعلى ذكر أن الله تعالى يجري الأمور بأسبابها ربما يكون استمرار الماء قد تحولت وظيفته من هدف إلى هدف آخر، أما الهدف الأول من غزارة الماء فهو القضاء على المعاندين والكفار، وأما الهدف الثاني فيُحتمل أن يكون إيصال السفينة إلى تلك القمة العالية التي حطت عليها في سلسلة جبال أرارات على الحدود الروسية لأسباب:
منها: أن يُظهر الله تعالى حجم ارتفاع الماء عن سطح الأرض لأنه عندما أمر الله الأرض بأن تبتلع الماء بدأت بابتلاعه، وبعد فترة من الهبوط حطت السفينة على قمة جبل يبلغ ارتفاعه خمسة آلاف متر أو أكثر من ذلك.
ومنها: ربما يكون استمراره أربعين يوماً تعبيراً عن شدة الغضب.
ومنها: أن الله تعالى أراد للبشرية أن تبدأ رحلتها الجديدة من تلك البقعة لحكمة لا يعلمها إلا هو عز وجل، وقد سُمي نوح(ع) بأبي البشر الثاني لأنه كان مصدر البشرية بعد أن قضى الطوفان على الجميع.
ومنها: ربما يكون ذلك من باب أن الله تعالى العالم بما سوف يكون علم بأن المنقبين سوف يصلون إلى تلك البقعة في عهد ابتعد فيه الناس عن الله والقيم والمبادئ والأديان، فأراد أن يعرّف الناس في القرن العشرين الماضي منذ سنوات قليلة على شأن العصبة الكريمة التي تخلى الناس عنها مع وجود أمرِ الله لهم باتباعها في هذه الحياة، وهم محمد وآله(ص) الذين وضع نوح لوحة في مقدمة سفينته مكتوب عليها تلك الأسماء الخمسة المباركة التي كانت السبب في حفظ السفينة من الغرق والتي سميت أيضاً بسفينة النجاة إلى يوم القيامة.
هذا ليس غلواً ولا كذباً بل هو واقع شهدته الأرض سنة ألف وتسع مئة وواحد وخمسين للميلاد أي منذ سبعة وخمسين عاماً من تاريخ اليوم حيث وجد المنقبون عن الآثار لوحة قديمة يعود تاريخ صنعها إلى آلاف السنين كان مكتوباً عليها كلمات بالسريانية، وهي اللغة التي تكلم بها نوح وقومه، وقد ترجمت هذه الكلمات إلى العربية فكانت أللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إحفظ هذه السفينة من الغرق.
هذا جزء من تلك الكلمات التي لا أحفظ منها سوى هذه الفقرة لأنها الأهم.
وقد وُضعت تلك اللوحة في أهم المتاحف البريطانية وهي موجودة حتى الآن لمن يريد التأكد منها.
وربما يكون هناك العديد من الغايات في استمراره أربعين يوماً لم يُطلعنا الله عليها أو أنها بُيِّنت في العصور الماضية ولم تصل إلينا ككثير من التعاليم والآثار التي فقدناها بألف سبب وسبب.
أما مسألة لماذا حطت السفينة على قمة ذلك الجبل أو لماذا لم تحط في مكة أو المدينة أو أي موضع مبارك؟ فهذا أمر يعود إلى الله عز وجل، ولا يجب علينا أن نعرف كل شيء، بل لا يمكن لنا أن ندرك جميع العلوم لقصر عقولنا وضعف طاقاتنا عن ذلك.
نِدَاءُ نُوْحٍ لِوَلَدِهِ
من الأمور البارزة التي ورد ذكرها في قصة نوح(ع) هو ذلك النداء الذي نادى به نوح ولده، والحوار الذي دار بينهما والذي كشف لنا عن أمور في غاية الأهمية، وفي نفس الوقت النداء الذي وجّهه نوح لربه بعد أن حقّت كلمة العذاب على ولده.
وقبل أن نلقي الضوء على تلك الأمور المستفادة من حوار نوح وولده الذي آثر الموج والهلاك على إعلان الإيمان نذكر النص القرآني الذي ركز على هذا الحوار نظراً لأهميته في مجال بيان الإخلاص لله عز وجل.
قال سبحانه(وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ){هود/42/43}
يشتمل هذا النص القرآني على عدة نقاط جديرة بالبيان:
النقطة الأولى: وهي مسألة تخصيص القرآن نداء نوح لولده، مع أنه طالما نادى كثيراً من الناس، فلماذا خصص القرآن هذه الناحية فقط؟
نحن نقول لا شك بأن نوحاً كان يرغب بصعود الجميع إلى السفينة لأن الصعود إليها يعني الإقرار والإذعان بما أتى به من عند ربه، ولكن القرآن الكريم ركز على ندائه لولده ليبين للناس عظمة الإنسان المؤمن الذي لا يفرط بذرة من إيمانه لا في سبيل نفسه ولا في سبيل ولده الذي هو أعز الناس على قلب الوالد، فلقد أراد القرآن أن يعطينا هنا درساً مهماً نستفيد منه طيلة حياتنا، وهو أن نؤثر رضا الله تعالى على كل شيء مهما كان مُهماً في نظرنا أو قريباً منّا نسبياً أو سببياً.
ولهذا خصص القرآن نداء نوح لولده فقال(وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ) وقد أراد أن يبين لنا كيف أن نوحاً تعامل مع ولده كما تعامل مع غيره رغم أنّ العاطفة تفرض نفسها في بعض الأحيان، لقد فرضت العاطفة نفسها على نوح ولكنه لم يضعف أمامها ولم يستسلم لها.
النقطة الثانية: وهي مستوحاة من قوله تعالى(وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ)
لقد كان ابن نوح في معزل عن أبيه، وهذا الإنعزال يفسَّر بعدَّة وجوه، يمكن أن يقال بأنه انعزل عن الإيمان الذي دعا إليه نوح، أو هو في معزل من شأن السفينة التي صنعها أبوه، ربما كان له دور في بنائها ليس من باب الإيمان بل من باب الرابط النسبي بينه وبين أبيه، وربما لا يكون ممن سَخروا من نوح، أكثر ما في الأمر أنه كان على الكفر ومات عليه، فقد تنسلخ من نفس المرء قوى الإيمان وتبقى باقي قواه ومشاعره موجودة، ولكن بقاء تلك المشاعر في نفسه تجاه أبيه لا تبرر له كفره ولا تخرجه عن كونه من الهالكين.
النقطة الثالثة: (يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ) فيشعرنا الخطاب القرآني هنا بأن نوحاً كان متألماً لمصير ولده، وكأنه يرجوه بالركوب حفاظاً عليه من العذاب الإلهي، وهنا لا ينبغي أن نسلخ مشاعر الأبوة من قلب نوح، فما يمكن أن نسلخه عنه هو أن يؤثر ولده على الدين فإن نوحاً أجلُّ من ذلك بكثير.
النقطة الرابعة: (قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء) حتى تلك اللحظة كان الناس مصرين على التمرد والعناد، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على كون العناد من الأمراض الخطيرة التي تنسي الإنسان نفسه وأهله كما أنسى العناد ابن نوح أباه وأخوته، كيف استطاع أن يمتنع عن الركوب مع أبيه، قليتعبره مسافراً وهو يدعوه معه إلى تلك الرحلة، ألا تتحرك بداخله مشاعر البنوة، ما معنى ذلك؟ معناه أن العناد أمر خطير قد أهلك أمماً من قبلنا، وسوف يهلك كثيراً من الأمم في المستقبل.
النقطة الخامسة: وهي رد نوح على ولده وإخباره بأنه لا نجاة لأهل الأرض إلا لمن ركب السفينة، وذلك بدليل قوله تعالى(قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ) فقد رحم الله الذين آمنوا برسالة نوح وركبوا معه السفينة إيماناً منهم بما أخبرهم نبيهم من حلول الغضب الإلهين باستثناء امرأة نوح التي ركبت السفينة بداعي الرابط السببي بينها وبين زوجها، وإلا فإنه لم تؤمن بالله تعالى، ورغم ذلك لم تغرق لأنها ركبت السفينة لأن سبب النجاة من الغرق آنذاك لم يكن الإيمان، بل كان الركوب في السفينة، فلو فرضنا أن أحد المؤمنين لم يركب السفينة-بغض النظر عن كونه في عدم ركوبها قد خرج عن الإيمان أو لا- فإنه لا شك كان سوف يغرق.
النقطة السادسة: النتيجة التي ذكرها القرآن الكريم في قوله(وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ)
وهنا نشير إلى أهمية الإستقامة في الدين، وأن أحداً لا يغني عن أحد شيئاً في يوم الحساب، فلا الله رحم ابن نوح تكريماً لنوح، ولا نوح تنازل عن شيء من دينه خوفاً من الله تعالى.
نِدَاءُ نُوْحٍ لِرَبهِ
قال تعالى(وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ){هود 44/47}
عند قيام السفينة على وجه الماء نادى نوح ولده بأن يصعد إليها فلم يلبي دعوة أبيه ولم يستجب لندائه فكان من الذين أغرقهم الله بالطوفان.
ونوح(ع) والد له مشاعره في الأبوة، وله عاطفته التي خلقها الله بين الوالد والولد، فعندما حُكم على ابن نوح بالغرق نادى نوح ربه وهو حزين على مصير ولده قائلاً(إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي) بمعنى أنه يطلب النجاة له من العذاب، وليس في مثل هذا الطلب معصية، بل هو تأكيد على المشاعر الإنسانية السليمة.
فأراد الله تعالى أن يريح قلب نوح من ذلك الحزن فأجابه قائلاً (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) ولا يعني ذلك أنه ليس ولده النسبي بل هو ولده من صلبه، ولكن الله تعالى في هذا الجواب مكّن تلك العلاقة القائمة على أساس الإيمان فجعل المؤمن قريب المؤمن وإن لم تربطهما النسبية، وسلخ تلك العلاقة عن القريب النسبي إذا كان كافراً، بمعنى أنه يا نوح لا تأسف عليه إنه كافر، ولا يليق بالمؤمن أن يستشفع للكافر، وهنا أرشد الله نبيه نوحاً إلى جوهر تلك الحقيقة وكأنه يقول: لو كان يحبك كما تحبه لاتبعك ولكنه خالفك فخرج عما أنت فيه إلى عالم آخر.
ولعل نداء نوح لربه حصل بعد انقضاء الطوفان وهبوط السفينة على الجبل لأن الحديث عن نداء نوح لله جاء بعد قوله تعالى(وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ)
فعندما سمع نوح جواب ربه أدرك حجم الغضب الإلهي على الذين كفروا وأنه لا ينبغي الحزن والأسف على عباد غضب الله عليهم بسبب كفرهم وعنادهم، فشعر نوح بخطورة الموقف فآخذ نفسه على ذلك الطلب طالباً المغفرة والرحمة من الله عز وجل موقناً بأنه إذا لم تتوجه الرحمة الإلهية فسوف يكون من الخاسرين.
وهنا لا بد من مرور سريع على فقرات تلك الآيات التي صورت لنا ظروف نداء نوح بعد أن هبطت سفينته على الجبل بأمان.
(يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ) أهل المؤمن هم أمثاله في الإيمان، فهم أنفع له من أنسابه البعيدين عن الله، ونلاحظ بأن القرآن لم يكتف بالقول إنه ليس من أهلك كيلا يظن الناس بأن الذي ناداه نوح لم يكن ولده وإنما أتبع القرآن قوله بقوله(إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) فعلم الناس بأن سبب سلخ الأهلية لم يكن النسب وإنما كان السلوك السيء.
(فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) لعله تعالى أراد لنوح أن لا تسيطر عليه العاطفة فنهاه عن أن يسأله ما لا يعلمه، فإن هناك أسباباً عند الله تعالى غير التي نعرفها نحن البشر، ولو كان في بيانها مصلحة لذكرها.
(إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) إن الله تعالى لا يريد لنبيه نوح(ع) أن ينزل إلى مستوى لا يليق به، فحذره من متابعة الأمر الذي أحزنه، وعند ذاك ادارك نوح الأمر وسلّمه لله تعالى ثم طلب منه المغفرة وهو لم يرتكب ذنباً فإن في مسألة الإستشفاع لولده لا يوجد ذنب وإنما يوجد حلقة مفقودة علمها عند الله تعالى.
وهنا أريد أن أشير إلى أمر فيه فائدة عظيمة إذا عرفناه وتدبرناه، وهو أن نوحاً(ع) رغم القرون الطويلة والتعب العظيم والسهر في سبيل الحق وتحمل أذى القوم جيلاً بعد جيل لم يفكر في نفسه أنه صاحب فضل بل بقي ظاناً بأنه مقصر أمام حق الله عز وجل، ولهذا فقد اعتبر سؤاله في ولده ذنباً وقد طلب الرحمة والمغفرة، مع أنه لم يرتكب ما يدعوه إلى طلبها، أما نحن الذين نقول بأننا مؤمنون بالله ومطيعون له فلو امتحننا الله ببلاء بسيط جداً لشككنا في أنفسنا بربنا وأخذتنا المنة وقلنا لماذا نزل علينا البلاء ونحن نطيع الله…
بعد تلك الأحداث كلها أهبط الله سفينة نوح بسلام وآمان لتبدأ الحياة البشرية من جديد، وفيه يقول تعالى(قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أليم)
مُعْجِزَاتُ نَبِي اللهِ نُوْحٍ(ع)
لقد أجرى الله تعالى معجزات كثيرة على يد نوح(ع) لأنه مع عدم وجود الإعجاز لا تقوم الحجة على الناس، وقد جعل الله عز وجل المعجزة علامة على النبوة، وإلا لكان بإمكان أي طامع بالشهرة والمال والسلطة أن يدعي النبوة، وهذا من شأنه أن يُحدث خللاً كبيراً في عالم الرسالات السماوية.
لقد ذكر القرآن أحداث نوح الخاصة بالإعجاز، ولكنها كانت مختلفة نوعاً ما عن معجزات باقي الأنبياء إذ أن معجزاته أشبهت النظام التكويني المعلوم باستثناء فوران التنور فهو الذي خرج كلياً عن نطاق هذا النظام الطبيعي، ولعل هذا هو منشأ اعتقاد البعض بأنه لم يأت بمعجزات علماً بأن له أكثر من معجزة من الطراز الأول.
وعلى فرض أن ظروف النبي لم تكن مؤاتية للقيام بالإعجاز لعدم الحاجة إليه فلا يكون هذا النبي فاقد الأهلية لذلك، وإنما المانع منه كان الظروف المحيطة، وليس النبي الذي لو أراد الإعجاز لحقق الله له ذلك.
وقد نجد بأن النبوة ارتبطت مع الإعجاز ارتباطاً متيناً بحيث نشأ بينهما تلازم فإنك إذا ذكرت النبي أو النبوة تبادر إلى ذهنك الإعجاز مباشرة حيث اعتادت البشرية على أن يأتي كل نبي بمعجزة واحدة على الأقل.
ولأجل بيان هذا الطرح نذكر لكم بعض معجزاته ولو بشكل موجز.
العمر المديد وعلاقته بالإعجاز
من جملة الأمور التي ينبغي طرحها حول حياة أبي البشر الثاني نوح(ع) هي مسألة العمر المديد لنرى هل لهذا الأمر علاقة بالإعجاز أو أنه كرامة أو مسألة طبيعية ترتبط بالنظام الكوني المحض.
فإن نبي الله نوحاً(ع) أكبر مُعمِّر في هذه الحياة حيث لم يذكر لنا التاريخ أن شخصاً عاش على وجه البسيطة مدة من الزمن تجاوزت حدود المعقول كما كان حال نوح الذي ناهز عمره الألفي سنة، وربما تجاوز هذا الرقم.
والجدير بالذكر حول هذا التعمير المميز أن ملامح الشيخوخة لم تظهر عليه رغم تقدمه بالسن.
ليس الأمر عادياً بل هو مؤيَّد بالمعجزة، وقد استبعد البعض إعجازه لكونه مرتبطاً بالنظام الكوني العام لأن التقدم في السن يعتبر أمراً عادياً، فهو يخضع لبعض أنظمة الكون، ولكنه بما تجاوز الحدود المعقولة ومن دون أن تظهر ملامح الشيخوخة عليه اعتبرناه معجزة لأنه أمر خارق لقوانين الطبيعة.
ولذا نقول: لا شك بأن مسألة العمر تخضع للقوانين الكونية نتيجة للإرتباط بينهما، ولكن عندما يتجاوز الأمر حدود الطبيعة المألوفة يصبح موضع تساؤل عند العقلاء فيبدأ النقاش حول ما إذا كان هذا نوعاً من الإعجاز أو لا، والأقرب أنه معجزة نتيجة للإرتباط الوثيق بين النبوة والإعجاز، فإن كونه خاصاً بالنبي دليل على إعجازه، فالنبوة علامة على الإعجاز كما كان الإعجاز علامة على النبوة.
فإذا انتفى كونه معجزة لعدم توفر شروط الإعجاز فيه انتفى كونه من الإعجاز، ولكن لم ينتف كونه أمراً غير اعتيادي.
وعلى فرض استطاع أحد من الناس أن يسلخ عن هذا الحدث صفة الإعجاز فإنه لا يستطيع أن ينكر وجود الكرامة في ذلك فإن الكرامة أمر خارق ومميز، ولكنه يشبه أنظمة الطبيعة.
ويمكن لنا أن نصل إلى النتيجة التالية، وهي: أن المعجزة تخرق أنظمة الطبيعة، وأن الكرامة تخضع لتلك الموازين مع وجود فوارق بينها وبين الأنظمة العادية التي تسير بالشكل الطبيعي.
ويمكن القول حينئذ بأن المسألة فيها تسديد إلهي، وذلك لوجود أمور خارجة عن النظام العام كمسألة عدم ظهور ملامح الشيخوخة عليه.
كما ويمكن إدراج هذا الأمر تحت عنوان الرعاية الإلهية، وبهذا يتحصل لدينا أن بعض خصوصيات الأنبياء عليهم السلام إما أن تكون معجزة أو كرامة أو ما هو مندرج تحت عنوان الرعاية.
والسبب في هذا التقسيم هو أن المعجزة لها شروط وكذلك الكرامة، ولما لم يقنع البعض بأن مسألة العمر المديد معجزة لفتنا نظره إلى الكرامة، وهي في نفس الوقت أمر غير اعتيادي، فإذا أنكر الكرامة أيضاً كان لا بد من إيجاد عنوان ثالث ندرج تحته تلك الحالة وهو الرعاية الإلهية، وإذا أنكر كل هذه الإحتمالات أصرينا على كون ذلك معجزة وكان المنكر لهذا الحدث معانداً.
نعم.. يمكن الشك بالأمر فيما إذا كان نوح هرماً قد ظهرت عليه ملامح الشيخوخة، ولكن بما أنه امتاز بقدرة الشباب رغم عمره المديد كان ذلك أمراً مميزاً، وبهذا نخرج الطاعنين في السن من هذه القاعدة.
وبمعنى آخر: لقد اعتبرنا العمر المديد في نبي الله نوح معجزة، بينما لا نعتبره في غيره كذلك حتى في أولئك الذين عمّروا ما يناهز الألف سنة، ولم نعتبر طول عمر نوح معجزة لكونه نبياً بل لكونه امتاز عن باقي المعمرين بعدم ظهور ملامح الشيخوخة عليه.
ولكن العمر المديد من دون ملاحظة آثاره على الجسد والنفس ليس معجزة في الأصل لكونه مرتبطاً بأنظمة هذه الطبيعة التي يموت فيها الإنسان شاباً أو طاعناً في السن بسبب بعض العوامل الطارئة من مرض وحادث ونحو ذلك.
ففرعون عمّر طويلاً، وهو بعيد كل البعد عن المعجزة والكرامة والرعاية الإلهية، فقد عاش مئات السنين ومات حين نزل الغضب الإلهي عليه.
والبحث في حقائق العمر المديد يضفي على بحثنا وضوحاً وجلاءاً وخصوصاً عندما نرجع إلى القرآن الكريم ونرى كيف ينظر إلى هذا الموضوع.
فلم يتعرض القرآن الكريم إلى ذكر تمايز الأولين بالأعمار المديدة كما هو معتقد كثير من الناس حيث لم تكن هذه الحالة عامة وشاملة، فإن هناك من مات في مقتبل العمر أو في الأعمار المتوسطة بحسب المعايير الحالية والطبيعية إذ قد يكون العمر المتوسط في بعض الأزمان الماضية أكثر بكثير مما نحن عليه اليوم.
وقد كانت نسبة الوفاة المبكرة عالية جداً في الزمن الماضي بسبب تعرُّض الناس للأمراض القاتلة والأوبئة الفتاكة التي كات تصيبهم بين الحين والآخر والتي لم يكن لها علاج في ذلك الزمان، وبسبب تعرضهم للإصابات أثناء سفرهم من بلد إلى آخر عبر الأودية والجبال والصحارى كعضة ضبع ولسعة أفعى أو حشرة سامة أو وقوع من على صخرة أو وقوع من على ظهر الدابة وغير ذلك من أسباب الموت التي لا تعد ولا تحصى.
وقد أشرنا إلى هذه النقطة لأن كثيراً من الناس يعتقدون أن العمر المديد كان من نصيب الأولين حيث يظنون بأن جميع الماضين كانوا من المعمرين، هذا مع العلم بأن العمر المديد لم يكن بالأمر العام، وإنما اختص بالبعض منهم فقط، وهم الذين حالفهم الحظ في الهروب من تلك الأسباب غير القضاء الإلهي لأنه إذا أتى القضاء بالموت مات الإنسان وإن لم يكن هناك سبب له.
أضف إلى ذلك أن نسبة وفاة الأطفال في الماضي لم تكن قليلة كما نظن، بل ربما تجاوزت نسبة وفاة الأطفال الحاليين وذلك بسبب التطور في صناعة الأدوية الفعالة وأسباب العلاج الذي شابه السحر في أيامنا.
وقد أشار القرآن إلى هذه الناحية التي يعتبرها من خصوصيات الطبيعة لأن الموت مرتبط بسبب، فمتى ما تحقق السبب حصل الموت من دون النظر إلى كون الميت طفلاً أو كهلاً أو شيخاً هرما.
قال تعالى(وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ){الحج /5} فلم تعن الآية قوماً دون قوم، ولا زمناً خاصاً، وإنما عنت الجميع في الماضي والحاضر والمستقبل.
ومن جملة الذين تمتعوا بالعمر المديد نوح(ابو البشر الثاني) ولعل الحكمة من وراء عمره المديد هو كونه مصدر البشرية بعد هلاك البشر بالطوفان، ففي مثل هذه الحالة لا بد أن يتمتع بعمر مديد لينتشر البشر على الأرض من جديد، وهذا هو السبب الذي دفع بنا إلى وضع عنوان يختلف عن المعجزة والكرامة، وهو الرعاية الإلهية.
لقد أشار القرآن إلى عمر نوح بشكل غير مباشر، وذلك عندما بين لنا مدة لبثه في قومه حيث قال تعالى(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ){العنكبوت/14}
لم يكن هذا الرقم كامل عمر نوح وإنما كان المدة التي دعا فيها قومه إلى الإيمان بالله تعالى، وهذا معنى قوله(لبث فيهم) وقد عاش مئات السنين بينهم قبل مبعثه ثم عاش مئات السنين بعد الطوفان حتى كثر النسل الآدمي على الأرض مجدداً.
فمسألة الأعمار المديدة أمر ذكره القرآن الكريم بشكل عادي ولم يعلق على شيء فيه.
ولكن الذي ركز على تلك المسألة وأوضحها للناس هو النبي الأكرم(ص) والأئمة المعصومون(ع) ليكون ذلك عبرة لهم على مر السنين.
وبسبب هذا العمر المديد وغيره من الأسباب شهد تاريخ نوح أكثر من معجزة أجراها الله على يديه لتكون علامة على نبوته كما صنع ذلك مع باقي أنبيائه حيث سددهم بهذا السلاح الذي لا يُنكر ولا تستطيع قوة في العالم أن تواجهه.
لقد جرت معجزات كثيرة على يد نوح، غير أن معجزاته امتازت عن غيرها بكونها مشابهة للنظام الكوني، وهي ليس داخلة فيه كالطوفان الذي حدث عن طريق المطر الغزير، وصناعة السفينة التي صُنعت من المواد المعلومة، وكالعمر المديد الذي بلغ مرحلة غير طبيعية، نعم هناك معجزة واحدة من معجزاته لم تشابه النظام الكوني وهي فوران التنور بالماء كعلامة على بدء الطوفان، وهناك أشياء قام بها نوح لم تكن عادية وهي توحي بالإعجاز.
منها: غرس الأشجار التي صنع من خشبها تلك السفينة الكبيرة، وهذا يعني بأن يد الغيب قد أوحت إليه فعل ذلك لأمرٍ سوف يحصل في المستقبل، وهذا بحد ذاته معجزة لا تنكر.
ومنها: صبره المميز الذي ناهز الألف سنة، ونحن نعلم بأن الله تعالى قد أمر عباده بالصبر فجعله جزءاً من الإيمان، وكل الناس يدركون بأن الصبر له نسب تختلف بين شخص وآخر، فإن منهم من يصبر مرة أو مرتين أو في خلال مدة من الزمن ثم بعد ذلك يفقد صبره تجاه بعض المسائل، وربما يستمر الصبر فيه إلى آخر لحظة في حياته.
ومهما صبر الفرد منا فإن صبره لن يصل إلى مستوى صبر الأنبياء(ع) لأنه على حجم البلاء، وإن أكثر الناس ابتلاءاً هم الأنبياء.
فلننظر سوياً إلى مدى صبر نوح(ع) الذي استغرق تسعماية وخمسين سنة ولم يتباطئ يوماً عن تبليغ ما أمره الله تعالى به، فلقد صبر على الأذى المادي والنفسي وعلى السخرية التي صدرت من قومه تجاه الرسالة التي حملها، وخصوصاً بعد أن أمره الله عز وجل بصنع السفينة، ولكنه(ع) لم يأبه لذلك، ولم تؤثر استهزاءاتهم عليه سلباً، بل زاده ذلك ثباتاً وأعطاه عزيمة فوق عزيمته.
فمن أراد أن يأخذ الدروس عن الصبر فلينظر إلى صبر الأنبياء وأهل البيت(ع) فإنهم بلغوا قمة الصبر في حياتهم.
وبعد ذلك ندرك بأن صبر نوح شابه الإعجاز إن لم نقل بأه معجزة بحد ذاته.
ومنها: الإعجاز في جمع جميع أصناف الحيوانات:
فقد كان يجب على قوم نوح أن يفكروا قليلاً في مسألة جمع الحيوانات المتنوعة ووضعها في مكان واحد من دون أن يفترس القوي الضعيف، ومعنى ذلك أن النظام الخاص بهذا الشأن قد تغير في تلك الظروف التي كان من شأنها أن تلفت انتباه الناس إلى تلك الخصوصية التي لم تكن لأحد من قبل.
لقد جرى هذا الأمر على مرأى ومسمع من الناس، ولا شك بأن منهم من لفت انتباهه ذلك، غير أنه لم يؤمن بما جاء به نوح، ففضَّل البقاء مع الأكثرية لظنه بأنها الغالبة، مع أن الأكثرية القائمة على الكفر والباطل لا يُكتب لها النجاح، وإذا كُتب لها ذلك فلن يكتب لها الإستمرار.
ومنهم من أعمى الكفر قلبه وعينه فلم ينتبه للأمر الذي كان ينبغي أن يلفت نظر الجميع إذ كيف يمكن أن يتغير النظام الذي استمر ملايين السنين في إشارة من نوح رغم عجز الأقوياء عن السيطرة على حيوان مفترس واحد من تلك الحيوانات التي أدخلها نوح في السفينة من دون أن تحدث أية حالة عنف بين صنف وآخر.
ثم إن للإعجاز وجهاً آخر في مسألة جمع الحيوان، وهو أنه كيف استطاع نوح أن يعثر على جميع أصناف الحيوان في مدة قصيرة من الزمن، وكيف استطاع أن يسيطر على الجميع ولم يكن قد تعاطى مع الحيوانات من قبل.
إن مسألة جمع الحيوانات وما تعلق بها من قبيل ائتلافها في السفينة رغم تناحرها في الخارج إنما كان معجزة من الله تعالى.
ينبغي إثبات هذه المعجزة في سجل المعجزات المعترف بها عند المسلمين حيث لا يجوز التغافل عن هذا الحق الكبير الذي أظهر الله به عظمة نوح(ع)
لقد تم جمعها بأمر من الله سبحانه وتعالى، وقد بيِّن القرآن الكريم هذه الناحية بقوله(حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ)
كثير من الناس بشكل عام يقرؤون قصة نوح(ع) ويستأنسون بروعتها القصصية وأحداثها الشيقة، ولكنهم قَلَّما ينظرون إلى القيمة الإعجازية في تلك السيرة العطرة التي تستحق الجانب الأكبر من الإهتمام لأنها تمثِّل أنفع المحطات التاريخية قبل الإسلام.
وقد يتساءل بعض الناس حول حدث الطوفان العظيم الذي جرى في زمن نبي الله نوح(ع) هل كان له علاقة بالإعجاز أم كان مجرد حدث أجراه الله تعالى على يد نوح لكي يقضي أمراً تجاه قومه المعاندين وهو إنزال العذاب بهم.
ومع تأمل بسيط في الغاية من إحداث الطوفان نجد أن له علاقة متينة بالمعجزة لأنه يرتبط بمسألة الدعوة إلى الله عز وجل.
وكذلك لو أدرجنا موضوع هذا الطوفان بعينه على القاعدة لوجدنا أنه لم يكن طوفاناً عادياً بل كان أمراً خارقاً للعادة، فهو ينسجم مع موضوع المعجزة وتعريفها العام.
أضف إلى ذلك أن الطوفان لم يحصل بطريقة عادية ومألوفة، وإنما حصل في مكان وزمان لم يكن أحد ليصدق بأنهما موضعان للطوفان أو محلاً له، بالإضافة إلى كونه قد حدث على إثر دعاء نوح على قومه.
وأكبر دليل على كونه خارجاً عن نطاق المألوف أنه أصبح هو المتبادر إلى الأذهان بمجرد ذكر كلمة الطوفان مما يعني أنه كان فريداً من نوعه، ولأجل ذلك طغى على ذكر وخبر كل طوفان قبله أو بعده.
ومن جملة الأدلة على كونه معجزة أمران:
الأول: مدته، فقد ذكر أنه دام أربعين يوماً بشكل غزير ومستمر.
الثاني: أثره على الأرض: فقد كان طوفاناً رهيباً حيث غطى اليابسة كلها فلم يبق منها موضع إلا وغطته المياه بدليل قول ابن نوح كما حكى القرآن الكريم(قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ)
حتى لو صعد إلى أعلى قمة في العالم وهي تتجاوز الثمانية آلاف متر فسوف يدركه الماء لأن الأمر الإلهي قد قضى بإغراق هذه الأرض بما فيها قمم الجبال العالية.
ومن خلال ما ذكرناه يتضح لدينا بأنه كان معجزة أجراها الله تعالى على يد نبيه نوح، غاية ما في الأمر أنه معجزة شبيهة بالحوادث الطبيعية وهو ليس في الحقيقة أمراً طبيعياً.
وحديث القرآن الكريم عن ذلك الطوفان يوحي بالإعجاز ، ووجه الإعجاز في الطوفان هو أنه لماذا لم يمت بسببه إلا الكفار؟ فلو كان طوفاناً عادياً لما فرق بين إنسان وإنسان.
ولماذا نجا نوح ومن معه ؟ ومن الذي أخبر نوحاً بالطوفان وأمره بصنع السفينة؟
ليس الأمر صدفة كما يدعي بعض المعاندين للحق .
تعالوا نرجع سوياً إلى المنطق الإلهي واللهجة القرآنية تجاه الحديث عن طوفان نوح وسوف نجد بأن الأمر كله معجزة.
قال تعالى(حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ)
فوران التنور
وهو من معجزات نبي الله نوح(ع) فوران التنور بالماء بينما كان مشتعلاً بالنيران، ولا شك بكون ذلك معجزة قد أجراها الله تعالى على يد نوح لتكون علامة على قرب موعد الطوفان.
وقد كان ذلك التنور من آثار حواء فقيل بأنها كانت تخبز فيه وقد توارثه الأبناء والأحفاد حتى وصل إلى يد زوجة نوح التي قال لها زوجها إذا فار هذا التنور بالماء فأسرعي إلى السفينة.
والتنور معجزة على كل حال سواء خرج منه الماء وهو مشتعل أم خرج منه الماء وهو معطل لأن السؤال القائم حول هذا الأمر هو أنه كيف خرج الماء من التنور ومن أين مصدره.
فيظهر لنا بأن فوران التنور من معجزات نوح(ع).
وقد أصبح هذا التنور مضرباً للمثل لمن يريد أن يعبر عن شدة غضبه وفوران دمه.
نُوْحٌ(ع) فِيْ نَظَرِ أَهْلِ العِصْمَةِ(ع)
إن جميع التعاليم التي نذكرها عن الأنبياء بشكل خاص مصدرها القرآن نفسه وكلام أهل العصمة سلام الله عليهم، فإننا لولاهم لما عرفنا من الحق شيئاً، ولما أدركنا أسرار هذا الوجود.
والحديث عن تاريخ الأنبياء وبيان مواقفهم هو أمر ديني لا يجوز تغييره أو تبديله أو إضافة شيء إليه من دون دليل لأن الأمر ليس ذوقاً خاصاً بل هو رسالة ائتمننا الله عليها حتى نؤديها للناس بهدف التوجيه والتعليم وكسب العبرة من حياتهم الطويلة وتجاربهم الكثيرة التي كانت متوجة بالفائدة لكل جيل عبر الزمن.
لقد حدثنا رسول الله محمد(ص) وأهل بيته الأطهار بأمور كثيرة عن تاريخ نوح(ع) وقد ذكرنا في بحث سابق أن نوحاً أول رسول أرسله الله إلى العالم، هذه المعلومة مستفادة من حديث لرسول الله(ص) قال فيه:أول نبي أرسل نوح:
وقد شهدت الأرض أنبياء قبل نوح في الفترة ما بينه وبين آدم، ولكنهم لم يكونوا رسلاً، ومن جملة من آتوا قبل نوح إدريس(ع) الذي حدثنا القرآن الكريم عنه في آيتين من آياته.
وقد ورد في هذا الشأن حديثان أحدهما عن الرسول(ص) الآخر عن الصادق(ع) فقد قال الرسول الأكرم(ص) ” أول الأنبياء آدم ثم نوح وبينهما عشرة آباء”
الرسول قال بأن آدم أول نبي ولم يقول أول رسول لأن أول الرسل هو نوح وليس آدم، والرسول هو الذي أرسله الله تعالى بشريعة إلى الناس، ثم يذكر النبي أن بين آدم ونوح عشرة آباء، وقد أوضح الإمام الصادق(ع) حقيقة هؤلاء الآباء حيث قال: كان بين آدم وبين نوح عليهما السلام عشرة آباء كلهم أنبياء:
وقد أشرت في أحد البحوث الماضية إلى أن نوحاً(ع) أمر بأن يغرس النوى وينتظره ليقطعه ويصنع منه السفينة وقد حدثنا إمامنا الباقر(ع) عن هذه الناحية مشيراً إلى المشقة التي تحملها في سبيل الدعوة إلى الله تعالى حيث قال: إن نوحاً(ع) لما غرس النوى مر عليه قومه فجعلوا يضحكون ويسخرون ويقولون قد قعد غراساً، حتى إذا طال النخل وكان جباراً طوالاً قطعه ثم نحته فقالوا قد قعد نجاراً، ثم ألّفه فجعله سفينة فمروا عليه فجعلوا يضحكون ويسخرون ويقولون قد قعد ملاحاً في فَلاة الأرض حتى فرغ منها:
ويروي صاحب البحار عن الإمام الصادق(ع) أنه قال: عاش نوح(ع) ألفي سنة وخمسمئة سنة منها ثمانمئة سنة وخمسون سنة قبل أن يُبعث، وألف سنة إلا خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم، ومائتا عام في عمل السفينة وخمسمائة بعدما نزل من السفينة ونضب الماء فمصّر الأمصار وأسكن ولده البلدان، ثم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقال السلام عليك فرد عليه نوح وقال له ما حاجتك أو ما جاء بك يا ملك الموت؟ فقال جئت لأقبض روحك، فقال له تدَعُني أدخل من الشمس إلى الظل فقال له نعم، فتحول نوح(ع) ثم قال يا ملك الموت: فكان أو كأن ما مر بي في الدنيا مثل تحولي من الشمس إلى الظل فامض لما أمرت به:
الشيخ علي فقيه