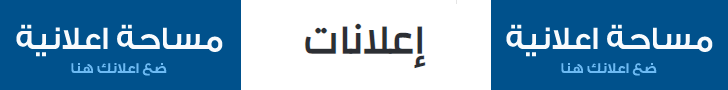وظائف الرسل والأنبياء(ع)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على رسوله الكريم وآله الميامين وأصحابهم المنتجبين
لقد أخذ الحديث عن الأنبياء ومهامهم في كتاب الله حيزاً كبيراً، فمنهم من ذكر الله تعالى تفاصيل كثيرة من حياته، ومنهم من اقتُصر على ذكر اسمه، ومنهم من لم يُذكر إسمه فضلاً عن سيرته، ويعود سبب هذا الأسلوب إلى حكمة الله تعالى في بيان الأمور والكشف عن الأحداث، فهو يعلم ما ينفع وما لا ينفع، ولعله تعالى اختار من الأحداث ما يتماشى مضمونه مع حياتنا اليومية ليكون ذلك توجيهاً لنا نصحح به سلوكنا وسيرنا بعد النظر إلى تجارب الذين ذكرهم الله في القرآن.
قال سبحانه(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ) وقال تعالى(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ)
ولكي أضبط البحث بشكل واضح أود أن أحصر الكلام في نقاط:
النقطة الأولى: سبب تفضيل بعض الأنبياء على البعض الآخر:
وهذا أمرٌ لا يخفى على عاقل ولا ينكره مؤمن لأن النص القرآني صريح في بيان هذا المعنى، يبقى السر كامناً في سبب هذا التفاضل بينهم، فالجميع أنبياء، والجميع معصومون، والجميع كان الهدف من بعثهم واحداً.
ولا يمكن الجزم بسبب معين في مسألة التفاضل بينهم إذ يبقى ذلك سراً من أسرار رب العالمين، ولكنه تعالى أشار شيء في القرآن، ولا يمكن لنا أن نجعل ما أشير إليه سبباً في هذا التفاضل كما في قوله تعالى(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ)
فهل أن التكليم سبب التفاضل بين من كلمه ربه وبين من لم يكلمهم؟ أم أن موسى(ع) كان أفضل من بعض من سبقه من الأنبياء ولأجل ذلك كلمه ربه؟ أم هل أن كثرة ذكر أحد الأنبياء يكشف عن كونه أعظم وأفضل من غيره؟
والآية الكريمة ليست صريحة في كون التفاضل حصل بسبب التكليم أو كان التكليم أحد أسباب التفاضل، لعل قوله تعالى(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) عبارة مستقلة بحد ذاتها كان الغرض منها الكشف عن وجود تراتبية بين الأنبياء، ثم أشار الله تعالى إلى موضوع آخر يُظهر من خلاله بعض مزايا الأنبياء كالتكليم مثلاً.
وأما قوله تعالى(وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ) يُحتمل أن يكون المراد عاماً والمعنى شاملاً لغير الأنبياء أيضاً، وهو واضح الدلالة إذ لا شك بأن الأنبياء(ع) كلهم أفضل من الناس العاديين، ومن هنا يظهر لنا أن المعنى من الآية هو رفع بعض الأنبياء درجات على بعض الأنبياء الآخرين، ويبقى السبب أولاً وأخيراً مجهولاً لدينا.
ثم إن هذا التفاضل موجود بين أنبياء العزم أنفسهم فإن سيدنا محمداً(ص) هو أعظم الأنبياء على الإطلاق، وأنبياء العزم أفضل من غيرهم، وباقي الأنبياء بعضهم أفضل من بعض.
ونحن نعتقد بأن هذا التفاضل لم يحصل من دون سبب فإن له سبباً كبيراً نحن نجهله، ربما يكون السبب عائداً إلى حجم المعاناة أوحجم الدور الذي لعبه هذا النبي أو ذاك، أو إلى الظروف التي كانت محيطة به، ولعل أبرز سبب لهذا التفاضل بحسب فهمنا هو حجم الإيمان الذي اشتمل عليه قلب النبي، والكل يدرك بوجود تفاوت بين رتبة ورتبة أخرى في درجات الإيمان، فما كان في قلب محمد(ص) لم يصل إلى حدوده ما كان في قلب موسى أو عيسى.
وأما موضوع كثرة ذكر النبي الفلاني في القرآن فلا نرى له أية علاقة في موضوع التفاضل بينهم لأننا نعتقد بأن عيسى(ع) أعظم من يوسف لأن عيسى من أولي العزم، ومع ذلك فقد نزلت سورة كاملة تتحدث عن قضية يوسف ولم تنزل سورة بهذا الحجم تتحدث عن عيسى(ع).
النقطة الثانية: العبرة من عدم ذكر جميع الأنبياء في القرآن:
من المعلوم لدى أكثر الناس أن الله تعالى أرسل إلى البشرية منذ نشوئها أكثر من مئة ألف نبي، وإنه لرقمٌ ضخم وعددٌ هائل بالنسبة إلى الأنبياء الذين ذكر القرآن أسماءهم وبيّن شيئاً من أحوالهم وأشار إلى نبذة عن تواريخهم، وكان عددهم خمسة وعشرين نبياً، هم: آدم وإدريس ونوح وهود وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف ويونس وصالح وذو الكفل وإلياس ويحيى وزكريا وداود وسليمان وأيوب وشعيب وموسى وهارون ولوط واليسع وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين.
وهو عدد كبير نظراً للزمن الفاصل بين أول الأنبياء(آدم) وخاتمهم(ص) والذي يزيد قليلاً على عشرة آلاف سنة أو ينقص قليلاً عن هذا الرقم.
فموضوع وجود أنبياء غير الذين ذُكروا في القرآن الكريم هو أمرٌ مسلَّمٌ به وذلك لقوله تعالى(وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ) وهنا كلام هامٌ حول أبعاد هذه الآية المباركة.
فهل هي ناظرة إلى الذين ذُكرت أساؤهم في القرآن وقد نزلت في زمن لم يكن الحديث عن الأنبياء قد اكتمل نزوله؟ أم أنّ المراد بها هم الخمسة وعشرون نبياً، ومن لم يقصصهم على النبي هم باقي العدد التام والذي هو مئة وأربعة وعشرون ألفاً؟
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن المفسرين لم يتبنوا هذا الرأي وأن الذين لم يذكر الله أسماءهم لم يذكرها فيما بعد وأن المراد بهم غير الذين وردت أسماؤهم، ومن جهة ثانية حتى لو لم يكن حين نزول هذه الآية قد اكتمل النزول فإن الله تعالى عندما أنزل القرآن على خاتم أنبيائه قد أنزله على قلبه دفعة واحدة، وبهذا تكون الآية ناظرة إلى الجميع وأنه فعلاً يوجد كثير من الأنبياء لم يحدّث القرآن عنهم.
إن هذا الأمر كان معلوماً لدى النبي(ص) منذ اليوم الأول من بعثته الشريفة، وقد كانت كل تعاليم القرآن لفظاً أو معنى أو كلاهما موجود في قلب الرسول بدليل قوله تعالى(وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) وبهذا يتضح لدينا أن الذين قصّهم الله تعالى على رسوله هم تمام العدد الذي ورد في القرآن الكريم، أي خمسة وعشرون نبياً بما فيهم خاتمهم(ص).
إذاً.. هناك أنبياء لم يأت القرآن على ذكر أسمائهم فضلاً عن ذكر أحوالهم، وإذا كان القرآن قد سكت عن هذا الأمر فمن أين عرفنا أنه يوجد مئة وأربعة وعشرون ألف نبي؟
لقد تعرّفنا على ذلك من رسول الله محمد(ص) الذي أخبرنا القرآن عنه بأنه لا ينطق إلا بوحي من الله تعالى، وقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ عن رسوله فإنه وإن لم يكن قرآناً إلا أن معناه من القرآن، وقد خفي الكثير عنا من كتاب الله العزيز، وحكم هذه القضية كحكم أية قضية أخرى قد أُوْكِلَ أمر بيانها إلى الرسول(ص)، فلقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة ولكنه لم يُشر إلى كيفيتها وأعدادها وعدد ركعات كل صلاة منها، والذي بيّن لنا تلك التفاصيل هو الرسول الأكرم(ص) الذي قال الله في شأنه(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)
وأمام هذا الواقع ترِد علينا جملة من التساؤلات.
منها: هل أن عدم ذكرهم وذكر أحوالهم فيه انتقاص من شأنهم أو أن الذين وردت أسماؤهم كانوا أفضل ممن لم ترد أسماؤهم؟
نجيب على هذا السؤال بالتالي: لا يوجد دليل واضح يدل على كون المذكورة أسماؤهم في القرآن أفضل ممن لم تُذكر أسماؤهم فيه، ولا يحق لنا أن نستنتج هذه الفكرة من عملية الذكر وعدمه، فإن الله تعالى هو الأعلم بما يصلح ذكره للناس عبر الزمن وبما لا يُستفاد من ذكره.
ومنها: هل أن أحوال مَن لم تُذكر أسماؤهم مشابهة تماماً لأحوال المذكورين في القرآن؟
نقول: ليس بالضرورة أن تكون أحوال أولئك مشابهة تماماً لأحوال هؤلاء، فلا بد أن يكون هناك اختلاف ولو في طريقة التعاطي مع الناس أو طريقة تعاطي الناس معهم، ثم إن المذكورين في القرآن قد تشابهت أحوالهم مع بعضهم البعض من حيث التبليغ والمعاناة التي لاقوها من المعاندين، ومن حيث وضع العراقيل في طرق الدعوة، ومن حيث طلب الإعجاز أو من حيث اتهام الأنبياء بالكذب والجنون والسحر أو من حيث محاولات التخلص من هذا النبي أو ذاك.
ونقول أيضاً: لعل الأحداث التي جرت مع المذكورين تنفعنا مباشرة لأن التاريخ يعيد نفسه ولأن العراقيل هي هي، ولأن الأهداف على حالها، وقد علم الله تعالى أن البشرية سوف تستفيد من تجارب المذكورين فقط فقدّم ذكرهم على ذكر غيرهم ممن استفادت منهم الأمم السابقة دوننا.
واللافت في الأمر هنا هو أن بعض الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن قد اقتصر القرآن على ذكر أسمائهم فقط وأنهم من الصالحين كذي الكفل واليسع وإدريس(ع)، ومن هنا ندرك بأن عدم ذكر من لم يذكرهم لا يتعلق بمسألة الإستفادة من تجاربهم أو عدم الإستفادة، وإنما يتعلق بأمر غيبي.
ولعل ذِكر مَن وردت أسماؤهم مع عدم الحديث عن أحوال بعضهم كذي الكفل واليسع يمكن أن نستفيد منه أمراً، وهو أن الله تعالى قد فعل ذلك من أجل أن يربط بين الأحقاب الزمنية فاختار من كل حقبة واحداً وذكَرَه من باب الترابط بين الرسالات والرسل.
ومنها: لماذا لم يذكر القرآن الكريم أسماءهم من باب التأكيد على وجودهم أو معرفة أعم العموميات عنهم؟
نقول: لقد كان إعجاز القرآن الكريم بإيجازه، ولا يصعب على الخالق سبحانه أن يُنزل مثل القرآن آلافاً، وقد وصف الله كلامه بقوله(قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا) وقوله(وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) فلو أراد القرآن الكريم أن يذكر أسماء جميع الأنبياء لخرج بذلك عن رونقه وروعته وإعجازه، في حين أن أهم الأمور لم يذكرها سوى بشكل مختصَر كالصلاة والصوم والحج.
ومنها: إذا كان الله تعالى قد بعث من الأنبياء بهذا المقدار الكبير في غضون أقل من عشرة آلاف سنة معنى ذلك أنه قد بعث نبياً للناس كل أسبوعين، في حين أن بعض الأنبياء قد تجاوز عمره الألف سنة فكيف يمكن أن نبيّن حقيقة هذا الأمر؟
إن هذا السؤال قليل الطرح والتداول، ولا أدري ما هو السبب في ذلك، مع أنه سؤال في غاية الأهمية، ولبيان حقيقة الأمر أقول: إن الله تعالى أرسل الآلاف من الأنبياء وجعل لكل واحد منهم دوراً وحدد له مهمته، فلقد كانت مهمة بعضهم الإعتناء بأفراد معدودين أو بقرية واحدة أو مدينة واحدة أو إقليم، ومنهم من كانت رسالته على مستوى العالَم كله كأولي العزم(ع)، فلقد كان تعالى يبعث في وقت واحد أكثر من نبي، ولربما اجتمع في نفس الوقت مئات منهم، ولم يبعثهم على نحو التعاقب، ففي ومن إبراهيم(ع) كان هناك إسماعيل ولوط وربما غيرهما، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المسألة حيث يقول(وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ * قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ)
وفي زمن يحيى كان هناك زكريا، وفي زمن داود كان هناك سليمان، وفي زمن موسى كان هناك هارون وشعيب، وفي زمن يوسف كان هناك يعقوب.
النقطة الثالثة: وظائف الأنبياء(ع):
إن وظائف الأنبياء(ع) كثيرة ومتنوعة لم تنحصر في مسألة التبليغ فقط وإنما عرّفوا البشرية على مهنٍ وحِرَفٍ وصناعات لم يكن عندهم عهدٌ بها من قبل، قال تعالى في بيان وظيفة خاتم الأنبياء المشابهة لوظائف سابقيه من الرسل(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
فقد أشار الكتاب العزيز إلى عدة وظائف من وظائف الأنبياء:
الوظيفة الأولى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وهي من أهم الوظائف التي يشترك فيها الأنبياء والمؤمنون لأن الأمر بالمعروف واجب شرعي على الجميع، فهو باب العلم والتزكية وكل الآثار الكريمة، فمن أمر بالمعروف وعمل به، ونهى عن المنكر وانتهى عنه كُتب عند الله تعالى من الصالحين.
الوظيفة الثانية: بيان حلّيّة الطيبات وحرمة الخبائث:
لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يتنزّه عباده عن تناول الخبائث التي بيّنها عن طريق رسله وأنبيائه ليخلّصهم من تبعاتها وآثارها عليهم في الدنيا والآخرة، وفي ذلك كمالٌ للإنسان وتنزيه لبطنه عن احتواء الخبائث من الخمر والطعام المحرّم والنجس بالأصل أو بالعارض.
الوظيفة الثالثة: وضْع الإصر عنهم وفكُّ الأغلال:
كانوا مأسورين بسبب عقائدهم الفاسدة التي أسرتهم ومنعتهم من ممارسة الكثير من أدوارهم فأتى الرسول ووضع عنهم تلك الأثقال ووجّههم نحو الخير والإستقامة وبيّن لهم تعاليم الإسلام التي تنسجم مع الأطباع السليمة.
الوظيفة الرابعة: بيان الفطرة والتذكير بالميثاق:
قال سبحانه(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)
ولذا فلم تكن وظيفة الأنبياء زرع العقيدة في نفوس الناس وبيان أن لهم خالقاً بل كانت وظيفتهم تحريك هذا الشعور بداخلهم ليذكّروهم بربهم الذي أخذ عليهم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم بأنه ربهم وهو من تجب طاعته دون غيره فأذعن له الجميع في هذا الميثاق الذي أخذه عليهم.
الوظيفة الخامسة: التذكير بنِعَم الله عز وجل
وهذه الظيفة لها علاقة متينة بالوظيفة السابقة لأن تعداد نعم الله تعالى يحرّك تلك القوة في داخلهم فيذكّرهم بربهم، وقد أوضح الأنبياء أن تلك النعم التي لا تعدّ ولا تُحصى لم تُخلق عبثاً وإنما خُلقت من أجل البشر ومن أجل اختبارهم في هذه الحياة.
الوظيفة السادسة: الإحتجاج على الناس بالتبليغ:
لا شك بأن بعث الأنبياء إلى الناس إنما هو من أجل إلقاء الحجة عليهم حتى لا يقول أحد في يوم القيامة لو كنت بعثتَ لنا رسلاً لاتبعنا الحق، فها هو سبحانه قد أرسل إليكم آلاف الأنبياء لتكون الحجة عليكم بالغة، ومع ذلك فإن كثيراً منكم قد جحدوا بالآيات وأنكلاوا الحق رغم قوة ظهوره، بل أنكروا المعجزات التي لا يمكن أن يُنكرها إلا المعاند.
ففي سورة البقرة قال سبحانه(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)
وفي سورة النساء قال تعالى(إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا * وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا * رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا)
وفي سورة الأنعام(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ){الأنعام/48}
الشيخ علي فقيه